التكنولوجيا والثقافة ترابط وصلة قُربى أكبر مما نعتقد

يتعمق شعورنا برفاهية الحياة التي نعيشها إذا ما عدنا قليلاً إلى الوراء، ونظرنا إلى ما كان يكابده أجدادنا من مشقات للحصول على النذر القليل مما نتمتع به اليوم بفضل التكنولوجيا الحديثة. لكن هذه التكنولوجيا لم تولد من فراغ، بل من رحم الثقافة نفسها التي كانت سائدة عند أجدادنا. فالثقافة هي الذاكرة التي حفظت كافة نشاطات الإنسان وراكمت خبراته. من تكنولوجيا المجرفة التي أسهمت في تطور الثورة الزراعية، حيث شعر الإنسان لأول مرة بنعيم الاستقرار في العهود الغابرة؛ إلى الهاتف الذكي الذي نعيش بواسطته في تواصل مستمر مع أهلنا وأصدقائنا وأحبتنا، فما بين الثقافة والتكنولوجيا علاقة تكافلية.
صحيح أن الحياة كانت قاسية قبل الكهرباء والسيارة والتلفون وقساطل المياه ووسائل الصرف الصحي داخل البيوت وتكنولوجيا المواصلات. إذ كان على الفرد أن يقوم بتحضير كل شيء بنفسه؛ ابتداءً بتوفير المياه من الينابيع إلى صناعة الخبز. فهذه الحياة تبدو لنا اليوم الشقاء بعينه. لكن مهلاً، كان يكتنف تلك الحياة ثقافة الروح الاجتماعية التضامنية بديلاً عن التكنولوجيا.
 في حديث تلفزيوني للأستاذ أحمد زكي يماني، وزير النفط السعودي السابق، تذكر وهو لما يزل يافعاً، كيف أن إحدى الأرامل في مكة المكرمة لم تكن تستطيع أن تترك أولادها لتخبز العجين في الفرن، فكانت تضعه أمام الباب، ولم يكن الوقت ليطول حتى يكون أحدهم قد تطوع للقيام بذلك دون أن تعلم من هو. كانت التكنولوجيا الحديثة غائبة. الهاتف لم يكن موجوداً، لكن ثقافة التعاضد الدافئة كانت بديلاً عنها.
في حديث تلفزيوني للأستاذ أحمد زكي يماني، وزير النفط السعودي السابق، تذكر وهو لما يزل يافعاً، كيف أن إحدى الأرامل في مكة المكرمة لم تكن تستطيع أن تترك أولادها لتخبز العجين في الفرن، فكانت تضعه أمام الباب، ولم يكن الوقت ليطول حتى يكون أحدهم قد تطوع للقيام بذلك دون أن تعلم من هو. كانت التكنولوجيا الحديثة غائبة. الهاتف لم يكن موجوداً، لكن ثقافة التعاضد الدافئة كانت بديلاً عنها.
مع ذلك، اكتشف علماء الأنثروبولوجيا أن النوع الإنساني الحالي، «الهومو سابيان» استطاع أن ينجو من عصور جليدية قاسية منذ عشرات ألوف السنين باستعماله الحربون لاصطياد السمك تحت الجليد، بينما أخفقت الأنواع الأخرى مثل «الهومو نيندرتال» من فعل ذلك. إذ إنها كانت تعتمد بشكل واسع على اصطياد الحيوانات الكبيرة التي انقرضت بدورها نتيجة الجليد، مما أدى إلى انقراض «النياندرتال» أيضاً.
إن نوعنا الإنساني الحالي كان أقل قوة جسدية من الأنواع الأخرى، لكنه كان أذكى. إن حياتنا الحالية، بهذا المعنى، هي هبة التكنولوجيا، التي بواسطتها تمكنَّا من البقاء والاستمرار. لذلك يقول «باتريك دانين» في مجلة «نيو أتلانتيس» يجب أن نطلق على الإنسان الحالي «هومو تكنولوجيا» بدل «هومو سابيان».
التكنولوجيا امتداد للجسد
 كما أن الثقافة تسكن عقلنا ووجداننا، فإن التكنولوجيا هي امتداد لأعضاء جسدنا. المجرفة هي امتداد لليدين، لكنها أقوى، الميكروسكوب هو امتداد للعين، نرى بواسطته ما لا نستطيع بالعين المجرَّدة، السيارة هي امتداد للأرجل، التلفون امتداد للأذنين.. الخ. لكن «مارشال ماكلوهان» فيلسوف التكنولوجيا والميديا الكندي، وصاحب تعبير «القرية الكونية» الشهير، يشير إلى أن لكل امتداد بترٌ يصاحبه من ناحية أخرى. فمع اختراع البارود تم القضاء على مهارة الرماية بالقوس. والسيارة قضت على تقاليد متطورة في المشي، التي بدورها جعلت القرى والمدن تتطور بطريقة جديدة مناسبة.
كما أن الثقافة تسكن عقلنا ووجداننا، فإن التكنولوجيا هي امتداد لأعضاء جسدنا. المجرفة هي امتداد لليدين، لكنها أقوى، الميكروسكوب هو امتداد للعين، نرى بواسطته ما لا نستطيع بالعين المجرَّدة، السيارة هي امتداد للأرجل، التلفون امتداد للأذنين.. الخ. لكن «مارشال ماكلوهان» فيلسوف التكنولوجيا والميديا الكندي، وصاحب تعبير «القرية الكونية» الشهير، يشير إلى أن لكل امتداد بترٌ يصاحبه من ناحية أخرى. فمع اختراع البارود تم القضاء على مهارة الرماية بالقوس. والسيارة قضت على تقاليد متطورة في المشي، التي بدورها جعلت القرى والمدن تتطور بطريقة جديدة مناسبة.
يحضر إلى الذاكرة هنا حال كثير من بلدات الاصطياف في جبال لبنان، مثلاً بلدة الشوير الضيعة التاريخية القديمة وضهور الشوير، التي هي امتداد لها، تقع فوقها بمائتي متر. ولتسهيل التنقل بينهما في القرون الماضية تم بناء عدة أدراج، كل واحد يحتوي على مئات من الدرجات الحجرية الجميلة. وقد بُني في الماضي كثير من البيوت الجميلة حولها على الرغم من انحدارها الشديد. لكن مع التوسع في استعمال السيارات، تم الاستغناء عن هذه الأدراج فباتت معالمها غير واضحة والبيوت حولها خرباً غير مسكونة. وأخذت المباني الجديدة تتمحور حول طرق السيارات. للمرء أن يتخيل كيف كانت هذه الأدراج عامرة بالمارة، وكيف كان الناس على تواصل وتماس فيما بينهم، وكيف أصبحوا الآن يلقون التحية على بعضهم داخل السيارات بالزمامير، إذا تسنى لهم ذلك. ومن نتائج هذا الامتداد أيضاً ضمور عضلات أرجلنا والهواء العليل الذي نستنشقه.
 إلى هذا الحد، يبدو الامتداد سهل الاستيعاب. فبعد أن طرح «ماكلوهان» باكراً السؤال المقلق: «من يمتلك عيونك وآذانك الممتدة؟»، طُرحت لاحقاً أسئلة كبيرة، خصوصاً فيما يتعلق بالتأثير على الوعي والفكر والثقافة. فالوسائط الإلكترونية الحديثة تحل محل الوظائف الأساسية للجهاز العصبي المركزي وهو استيعاب المعلومات وتخزينها وتحليلها، ثم تحويل القيم الاجتماعية والاقتصادية والثقافية إلى مجرد معلومات.
إلى هذا الحد، يبدو الامتداد سهل الاستيعاب. فبعد أن طرح «ماكلوهان» باكراً السؤال المقلق: «من يمتلك عيونك وآذانك الممتدة؟»، طُرحت لاحقاً أسئلة كبيرة، خصوصاً فيما يتعلق بالتأثير على الوعي والفكر والثقافة. فالوسائط الإلكترونية الحديثة تحل محل الوظائف الأساسية للجهاز العصبي المركزي وهو استيعاب المعلومات وتخزينها وتحليلها، ثم تحويل القيم الاجتماعية والاقتصادية والثقافية إلى مجرد معلومات.
الثقافة تُمهِّد للتكنولوجيا
قبل الثورة الصناعية والانفجار التكنولوجي الذي لا يزال يتوالى فصولاً إلى اليوم، مهدت النهضة الثقافية الأوروبية ابتداءً من القرن الخامس عشر حتى السابع عشر، الطريق لها. تلتها حركة التنوير التي امتدت إلى منتصف القرن الثامن عشر، والتي قامت على مناهضة الشعوذة والخرافات متحدية كثيراً من الاعتقادات والتقاليد الراسخة منذ قرون. كما أكدت تحكيم العقل والنقد والتجربة بديلاً عن التفسيرات الماورائية. وعملت على فصل العلم عن غيره من الأفكار، حيث أطلق عليه العلم الحديث. فكان أن ظهر المفهوم الديكارتي القائل: «أنا أفكِّر إذن أنا موجود»، وأصبح أساساً في الفكر الغربي.
ويُفسر أحياناً بالقول «أنا أشك إذن أنا موجود». ففي جواب عن سؤال: ما حركة التنوير؟، أجاب الفيلسوف الكبير «ايمانويل كانط» (1724-1804)، «هي الحرية في استعمال عقلك». وظهرت في تلك المرحلة أسماء كبيرة مثل «باروخ سبينوزا» (1632-1677)، «جون لوك» (1632-1704)، «بيار بايل» (1647-1706)، «فولتير» (1694-1778)، «إسحاق نيوتن» (1643-1727)، «توماس هوبس» (1588-1679) وغيرهم الكثير.
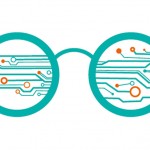 وكما سبقت الثورة الصناعية حركتا النهضة والتنوير، كذلك فإن الثورة العلمية والثقافية قبل منتصف القرن العشرين، خصوصاً ما يتعلق بالعلوم والفنون والفلسفة، وفلسفة العلوم وما يعرف بفكر ما بعد الحداثة، تزامنت مع ثورة التكنولوجيا الرقمية الحالية، ومهدت لها.
وكما سبقت الثورة الصناعية حركتا النهضة والتنوير، كذلك فإن الثورة العلمية والثقافية قبل منتصف القرن العشرين، خصوصاً ما يتعلق بالعلوم والفنون والفلسفة، وفلسفة العلوم وما يعرف بفكر ما بعد الحداثة، تزامنت مع ثورة التكنولوجيا الرقمية الحالية، ومهدت لها.
يقول «أرثر ميلر»، أستاذ تاريخ الفلسفة والعلوم والتكنولوجيا في جامعة لندن، إنه في وقت واحد اكتشف «ألبرت آنشتاين» النظرية النسبية واكتشف «بابلو بيكاسو» التكعيبية في الرسم. كلاهما كان يعالج خاصية المكان، أو الفضاء، وكيفية التطلع إليه بطرق مختلفة من قبل مشاهدين مختلفين. أراد القول إن بين العلم والتكنولوجيا والثقافة ترابط عضوي.
 وكان «نيلز بوهر»، العالم والفيلسوف الدانماركي، ذو الإسهامات المهمة في فهم خصائص الذرة والإلكترونيات، قد وصل إلى حالة اليأس في أبحاثه حول طبيعة الإلكترون في النصف الأول من القرن العشرين. إذ لم يتوصل، بعد اختبارات مضنية، إلاَّ إلى نتائج متناقضة. فاتخذ لنفسه فترة للراحة وباشر قراءة كتاب عن التكعيبية، لمجرد الترفيه عن النفس. لكن هذا الكتاب كان الشرارة التي أشعلت مخيلته للوصول إلى ما أصبح يُعد محطة مهمة في تاريخ العلوم، وهي نظرية «المتمم في فيزياء الكم». إذ إنَّ بعض الأشياء، ومنها الإلكترون، هي جزيئات وتموجات في الوقت نفسه. ولكن عند قياسها تكون إما هذه أو تلك. كذلك التكعيبية التحليلية في الرسم تحاول أن تمثل مشهداً مرئياً من جوانب مختلفة على لوحة واحدة. إن النتائج المتناقضة التي توصل إليها في اختباراته تعكس حقيقة الإلكترون. وكان الخيال ما ينقص هذه النتائج، فكان له.
وكان «نيلز بوهر»، العالم والفيلسوف الدانماركي، ذو الإسهامات المهمة في فهم خصائص الذرة والإلكترونيات، قد وصل إلى حالة اليأس في أبحاثه حول طبيعة الإلكترون في النصف الأول من القرن العشرين. إذ لم يتوصل، بعد اختبارات مضنية، إلاَّ إلى نتائج متناقضة. فاتخذ لنفسه فترة للراحة وباشر قراءة كتاب عن التكعيبية، لمجرد الترفيه عن النفس. لكن هذا الكتاب كان الشرارة التي أشعلت مخيلته للوصول إلى ما أصبح يُعد محطة مهمة في تاريخ العلوم، وهي نظرية «المتمم في فيزياء الكم». إذ إنَّ بعض الأشياء، ومنها الإلكترون، هي جزيئات وتموجات في الوقت نفسه. ولكن عند قياسها تكون إما هذه أو تلك. كذلك التكعيبية التحليلية في الرسم تحاول أن تمثل مشهداً مرئياً من جوانب مختلفة على لوحة واحدة. إن النتائج المتناقضة التي توصل إليها في اختباراته تعكس حقيقة الإلكترون. وكان الخيال ما ينقص هذه النتائج، فكان له.
الثقافة تؤثر على التكنولوجيا
والحال أن كل ثقافة تطوِّر تكنولوجياتها الخاصة بها. فنظام النقل في الولايات المتحدة الأمريكية يختلف عنه في أوروبا أو غيرها. إنه يعكس الشخصية الأمريكية الليبرالية والمستقلة للفرد الأمريكي. هكذا يعتمد بشكل أساسي على السيارات الخاصة في المدن الأمريكية. لذلك فإن وسائط النقل العام هي أضعف بكثير مما هو حالها في المدن الأوروبية التي تعتمد على وسائط النقل العامة فوق الأرض وتحتها بشكل كثيف. وفي بحث لـ «كليف بونتينغ» حول جزيرة «أيستر» البولينيزية في المحيط الباسيفيكي وانهيار حضارتها، يؤكد تأثير الثقافة القوي على التكنولوجيا. فبعد التقدم الكبير في الزراعة وتربية الماشية، طرأ تحسن كبير على أحوال السكان. مما دفعهم إلى توجيه نشاطاتهم نحو إقامة التماثيل الدينية الضخمة. وقد أقيم حوالي 880 تمثالاً تُعد من المآثر التاريخية. لكن ذلك تطلب موارد كبيرة وسبلاً لنقل الأخشاب والحجارة إلى أماكن محددة وبعيدة. فأدى ذلك إلى إزالة الغابات وتدهور البيئة نفسها التي كانت سبب ازدهارهم. وبانقراض البيئة انقرض معها شعب تلك الجزر.
 كذلك في الصين القديمة، كانت الألعاب النارية جزءاً أساسياً من ثقافة الاحتفالات الدينية. فتم اكتشاف البارود كتطوير تكنولوجي لهذه الألعاب. ونتيجة الثقافة الدينية السائدة بقي استعماله محصوراً في هذا المجال لقرون. إلى أن وجد طريقه إلى أوروبا فاستعمل فوراً كسىلاح في الحرب. وكان الدافع إلى صناعة المدافع وتكنولوجياتها التي أدخلت تغييرات جذرية على استراتيجيات الحروب وغيَّرت مجرى التاريخ. كان البارود في الصين حاجة ثقافية دينية سلمية. لكنه في الغرب أصبح حاجة في ثقافة فن الحروب. هذا مع العلم أن الصين هي أقدم من طوَّر فنون الحرب. فما زال حتى اليوم كتاب «سان تزو» وعنوانه «فن الحرب»، والذي كتب ألفي سنة قبل أن يضع الأوروبيون يدهم على البارود الصيني، يُعد مرجعاً في علم الاستراتيجية.
كذلك في الصين القديمة، كانت الألعاب النارية جزءاً أساسياً من ثقافة الاحتفالات الدينية. فتم اكتشاف البارود كتطوير تكنولوجي لهذه الألعاب. ونتيجة الثقافة الدينية السائدة بقي استعماله محصوراً في هذا المجال لقرون. إلى أن وجد طريقه إلى أوروبا فاستعمل فوراً كسىلاح في الحرب. وكان الدافع إلى صناعة المدافع وتكنولوجياتها التي أدخلت تغييرات جذرية على استراتيجيات الحروب وغيَّرت مجرى التاريخ. كان البارود في الصين حاجة ثقافية دينية سلمية. لكنه في الغرب أصبح حاجة في ثقافة فن الحروب. هذا مع العلم أن الصين هي أقدم من طوَّر فنون الحرب. فما زال حتى اليوم كتاب «سان تزو» وعنوانه «فن الحرب»، والذي كتب ألفي سنة قبل أن يضع الأوروبيون يدهم على البارود الصيني، يُعد مرجعاً في علم الاستراتيجية.
من ناحيتهم، طور منتجو الهواتف النقالة منتجاتهم باستمرار لتتناسب مع الأسواق الإسلامية لتسهيل وتذكير المستخدمين بأوقات الصلاة وتوجيههم نحو مكة المكرمة وإيقاف المكالمات الواردة لمدة عشرين دقيقة. كما أنها في بعض الأحوال الأخرى تقوم بتغييرات أخرى تناسب بعض الثقافات الإفريقية والآسيوية الخاصة بها. فالأماكن في اليابان مثلاً ضيقة، خاصة أماكن السكن ووسائط النقل. وتبرز في هذه الحالة مسألة الخصوصية. فالتكلم بصوت مرتفع على الهواتف هناك يصبح مشكلة مقلقة. لذلك طور منتجو هذه الهواتف نظام الرسائل النصية ليستعاض به عن التكلم. ولهذا تبدو أزرار الطباعة بارزة أكثر من العادية، وشاشته أوسع لتستوعب رسائل أطول، كما أن أسعار الرسائل أرخص نسبياً.
التكنولوجيا الحاكمة
إن لكل تكنولوجيا فلسفتها وتحاملها الخاص بها. وهكذا تحمل بذاتها تأثيرها على الثقافة من خلال جعلنا عرضة لتفضيل وتقييم وجهة نظر معيَّنة. حامل المطرقة يبدو له أي شيء مسماراً. وحامل القلم يبدو له أي شيء جملة. ولحامل كاميرا يبدو أي شيء صورة. ولمن معه كمبيوتر يبدو أي شيء معلومات. وقيمة المعلومات، كما أصبح رائجاً، تعلو فوق قيمة المعرفة، وبالتأكيد فوق قيمة الحكمة. مع تقدم الوقت، تغيب الحكمة، وتصبح شيئاً من التاريخ. وهل بقي لكبارنا قيمة غير الحكمة؟ لذلك يبدو كبار السن ضحايا هذا التقدم التكنولوجي الهائل. هذا بحد ذاته تغير ثقافي كبير.
هذا الفيض من التكنولوجيا الحديثة أصبح يحكم حياتنا العصرية بكل أبعادها. فهي حاضرة في المنزل، وفي الطريق إلى العمل وفي العمل.. الخ.
إزاء ذلك، طُرحت أسئلة مقلقة حول ما إذا كانت هذه العوالم الافتراضية التي تنقلنا إليها، تعمل ضد الثقافة القديمة التي رافقتنا كل العصور إلى اليوم دون أن تكملها كما كان يحدث في الماضي. إنها تضع حاجزاً بيننا وبين حركة الحياة اليومية وغناها وتنوعها.
فيما مضى، كنا نقرأ الكتب. كان النص مفتوحاً على خيالنا الخاص وتجربتنا الفريدة. كان الكتاب يُغني خيالنا وتجاربنا. وكنا نُغنيه بنبض حياتنا الحارة. بين الكتاب وبيننا كانت علاقات حب وتفاعل شفَّافة صافية، لا يشوبها أي زيف أو غرض. كنا نقرأ الرواية ونتماهى مع أبطالها. كنا نُسقِط أحداثها على أنفسنا، ونسقط مشاعرنا وآمالنا على صفحاتها. كان كل قارئ «جان فالجان» خاص به عند قراءته «البؤساء» لفيكتور هوغو. واليوم، في عصر الصورة والكاميرا والكمبيوتر اللوحي والتمثيل المحترف، وسهولة الحصول على كل ذلك، يصلنا النص نفسه والانطباع مع الصورة نفسها. وتأتي الانفعالات نفسها جاهزة لكل فرد. فهل التكنولوجيا تقضي على التنوع والتعدد؟
علاقة تكافلية
 على الرغم من ذلك، فإن ما بين الثقافة، بما تختزنه من فنون وآداب ومعتقدات وتقاليد وبين التكنولوجيا والعلم ترابط يعود إلى فجر الحضارة الإنسانية. والانقطاع الذي نلاحظه بينهما لم يحصل إلا في بداية القرن التاسع عشر. وسببه هو المبالغة في الفصل بين العمل على الآلة، الذي كان قد بدأ ينظر إليه في ذلك الوقت بتفوق وإعجاب (كما ننظر اليوم مثلاً إلى روَّاد الفضاء)، وبين العمل اليدوي. أخذ العمل اليدوي ينحصر في الزراعة، وأصبح ينظر إليه بدونية. وامتد ذلك إلى الفصل بين الإنتاج الصناعي المنظم والغني، وبين الإنتاج الزراعي الفوضوي والضعيف. وينتج ذلك دولاً منظمة وقوية اقتصادياً وعسكرياً والآخر دولاً ضعيفة وممزقة. أخذ هذا التمايز يرتبط بشكل تعسفي بالتمايز القديم بين المادة والروح. وانتقلت هذه الثنائية إلى الفصل بين التكنولوجيا والعلم من جهة وبين الثقافة من الجهة الأخرى. وساد الاعتقاد بالنظرة المادية المتفوقة من جهة، والروحية المتخلفة عنها من الجهة الأخرى.
على الرغم من ذلك، فإن ما بين الثقافة، بما تختزنه من فنون وآداب ومعتقدات وتقاليد وبين التكنولوجيا والعلم ترابط يعود إلى فجر الحضارة الإنسانية. والانقطاع الذي نلاحظه بينهما لم يحصل إلا في بداية القرن التاسع عشر. وسببه هو المبالغة في الفصل بين العمل على الآلة، الذي كان قد بدأ ينظر إليه في ذلك الوقت بتفوق وإعجاب (كما ننظر اليوم مثلاً إلى روَّاد الفضاء)، وبين العمل اليدوي. أخذ العمل اليدوي ينحصر في الزراعة، وأصبح ينظر إليه بدونية. وامتد ذلك إلى الفصل بين الإنتاج الصناعي المنظم والغني، وبين الإنتاج الزراعي الفوضوي والضعيف. وينتج ذلك دولاً منظمة وقوية اقتصادياً وعسكرياً والآخر دولاً ضعيفة وممزقة. أخذ هذا التمايز يرتبط بشكل تعسفي بالتمايز القديم بين المادة والروح. وانتقلت هذه الثنائية إلى الفصل بين التكنولوجيا والعلم من جهة وبين الثقافة من الجهة الأخرى. وساد الاعتقاد بالنظرة المادية المتفوقة من جهة، والروحية المتخلفة عنها من الجهة الأخرى.
لكن مع التقدُّم التكنولوجي نفسه خاصة في الكمبيوتر والبرمجيات، وما نشأ عنها من تقدم خيالي في كثير من الفنون، وكذلك في علم الدماغ والأعصاب والتحليل النفسي-الجسدي، أو في المجال الموسيقي حيث يتداخل الكمبيوتر مع الفيزياء والرياضيات والتأليف والإنتاج ونظريات الصوت، وغيرها كثير من المجالات المشتركة، بدأت هذه الحدود بين الثقافة والتكنولوجيا تتهافت وتتآكل.
في كتابه «انطلاق الطبقة المبدعة» الصادر سنة 2005م، وهو دراسة للأماكن المزدهرة في العالم، يشير ريتشارد فلوريدا إلى أن الإبداع العلمي والتكنولوجي والفني والاقتصادي والثقافي مترابط إلى أبعد الحدود. حتى أن أماكن مشهورة جداً بتقدمها التكنولوجي مثل بنغالور في الهند أو شانغهاي في الصين لا تزال متخلفة جداً بالنسبة إلى مدن أخرى مثل لندن، وباريس، وسان فرانسيسكو، ونيويورك وغيرها.. بسبب تخلفها الثقافي والفني. فجامعة كاليفورنيا وحدها سجلت براءات اختراع أكثر من الصين والهند مجتمعتين. إن أهم العوامل في هذه المراكز، بالإضافة إلى جامعات من الصف الأول، كما يضيف فلوريدا، هو حماسة للفن في كل المجالات وللحس الجمالي القوي.
تأكيداً على ذلك، يتخيل روبين شاندلر في كتابه «المناطق الإبداعية المتوازية»، أن معلِّم المستقبل وهو ليوناردو دافنشي، افتراضي يعطي دروساً في صف سنة 2099م.
