بناء العلاقة بـ النص المرجعي في الخطاب الإسلامي المعاصر
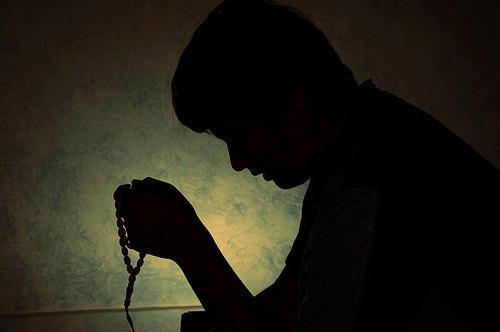
بناء العلاقة بـ النص المرجعي في الخطاب الإسلامي المعاصر
جواد الشقوري
يمكن اعتبار الخطاب الإسلامي في كل مرحلة من المراحل، وفي كل لحظة زمنية، بمثابة جملة المفاهيم والرؤى التي استقرت في البنية الذهنية لحملة هذا الخطاب( أفرادا وجماعات) عن الواقع، انطلاقا من مرجعية الإسلام. وهذه المفاهيم والرؤى هي التي تحدد طبيعة الخيارات والرهانات.
ومن المنطقي أن تكون هذه الرهانات والخيارات سليمة وسديدة، كلما كان فهم الواقع فهما سليما وسديدا. وإن كل قراءة تبسيطية أو اختزالية لمفردات ومعطيات الواقع، قد تضع هذه الخيارات والرهانات، في موضع يستحيل معه الوصول إلى تحقيق الأهداف الكبرى والصغرى؛ مما يعني -حتما– عدم القدرة، بل العجز على إحداث التغيير والتحول المنشود.
ضمن هذا السياق، تحاول هذه الإسهامة أن تعمل النظر في الموقع الذي يحتله الواقع في البنية الفكرية للخطاب الإسلامي المعاصر. ودافعنا إلى هذه المغامرة الفكرية، هو ما نلاحظه عندما نطالع مسير هذا الخطاب- الحركة الإسلامية على وجه أخص- على مستوى النظر كما على مستوى الممارسة، من مفارقة غريبة: فعلى مستوى الخطاب، نلمس تضخما - لا بأس به- في الدعوة إلى استشعار أهمية الواقع، بل واعتباره منطلقا أساسيا من منطلقات التغيير. وفي المقابل، على مستوى الممارسة، وعلى أرض الواقع، لم يثمر ذلك الخطاب الأهداف التي كان يتوخاها؛ آية ذلك ما تعيشه الحركة الإسلامية عموما- مثلا- من فقر في بنائها الفكري، وعجز عن تخريج عناصر في مستوى طبيعة التحولات والتطورات التي يشهدها الواقع المعاصر. ومفارقة المفارقات – والتي تستدعي التوقف عند أسبابها- أن نجد أن أغلب الذين استطاعوا أن يحققوا بالخطاب الإسلامي المعاصر قفزة نوعية على مستوى النظر والفكر، كما على مستوى فهم وتحليل الواقع والوقائع، كانوا في بداية مشوارهم الفكري خارج دائرة العمل الإسلامي، والأسماء أكثر من أن تحصى في هذا المقال!!
ولعل إخفاق الكثير من التجارب الإسلامية في الوصول إلى تحقيق ما سطرته من أهداف –خاصة تلك الحركات التي كانت تراهن على العمل السياسي والدولة القطرية - يمكن رده إلى تلك القراءة التبسيطية للواقع، بمعنى عدم بنائها للرهانات على قراءة صحيحة للعالم والعصر.
وفي اعتقادنا، قد تكون العلاقة التي يبنيها الخطاب الإسلامي بنصوصه المرجعية، هي –العلاقة- التي تقف وراء ظاهرة الضعف في التعامل بشكل فعال مع الواقع. فنحسب أن عدم فعالية الخطاب الذي يدعو إلى إيلاء أهمية كبيرة لدراسة الواقع، كان نتيجة منطقية لطبيعة العلاقة التي يبنيها الخطاب الإسلامي بنصوصه الثلاث التي تشكل – بالأساس- مرجعيته الفكرية؛ وهي: النص المقدس، النص التراثي، والنص الحركي.
إن تلك العلاقة –في نظرنا- قد أفرزت ظاهرة ساهمت في تعطيل مفعولية وفاعلية الخطاب الداعي إلى الاهتمام بالواقع.. حيث تحول –الخطاب- إلى مجرد خطاب نظري، ساكن غير متحرك، جامد غير مشتغل.. هذه الظاهرة، يمكن تسميتها بظاهرة " التعالي المرجعي"؛ إذ أن انشداد هذا الخطاب إلى كل نص من هذه النصوص المرجعية قد أشعره( أي الخطاب ) بنوع من الارتياح لما يملكه من أفكار ورؤى؛ وإن هذا التعالي المرجعي عمق في العمل الإسلامي( عموما) نوعا من الإحساس بإمكانية التعالي –بإفراط- عن الواقع.
فبخصوص النص المقدس نقول إن هذا النص- خاصة المتعلق بقضايا المجتمع والاجتماع البشري- مرتبط بشكل عام/كلي بالإجابة على "سؤال لماذا". أما الإجابة على "سؤال كيف" فمرتبطة - بشكل أساسي- بفهم تقلبات الواقع وتموجاته المختلفة.. وإن الوقوع في آفة الخلط بين هذين المستويين من التفكير، وعدم التمييز بينهما، ربما كان وراء تلك الترسانة الهائلة من الكتابات الإسلامية، التي لا تمس إشكالات وظواهر الواقع المعقدة إلا في إطارها العام؛ ومن هنا سطحيتها وعموميتها. ولا نبالغ كثيرا إن قلنا بأن غياب هذا الأمر هو الذي يفسر اكتفاء الكثير من أطر العمل الإسلامي بالقراءة السطحية لظواهر الواقع، عن طريق الإجابة على "سؤال لماذا" ..لأن الإجابة على "سؤال كيف" تتطلب بذل غاية الجهد من أجل التدقيق في إشكالات الواقع وامتلاك ناصيته والإحاطة بمفرداته المختلفة.
وفي غالب الأحيان، تكون الإجابة على "سؤال لماذا" ثابتة، لا تتغير بتغير الزمان والمكان، أما الإجابة على "سؤال كيف" فيطالها التغير بناء وباطراد مع تغير الواقع. وإن الرؤية انطلاقا من "سؤال لماذا" سابقة عن الواقع، أما الرؤية بناء على "سؤال كيف" فيسبقها الواقع وتأتي بعده.
وإن ما تقدم- أيضا- هو الذي يفسر لماذا يتقن العمل الإسلامي- أي بعض مدارسه- لغة الهدم بامتياز، ويفشل في إتقان لغة البناء. لأن الهدم سبيله واضح؛ وهو الاعتماد على جملة من النصوص المرجعية أو تلك المرتبطة بـ"سؤال لماذا ". أما البناء، فيتطلب فهم الواقع بعمق.. أي الانطلاق من الإجابة على "سؤال كيف".
إن طبيعة العلاقة التي يبنيها الخطاب الإسلامي بالنص المقدس أدت إلى الإحساس بنوع من الاكتفاء المرجعي/النظري، أي الشعور بعدم الحاجة إلى مراجع أخرى لفهم الواقع.. عكس بعض التيارات الفكرية/الإيديولوجية الأخرى التي تسترشد بمراجع أرضية.
أما بالنسبة للعلاقة بالنص التراثي فقد تكون عامل نكوص عندما يتم التماهي مع جزئيات التراث وليس بالمنهج الذي كان وراء إنتاج هذا النص.
إن هذا المسلك قد يكون من الأسباب التي تفسر عزوف العمل الإسلامي عن الاهتمام بتفكيك وفهم مفردات الواقع. لأن هذا المسلك بمثابة ارتباط بالإجابات، وهو ارتباط يمني النفس، ولا يكلفها عناء البحث؛ ولا عجب إن ألفينا بعض الأدبيات التي تسلك هذا السبيل تبدو في معظمها وكأنها غير متصلة بحياة الناس وبإشكالاتهم الحقيقية، ذلك لأنها تعاملت بدون وعي مع نصوص التراث، وبشكل مبتور من سياقها الزماني والمكاني.
وعندما يتم الارتباط بهذا الشكل بنصوصنا التراثية، فإننا سنشعر بأننا نملك إجابات لكل الأسئلة، وتأصيلا لكل مستجد؛ وهذا النوع من السلوك قدير على جعلنا ننظر إلى الواقع على أساس أن الخطأ يكمن فيه، ولهذا السبب تحاول ـ في الغالب ـ بعض الكتابات الإسلامية أن تتعامل مع الواقع بشكل " إداني". إن هذا النوع من التفكير، لا يعطي الأولوية لدراسة الواقع من أجل فهمه وإيجاد إجابات جديدة على إشكالاته المختلفة؛ طبعا مع الاسترشاد بمنهج المسلمين الأوائل في التعامل مع مشكلاتهم المعيشة.
وبهذا الأمر نفسر لماذا لم تبرز -إلا نادرا- في صفوف الحركة الإسلامية، عناصر تهتم بقضايا الإجتماع البشري..وبه يفسر -أيضا- ضعف البناء الفكري/المعرفي للكثير من الحركات الإسلامية؛ لأن الشعور بالاكتفاء و"الكمال" يورث في الإنسان/ الجماعة حالة نفسية -بل ومعرفية- خطيرة، تتمثل في العزوف عن دراسة الواقع ـ والتجرد في الدراسةـ والأفكار التي شكلته وصاغته حتى استوى على سوقه الراهن.
ولكي تأخذ هذه الدراسة مسارها الطبيعي.. لا بد من الابتعاد ما أمكن عن الانشداد المفرط إلى الماضي، والحديث بلغة المنجزات والإنجازات، وتفسير الحاضر بالماضي، وبناء صور فوتوغرافية للمستقبل انطلاقا من فعل التماهي مع الماضي.
فعندما يحتل الماضي في قاموس الإنسان/الجماعة، حيزا كبيرا ومساحة كبيرة، فيمكن اعتبار ذلك نوعا من التعويض عن فعل الانسحاب من الحاضر؛ وللذكرى فقط أشير إلى أن هذه الذهنية " المسكونة بالماضي/ الماضوية" قد خلفت آثارا سلبية على الفكر الإسلامي؛ فتمجيد الماضي الذهبي، وتحويله إلى لغة وشعارات، قد يحجب رؤية بعض الأحداث والوقائع التي حدثت في تاريخنا بشكل "محايد" و"موضوعي".
إن الإنسان/الجماعة عندما تكون حصته من فقه الواقع ضعيفة، يسعى جاهدا من أجل إيجاد المشروعية لوجوده انطلاقا من إنجازات الآخرين، ونحن نعلم أن المسلمين في عز أيامهم أنتجوا أفكارا انطلاقا من تفاعلهم الإيجابي مع واقعهم وفهمهم العميق له، حتى تسنى لهم تحقيق إنجازات كبرى على كافة المستويات. ونحن لم ننتج الأفكار، ولكن نعيد إنتاج الإنتاجات السالفة، ليس على المستوى العملي/الواقعي، بل على المستوى التجريدي/ النظري. وهذا ما جعل بعض المراقـبين ينظرون إلى هذا النوع من الاتجاه في التفكير والسلوك على أساس أنه اتجاه غارق في المثـالية ومتـسم بسمة العـزوف عن الواقع -المعيش.. ونحن هنا أمام ظاهرة يمكن تسميتها "بظاهرة التضخم على مستوى إنجازات الآخرين". هذه الظاهرة التي من شأنها أن تبعد الخطاب الإسلامي عن فهم الواقع واعتباره مرجعا في حد ذاته. فهذه الإنجازات التي حدثت في تاريخنا تشعر العمل الإسلامي بنوع من التعالي عن الواقع.
أخيرا، بالنسبة لطبيعة العلاقة التي تبنيها بعض مدارس العمل الإسلامي مع النص الحركي، قد أفرزت ـ في اعتقادنا ـ ظاهرة يمكن تسميتها بظاهرة "التمركز حول آراء التنظيم ونصوصه الحركية" بمعنى آخر؛ إن النصوص الحركية هي التي غدت تحدد لأفراد العمل الإسلامي( أقصد على وجه الخصوص علماءه ومثقفيه ومفكريه،) نوعية النظرة التي يقاربون بها إشكالات الواقع وظواهره المختلفة.. دون فقه روح هذه النصوص الحركية ودواعيها التأسيسية/التنظيرية.
فالمشكلة التي تحول دون بروز عناصر قادرة على فهم التغيرات والتحولات الجديدة التي تطرأ على الواقع، يمكن اختصارها في التعامل مع النص الحركي باعتباره نصا يحمل قدرة فائقة على تغيير وفهم كل شيء، ولا ينظر إليه كنص زمني تاريخي، تحكمت مجموعة من العوامل في صياغته.
عندما ينظر إلى النص الحركي بهذا الشكل غير السليم، فإنه ولا شك ستحجب رؤية الواقع بشكل سديد.. وتتعمق المشكلة عندما يكون النص الحركي هو الذي يحدد لبعض العاملين للإسلام حتى فهمهم لجملة من النصوص التراثية، بل لطائفة من النصوص المقدسة أيضا!!.
فعندما يكون النص الحركي(الزمني بطبيعة الحال) هو المحدد لطبيعة نظرتنا إلى الإشكالات والأسئلة التي يحبل بها واقعنا المعاصر (المتجدد)، فإن الإجابات ستكون قريبة من الشكلية ومتسمة بالسطحية.
وهذا الأمر يقودنا إلى الحديث عن موقع المثقف داخل العمل الإسلامي المعاصر. فنميل إلى القول بأن المفكر يجب أن يكون فوق التنظيم؛ بمعنى أن السياسات والاختيارات التي يرسمها التنظيم ينبغي أن تكون تعبيرا عن ما وصل إليه المفكر من آراء وإجابات.. وللأسف فإن العكس هو الذي يحدث في بعض الأحيان. فنجد أن المثقف في صفوف الحركة الإسلامية على وجه الخصوص، بمثابة مدافع عن التنظيم، وعندما أقول التنظيم، أقصد اختياراته القبلية!!
هذه بعض الإشارات أوردتها، على عجل، قصد تعميق الحوار حولها، وهي إشارات تثير إشكالات أكثر مما تقدم إجابات. * الأستاذ جواد الشقوري: باحث وكاتب من المغرب.
المصدر: موقع مركز العهد الثقافي
