انحطاط التديّن وتديين الانحطاط!
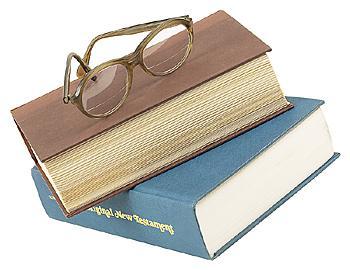
انحطاط التديّن وتديين الانحطاط!
محمد أبو رمان
ثمة مسافة شاسعة جداً بين أنماط التديّن السائدة في مجتمعنا ومقاصد الشريعة الإسلامية وغايات الخطاب القرآني، وفي أحيان كثيرة يعكس تديّن شريحة اجتماعية واسعة أزمة اجتماعية وليس إيماناً نابعاً من إدراك عميق لأبعاد الرسالة الإسلامية في حياة الفرد والمجتمع والدول.
بالضرورة، ليس من الممكن أن نتصور أن يصل الناس جميعاً إلى الدرجة نفسها من الإدراك والعلم لمعاني الإسلام ودلالات وعلل الأحكام الشرعية، لكن على الأقل أن يكون التيار العام في المجتمعات أقرب إلى إدراك هذا الفهم، وليس العكس.
تجليّات "أزمة التدين" أو "التدين المنحط"، بعبارة أكثر قسوة بتعريف الفقيه الإسلامي المغربي، د. أحمد الريسوني تبدو في كثير من مجالات الحياة، ولعلّ المثال الأبرز اليوم هو ما نشهده من تفجير للكنائس في العراق ومن اقتتال وعصبيات بين السنة والشيعة ومن حوادث تفجير ومن استباحة دماء الناس على أتفه الأسباب.
تبدو الأزمة بصورة أكثر تماسّاً مع حياتنا اليومية وقيمنا المجتمعية وبعلاقة الفرد مع نفسه ومجتمعه ودولته، وقد لخّص ذلك بجملةٍ واحدة المفكر والمؤرخ العراقي الكبير علي الوردي فيما وصفه بـ"الإسلام الصوري"، على غرار "المنطق الصوري" الذي حكم العقل الفقهي المسلم قروناً من الزمن.
"التدين الشكلي" أو الصوري يعني اهتمام الناس بالمظاهر والقشور والجزئيات والأشكال على حساب المضامين والمحتوى والغايات. وتجد كثيراً من الناس يمارسون العبادات ويلتزمون بالسنة النبوية في لباسهم وحديثهم مع الآخرين، لكن ذلك من دون أن ينعكس على سلوكهم الأخلاقي تجاه أنفسهم والآخرين والمجتمع والدولة.
لماذا لا تنعكس ميول المزاج الاجتماعي العام المتصاعدة نحو التدين على واقع هذه المجتمعات فتغيره نحو الأفضل تنموياً وسياسياً واقتصادياً واجتماعياً؟ لأنّ أغلب الناس باختصار لا يجدون تناقضاً حقيقياً بين تديّنهم وبين حالة الانحطاط العام، بل إن مساحة واسعة من "التدين الشعبي" تتواطأ مع الانحطاط وتتعانق معه، ولا تشعر أنّ الإسلام هو صنو المدنية والحداثة والحضارة والتقدم وخصم الانحطاط والتخلف والأمّيّة!
في كتابه الجميل "دراسات قرآنية" يرسّخ المفكّر الإسلامي الأستاذ محمد قطب قاعدةً مهمة في إدراك أسرار القرآن وروح الشريعة الإسلامية عندما يؤكّد أنّ الآيات القرآنية تربط دوماً العقيدة والإيمان بالجانب الأخلاقي والسلوكي للإنسان (الصدق، الوفاء بالعهد، الالتزام بالعقد، أداء الأمانات) وتجعل منه مؤشّراً واضحاً ورئيساً على حقيقة إيمان الشخص أو كفره وضلاله!
ما نراه اليوم أن غالبية أشكال التديّن تتخذ طابعاً شكلياً وصورياً، بل بالتأمل بصورة أكبر في جذور المدارس الفكرية الإسلامية نجد أنّها أقرب إلى اتجاهين رئيسين؛ الاتجاه الأول يمتد إلى ابن تيمية ومدرسته السلفية وما نجم عنها لاحقاً، من موقف حاد من الشيعة والصوفية والفرق الأخرى، والتمركز بصورة كبيرة حول النص، وهو ما أخذته بصورة أكثر تشدداً الدعوة الوهابية لاحقاً، ومن ثم السلفية المعاصرة، فيما لم تشكّل السلفية العقلانية في بداية القرن إلاّ شذوذاً عن هذه المدرسة.
أما الاتجاه الثاني، فيمثّل امتداداً للغزالي ونزوعه الصوفي الوجداني المذهبي، وفيه أيضاً موقف متحفّظ من الفلسفة والنزعة العقلانية.
في المقابل، ومع الاحترام لميراث هذين العالمين ومدرستيهما الكبيرتين إلاّ أنّنا لا نلحظ امتداداً مماثلاً لمدرسة ابن رشد، رغم أنّه ساهم مساهمة كبيرة في بروز عصر التنوير في الحضارة الغربية، وفي الانتفاضة الفكرية المعرفية على الكنيسة.
ما نحتاجه ليس قياس مدى انتشار التدين، بل نوعيته ومدى تأثيره في تغيير الأوضاع العامة والاتجاه بالمجتمعات نحو المدنية والحضارة والمسؤولية المجتمعية والمدنية والأخلاقية والمعرفة.
* المصدر: جريدة الغد الأردنية، 12-11-2010
انحطاط التديّن وتديين الانحطاط!
محمد أبو رمان
ثمة مسافة شاسعة جداً بين أنماط التديّن السائدة في مجتمعنا ومقاصد الشريعة الإسلامية وغايات الخطاب القرآني، وفي أحيان كثيرة يعكس تديّن شريحة اجتماعية واسعة أزمة اجتماعية وليس إيماناً نابعاً من إدراك عميق لأبعاد الرسالة الإسلامية في حياة الفرد والمجتمع والدول.
بالضرورة، ليس من الممكن أن نتصور أن يصل الناس جميعاً إلى الدرجة نفسها من الإدراك والعلم لمعاني الإسلام ودلالات وعلل الأحكام الشرعية، لكن على الأقل أن يكون التيار العام في المجتمعات أقرب إلى إدراك هذا الفهم، وليس العكس.
تجليّات "أزمة التدين" أو "التدين المنحط"، بعبارة أكثر قسوة بتعريف الفقيه الإسلامي المغربي، د. أحمد الريسوني تبدو في كثير من مجالات الحياة، ولعلّ المثال الأبرز اليوم هو ما نشهده من تفجير للكنائس في العراق ومن اقتتال وعصبيات بين السنة والشيعة ومن حوادث تفجير ومن استباحة دماء الناس على أتفه الأسباب.
تبدو الأزمة بصورة أكثر تماسّاً مع حياتنا اليومية وقيمنا المجتمعية وبعلاقة الفرد مع نفسه ومجتمعه ودولته، وقد لخّص ذلك بجملةٍ واحدة المفكر والمؤرخ العراقي الكبير علي الوردي فيما وصفه بـ"الإسلام الصوري"، على غرار "المنطق الصوري" الذي حكم العقل الفقهي المسلم قروناً من الزمن.
"التدين الشكلي" أو الصوري يعني اهتمام الناس بالمظاهر والقشور والجزئيات والأشكال على حساب المضامين والمحتوى والغايات. وتجد كثيراً من الناس يمارسون العبادات ويلتزمون بالسنة النبوية في لباسهم وحديثهم مع الآخرين، لكن ذلك من دون أن ينعكس على سلوكهم الأخلاقي تجاه أنفسهم والآخرين والمجتمع والدولة.
لماذا لا تنعكس ميول المزاج الاجتماعي العام المتصاعدة نحو التدين على واقع هذه المجتمعات فتغيره نحو الأفضل تنموياً وسياسياً واقتصادياً واجتماعياً؟ لأنّ أغلب الناس باختصار لا يجدون تناقضاً حقيقياً بين تديّنهم وبين حالة الانحطاط العام، بل إن مساحة واسعة من "التدين الشعبي" تتواطأ مع الانحطاط وتتعانق معه، ولا تشعر أنّ الإسلام هو صنو المدنية والحداثة والحضارة والتقدم وخصم الانحطاط والتخلف والأمّيّة!
في كتابه الجميل "دراسات قرآنية" يرسّخ المفكّر الإسلامي الأستاذ محمد قطب قاعدةً مهمة في إدراك أسرار القرآن وروح الشريعة الإسلامية عندما يؤكّد أنّ الآيات القرآنية تربط دوماً العقيدة والإيمان بالجانب الأخلاقي والسلوكي للإنسان (الصدق، الوفاء بالعهد، الالتزام بالعقد، أداء الأمانات) وتجعل منه مؤشّراً واضحاً ورئيساً على حقيقة إيمان الشخص أو كفره وضلاله!
ما نراه اليوم أن غالبية أشكال التديّن تتخذ طابعاً شكلياً وصورياً، بل بالتأمل بصورة أكبر في جذور المدارس الفكرية الإسلامية نجد أنّها أقرب إلى اتجاهين رئيسين؛ الاتجاه الأول يمتد إلى ابن تيمية ومدرسته السلفية وما نجم عنها لاحقاً، من موقف حاد من الشيعة والصوفية والفرق الأخرى، والتمركز بصورة كبيرة حول النص، وهو ما أخذته بصورة أكثر تشدداً الدعوة الوهابية لاحقاً، ومن ثم السلفية المعاصرة، فيما لم تشكّل السلفية العقلانية في بداية القرن إلاّ شذوذاً عن هذه المدرسة.
أما الاتجاه الثاني، فيمثّل امتداداً للغزالي ونزوعه الصوفي الوجداني المذهبي، وفيه أيضاً موقف متحفّظ من الفلسفة والنزعة العقلانية.
في المقابل، ومع الاحترام لميراث هذين العالمين ومدرستيهما الكبيرتين إلاّ أنّنا لا نلحظ امتداداً مماثلاً لمدرسة ابن رشد، رغم أنّه ساهم مساهمة كبيرة في بروز عصر التنوير في الحضارة الغربية، وفي الانتفاضة الفكرية المعرفية على الكنيسة.
ما نحتاجه ليس قياس مدى انتشار التدين، بل نوعيته ومدى تأثيره في تغيير الأوضاع العامة والاتجاه بالمجتمعات نحو المدنية والحضارة والمسؤولية المجتمعية والمدنية والأخلاقية والمعرفة.
* المصدر: جريدة الغد الأردنية، 12-11-2010
