عوامل تقوية الوحدة الإسلامية في الشعائر الدينية
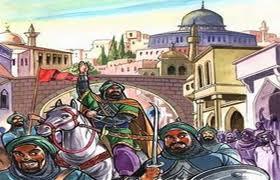
أحمد بن حمد الخليلي
مقدمة:
الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه ، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد ، الرحمة المهداة للعالمين ، والنعمة المسداة للخلق أجمعين ، وعلى آله وصحبه ، وعلى تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ، أما بعد:
فقد اقتضت إرادة الله تعالى أن تقوم حياة النوع الإنساني في الأرض من بين سائر الخلق على أسس من النظم الإجتماعية ، وتحت مظلة الأوضاع المدنية ، لأن الإنسان بتكوينه الخِلقي أُعد ليكون اجتماعياً بفطرته ، مدنياً بطبعه ، ولذلك كان الناس متداخلين في معايشهم ، متشابكين في مصالحهم لا يستغنى صنف منهم عن غيره ، فالرجل والمرأة ، والقوي والضعيف ، والحاكم والمحكوم ، والغني والفقير ، لا تجد أحدا منهم يتقل في حياته بنفسه مستغنيا عن بني جنسه . فالملك مثلا أو السلطان أو الرئيس هو في منتهى الحاجة إلى جميع طبقات الناس المختلفة ، فهو بحاجة إلى الوزير والمستشار ، والقاضي والكاتب ، والبيب والمهندس ، والجندي والشرطي ، والتاجر والفلاح ، والبناء والنجار ، والين والسباك ، والخدام والطباخ ، والحارس والسائق وغيرهم من ذوي الخبرات الفنية ، والمهارات العلمية ، والإختصاصات العملية ، وقل مثل ذلك في جميع طبقات الناس مهما رقوا إلى مدارج الكمال ، وتبوأوا مقاعد العز والشرف .
وهل من أحد أكرم من الله على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم الذي رفع قدره فوق النبيين ، وفضّله على خلقه أجمعين؟ وقد كانت حياته –من هذه الناحية- كحياة سائر البشر ، فكان يأكل الطعام ويمشي في الأسواق ، ويتزوج النساء ، ويتداوى من الأمراض ، ويستعين بذوي الإختصاص في مختلف الأعمال ، وقد أمره الله تعالى أن لا يستغنى برأيه عن مشورة أصحابه رضي الله عنهم ، فقد قال له: ((وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ)) { سورة آل عمران / الآية 159 } مع أنه أحصف منهم رأيا ، وأعمق منهم نظرا ، وأعظم اقتدارا ، وأقوى فهما ، وبجانب هذه المزايا التي كان يتمتع بها فقد كان مختصا من بينهم بتنزيل الوحي عليه بأمر الله ، ينير له السبيل ، ويرفع له الدليل ويبين له ما يأتي وما يذر ، وما يقول وما يعمل ، فلو استغنى أحد من البشر عن بني جنسه لكان أولى الناس بذلك هذا النبي المجتبي والرسول المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام ، ثم سائر النبيين الذين اصطفاهم الله من سائر خلقه لأن يكونوا وعاء لنوره وحملة لرسالته ، ولكن أنى ذلك ، وقد اقتضت مشيئة الله أن تكون حياة البشر أجمعين متشابهة من هذه الناحية ، فتلك سنتها التي لا تتبدل حتى يرث الله الأرض ومن عليها ، وتلك نواميسها التي لا تتحول حتى يتحول الوجود كله إلى نشأة أخرى ((وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا)) { سورة الأحزاب: آية 62 ، وسورة الفتح: آية 23 }.
وإذا كانت هذه هي سنة الحياة التي أرادها الله لهذا الصنف من خلقه فإن التفاهم ، والترابط والتآلف ، والتعاون بين الناس ضرورة ملحة من ضرورات حياتهم ، ومطلب مهم من مطالب فطرتهم سواء كان ذلك في محيط ضيق كالأسرة والعشيرة ، أو محيط أوسع كالمجتمع والأمة.
وبما أن الإسلام دين الفطرة الذي يأتلف معها ولا يختلف ، وينسجم مع مطالبها ولا يصطدم كما هو صريح في قوله تعالى: ((فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ)) { سورة الروم: آية 30 } فإنه جاء يقوي هذه الروابط ، ويمتن هذه الصلات في تعاليمه السمحة ، ففرض حقوق الوالدين ، وحقوق الزوجين ، وحقوق ذوي القربى ، وحقوق الجوار ، وحقوق المسلمين عامة ، وحقوق البشر بصفة أعم ، مراعيا في ذلك مطالب الفطرة وضرورات الحياة واضعا كل شيء في موضعه في نظام رتيب تعجز عن مثله قدرات البشر.
ومن تفقد أحوال البشر وأمعن في تعاليم الإسلام أيقن أن شؤونهم لا تصلح إلا به ، وأوضاعهم لا تستقر إلا عليه ، وأن الإسلام في كل ما يشرع من حكم بين الناس وما يفرضه من العبادات وما يحذر منه من المحظورات يهدف إلى إصلاح الإنسان ، ويراعي ما يجمع شمله ، ويلملم شتاته ، ويؤلف بين قلوب أفراده ، ويستأصل ما يورث بينهم البغضاء والأحقاد والكراهية ، ومن نظر في تضاعيف الكتاب والسنة وجد أن الإتحاد مطلب أساسي من مطال الإسلام ، فالإسلام كما يأمر بالإيمان والتقوى يأمر بالألفة والوفاق ، وكما يحذر من الكفر والفجور يحذر من الفرقة والشقاق ، قال تعالى: ((أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُواْ وَاذْكُرُواْ نِعْمَةَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاء فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَىَ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ)) { سورة آل عمران: الآيات 102-103 } ، وقال: ((وَلاَ تَكُونُواْ كَالَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَاخْتَلَفُواْ مِن بَعْدِ مَا جَاءهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُوْلَـئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ)) { سورة آل عمران: آية 105 } ، وقال: ((إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ)) { سورة الأنعام: آية 159 } ، وقال: ((وَلاَ تَنَازَعُواْ فَتَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ)) { سورة الأنفال: آية 46 }.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا) (1) وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم وقال: (مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر) (2) ، وقال: (المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. بحسب امرئى من الشر أن يحقر أخاه المسلم) (3) ، وقال صلى الله عليه وسلم: (المسلمون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم ويسعى بذمتهم أدناهم ...) الحديث (4).
ولأجل المحافظة على وحدة الأمة والمجتمع شدد الإسلام الحكم في كل ما يؤدي إلى تفككها فحرم السخرية واللمز والتنابز بالألقاب وسوء الظن ، والتجسس والغيبة ، والتعالي بالأنساب والأحساب ، قال تعالى: ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَومٌ مِّن قَوْمٍ عَسَى أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاء مِّن نِّسَاء عَسَى أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الاِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ)) { سورة الحجرات: الآيات 11-13 } ، ومثل ذلك تحريم السباب والقتال بين المسلمين وإلحاقهما بالفسوق والكفر ، قال النبي صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم: (سباب المسلم فسوق وقتاله كفر) (5) ، وقال عليه الصلاة والسلام: (لا ترجعوا من بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض) (6).
وعوامل الوحدة بين الأمة الإسلامية متوفرة في تضاعيف تعاليم الإسلام ، لا تنحصر في جانب دون آخر ، فعقيدة الإسلام نفسها من أعظم أسباب ترابط الأمة واتحادها ، وهكذا شريعته ، وعباداته ، وآدابه ، ومثله ، وسنتناول في هذا البحث المختصر عوامل تقوية الوحدة الإسلامية في الشعائر الدينية ، وسبل تحقيق فعاليتها حسبما طلب منا أن نشارك في هذا الملتقى الإسلامي الكبير.
ولعل من نافلة القول التأكيد بأن الشعائر الدينية في الإسلام من أبرز العوامل وأقوى الوسائل للتآلف والترابط والتواد والتعاطف بين أفراد الأمة المسلمة الذين يدينون بهذه الشعائر ويمارسونها بأمانة وإخلاص نابعين من الشعور بالمسؤولية أمام الله سبحانه ، ومما يؤكد ذلك الصيغة التعليمية التي جاءت في القرآن لإرشادنا وتوجيهنا في توجيه العبادة إلى الله عز وجل ، فقد جاءت هذه الصيغة في سورة تتكرر في كل ركعة من ركعات الصلاة التي هي أم العبادات وأقدسها ، تلكم الصيغة هي قوله تعالى: ((إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ)) { سورة الفاتحة: الآيات 4-5 } ، فإن ضمير الجمع فيها يبعث في نفس العابد المستعين شعورا باندماجه مع سائر العابدين الذين يشتركون معه في هذه العبادة (7) ، وليس بخاف ما يترتب على هذا الشعور من التآلف والتراحم ، وما ينبعث من روح الإخاء الديني.
وبعد هذا التمهيد الذي وضعته بين يدي هذا البحث المتواضع أنتقل إلى ذات الموضوع.
الشعائر لغة واصطلاحا:
الشعائر جمع شعيرة وشعارة وهي لغة بمعنى العلامة لأنها مأخوذة من أشعر بمعنى أعلم(8) ، واصطلاحا ما جعل علامة على أداء عمل من أعمال الحج والعمرة ، وهي المواضع المعظمة مثل المواقيت التي يقع عندها الإحرام ومنها الكعبة والمسجد الحرام ، والمقام ، والصفا والمروة ، وعرفة ، والمشعر الحرام بمزدلفة ، ومنى ، والجمار(9) ، وتوسع فيها فأطلقت على كل شيء جعل علما من أعلام طاعة الله(10) ، واطلقت على نفس العبادات(11) وذلك لأنها أدل دليل على طاعة الله سبحانه ، فهي من علائم الإنقياد لعزته والخضوع لجبروته ، وحصرها بعضهم في العبادات الاجتماعية كالأذان وصلاة الجمعة والعيدين(12).
وقد شاع في عصرنا إطلاق الشعائر على أمهات العبادات المعروفة ، وهي الصلاة ، والزكاة ، والصيام ، والحج بكل ما اشتملت عليه من شروط وأركان وهو الذي يفهم من قول الإمام محمد عبده: " في الأحكام التي شرعها تعالى نوع يسمى بالشعائر ومنها ما لا يسمى بذلك كأحكام المعاملات كافة لأنها شرعت لمصالح البشر فلها علل وأسباب يسهل على كل إنسان أن يفهمها ، فهذا أحد أقسام الشرائع ، والقسم الثاني هو ما تعبدنا الله تعالى به كالصلاة على وجه مخصوص ، وكالتوجه فيها إلى مكان مخصوص سماه الله بيته مع أنه من خلقه كسائر العالم ، فهذا شيء شرعه الله وتعبدنا به لعلمه بأنه فيه مصلحة لنا ، ولكننا نحن لا نفهم سر ذلك تمام الفهم من كل وجه " (13) ، وما قاله في الصلاة يصدق على سائر أركان الإسلام العملية فإنها جميعا شرعت لتحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى ، ولذلك كانت منطوية على أشياء غامضة بالنسبة إلى العباد ، كتحديد مواقيت الصوم ، ومشروعية مناسك الحج ، وكون هذه الأعمال تعبدية محضة لا ينافي انطواءها على مصالح للعباد قد تظهر منها جوانب لهم وتخفي جوانب أخرى ، ومن بين هذه المصالح ما ينتج عن هذه العبادات من ألفة وتواد بين الناس وهذا هو موضوع بحثنا هذا.
الصلاة:
الصلاة هي أساس العبادات ومجمع الطاعات ، حض الله عليها في كثير من آيات الكتاب ، فكم نجد فيها تكرار قوله: ((وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ)) ، وقال تعالى: ((حَافِظُواْ عَلَى الصَّلَوَاتِ والصَّلاَةِ الْوُسْطَى)) { سورة البقرة: آية 238 } ، وصدر بإقامتها والمحافظة عليها أوصاف المؤمنين ونعوت المتقين والمحسنين ، كما هو واضح في قوله: ((هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ)) { سورة البقرة: الآيات 2-3 } ، وقوله: ((قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ)) { سورة المؤمنون: الآيات 1-2 } ، وقوله: ((إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ)) {سورة الأنفال: الآيات 2-3 } ، وقوله ((هُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُم بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ)) { سورة النمل: آية 2-3 }، وقال: ((هُدًى وَرَحْمَةً لِّلْمُحْسِنِينَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُم بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ)) { سورة لقمان: الآيات 3-4 } ، وقال في الذين يستوجبون نصر الله بسبب نصرتهم له: ((الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ ... الآية)) { سورة الحج: آية 41 }.
وإذا كانت صفات البررة الأخيار تصدر بالمحافظة على الصلاة كما في هذه الآيات وغيرها ، فإن صفات أضدادها الفجرة الأشرار يذكر أيضا في طليعتها إهمال الصلاة وعدم المبالاة بها كما هو واضح في قوله تعالى: ((فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا)) { سورة مريم: آية 59 } ، وقوله فيما يحكيه من إجابة الكفار بعدما يصلون النار: ((لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ)) { سورة المدثر: الآيات 43-46 }.
وقد عنيت السنة النبوية بالحض عليها عناية بالغة ، ومما جاء في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ((لكل شيء عمود وعمود الدين الصلاة وعمود الصلاة الخشوع)) (14) ، وقوله: ((لا إيمان لمن لا صلاة له)) (15) ، وقوله: ((ليس بين العبد والكفر إلا تركه الصلاة)) (16) ، وقوله عليه الصلاة والسلام: ((العهد الذي بيننا وبينكم الصلاة فمن تركها فقد كفر)) (17) ، وذكر صلى الله عليه وسلم الصلاة يوما فقال: ((من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة ، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي ابن خلف)) (18).
وإذا كانت العبادات في الإسلام على اختلافها في الكيفية والأداء ذات أثر عميق وتأثير بالغ في سلوك العابد الشخصي ونظامه الاجتماعي فإن الصلاة أبلغها أثرا ، وأقواها تأثيرا ، فهي تجتث رذائل النفس ، وتغرس فيها روح الفضيلة ، وتبعث فيها عزائم الخير ، وتنهها عن دواعي الشر ، وتفجر فيها عواطف الرحمة والإحسان ، ولذلك كانت أكثر العبادات تكرارا في عمل الإنسان.
وقد تحدث القرآن الكريم عن أثر الصلاة في آيات متعددة ، منها قوله تعالى: ((وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي)) { سورة طه: آية14 } ، وقوله: ((وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ)) { سورة العنكبوت: آية 45 } ، وقوله: ((إِنَّ الْإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا إِلَّا الْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ)) { سورة المعارج: الآيات 19-23 }. فقد جعل الله في هذه الآيات الصلاة أقوى العوامل في تطهير النفس من أدران الأخلاق المذمومة التي تعد من الطبائع التي جبل عليها الإنسان ، وهذا إذا أداها العبد محافظا عليها ومخلصا فيها لا يرجو بها إلا وجه الله ، ولا يستشعر فيها إلا عظمته ، أما إذا أداها على غير هذا الوجه فلن تعدو أن تكون كالجسم المتعفن ، الهامد بعدما انتزعت منه الروح ، وهذا واضح في قوله تعالى: ((أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ)) { سورة الماعون: آية 1-5 } إذ ترون كيف ربط الله سبحانه بين هذه الموبقات التي نعاها على القوم الظالمين- وهي التكذيب بالدين ، ودّع اليتيم ، وعدم الحض على طعام المسكين- وبين السهو عن الصلاة بالفاء الرابطة لما بعدها بما قبلها ، وما هو إلا تنبيه على أن ما ذكر إنما نشأ من عدم المحافظة على الصلاة المشروعة ، وهو بالتالي تنبيه على أن ما ذكر إنما نشأ من عدم المحافظة على الصلاة المشروعة ، وهو بالتالي تنبيه على أن الذين يؤدون الصلاة كما شرعها الله كاملة غير منقوصة شكلا وروحا مبرأون من هذه الخصال.
وقد صور لنا النبي صلى الله عليه وسلم أثر الصلاة في النفس بما هو أقرب إلى الحس من الامور المشاهدة المألوفة حيث قال: ((أرأيتم لو أن على باب أحدكم نهرا جاريا غمرا ينغمس فيه كل يوم وليلة خمس مرات. أيبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يا رسول الله ، قال: فذلك مثل الصلوات الخمس)) (19).
ذلك لأن المطلوب في الصلاة أن يقف المصلي بين يدي ربه مستشعرا ذله وصغره أمام العزة المطلقة والكبرياء المطلق ، خاشعا وجلا تاركا وراءه هموم الدنيا وأشغالها ، لا يستحضر إلا ما يتلوه ويردده من ذكر الله في قيامه وقعوده ، وركوعه وسجوده ، وفي تنقلاته بينها ، وأكثر ما يتردد من الذكر على لسانه تكبير الله تعالى الذي يفتتح به الصلاة ويردده في انتقاله من حال إلى حال فيها وهو كاف لإيقاظه من غفلته ، وإفاضة شعور يملأ شعاب النفس ويبلغ في أعماق العقل والوجدان بأن الكبرياء لله تعالى وحده ، والناس وإن تباينت طبقاتهم حسب أعرافهم المصطنعة ما هم إلا عبيد أذلاء بين يديه ، نافذة فيهم مشيئته ، ماض فيهم قضاؤه ، لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ، لا فرق في ذلك بين قوي وضعيف ، ولا بين كبير وصغير ، ولا بين غني وفقير ، ولا بين جنس وآخر ، فقد قال عز وجل: ((يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ)) { سورة الحجرات: آية13 } ، فليس من الحكمة والعقل ولا من المصلحة للإنسان أن يتعالى على أحد من خلق الله لمنافاة ذلك للتقوى التي هي ميزان التفاضل بين الناس ، ولأن أثر ذلك يعود على النفس بما تكره في الدنيا والآخرة ، وهكذا كل ما يتلوه المصلي في صلاته من قرآن أو تسبيح أو أي ذكر كان تفتح كل كلمة منه آفاقا من الفكر النير فتستنير بصيرته وتصفو سريرته وتستقيم في الناس سيرته.
واشتراك جميع المصلين من الأمة –وكلهم مطالبون بالصلاة ومخاطبون بأدائها على وجهها الشرعي- في التحلي بهذه القيم والتخلق بهذه الفضائل يؤدي إلى تفاعل جميع أفراد الأمة في أسرهم ومجتمعاتهم ، وبهذا تتماسك جميع أجزاء الأمة فتكون متحدة في مبادئها وغاياتها ، وفي مسيرها ومصيرها ، وفي سلوكها وعاداتها ، وفي أحاسيسها ومشاعرها ، وفي آمالها وآلامها يشد قويها أزر ضعيفها ، ويسد غنيها حاجة فقيرها ويوقر صغيرها كبيرها ، ويرحم كبيرها صغيرها ، وفي ذلك تجسيد لما يدعو إليه قوله تعالى: ((إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ)) { سورة الحجرات: آية10 } ، وقوله: ((إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ)) { سورة الأنبياء: آية 92 } ، وقوله: ((وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ)) { سورة المؤمنون: آية 52 }.
صلاة الجماعة:
إذا كانت الصلاة تنبع منها هذه القيم ، وتنبعث منها هذه الفضائل فإن أداءها في الجماعات يضاعف من رسوخ هذه المعاني في النفس ، وتمكنها من العقل والقلب ، فما أروع لك المشهد الذي يجمع شتاش الناس في ظل العبودية لله سبحانه فتصطف صفوفهم بين يديه متراصين في وقفتهم ، منتظمين في حركاتهم ، قد تحطمت بينهم جميع الفوارق المصطنعة ، وتطايرت عنهم جميع النعرات المختلفة ، يقف الغني والفقير ، والقوي والضعيف ، والحاكم والمحكوم جنبا إلى جنب لا يعظمون غير الله ، ولا يبتغون إلا وجهه ، تخر له جباههم ساجدة ، وتنحني له ظهورهم راكعة ، وتذل له رقابهم صاغرة ، لا يستجيبون إلا لداعي الله ، ولا يلتفتون إلا على مائدة عبادته ، يداوون بها نفوسهم من غرورها ، ومن سائر عيوبها وشرورها.
إن مثل هذا اللقاء الروحاني لجدير بأن تلتحم في الأرواح قبل أن تلتقي الأجساد ، وأن تمتزج فيه المشاعر ، وتتعاطف فيه القلوب فيتبخر –بحرارة الإيمان- بما فيها من سخائم وأحقاد ، ويتلاشى بسيل المودة وما يغشاها من بغض وكراهية.
وللصلاة في الجماعة فضل عظيم بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم بقوله: ((صلاة الجماعة تفضل على صلاة أحدكم وحده بخمس وعشرين درجة)) (20) ، وفي رواية أخرى ((الصلاة في الجماعة خير من صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة)) (21).
ولم تختلف الأمة في مشروعية الجماعة في الصلوات الخمس وفي فضلها ، وإنما اختلفت في حكمها ، فعدها بعضهم واجبة على الأعيان ، وغيرهم واجبة على الكفاية ، وآخرون سنة مرغبا فيها ، والقول الأول هو الصحيح للأدلة المتظافرة الدالة عليه ، وليس هذا المقام محلا لبحثها (22).
صلاة الجمعة:
إذا كانت الصلوات الخمس في الجماعات تجمع عددا محدودا من الناس في كل يوم وليلة خمس مرات لتطهرهم من أرجاس الإثم ، وتصفيهم من أكدار البغضاء والأحقاد ، فإن صلاة الجمعة تجمع عددا أكبر في كل يوم جمعة من كل أسبوع ليزدادوا صفاء ونقاء ونورا وبهاء ، وليكون في ذلك تذكيرهم بأكثر من معنى ليشكروا نعمة الله عليهم وليقووا صلتهم به ، معتصمين بحبله المتين ، ومتمسكين بعروته الوثقى ، ففي يوم الجمعة خلق الله آدم أبا البشر ، وفيه تاب عليه ، وفيه أهبط من السماء إلى الأرض ، وفيه تقوم الساعة ، وفيه ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا ، إلا أعطاه إياه (23).
وفي صلاة الجمعة ما في غيرها من الصلوات من التذكير والتبصير ، وإنما اختصت الجمعة بمشروعية الخطبة التي تبصر السالكين ، وتذكر الغافلين ، وتهدي إلى الصراط المستقيم ، وفي هذا كله شد للأواصر الاجتماعية ، وربط للفرد بأسرته ومجتمعه وأمته ، وهي فرض بنص القرآن ، وسُـنة الرسول صلى الله عليه وسلم ، وإجماع الأمة.
الزكــاة:
الزكاة –وإن كانت نظاما ماليا اجتماعيا- معدودة في ضمن شعائر الدين ، لأنها من أمهات العبادات التي تغرس روح التقوى في نفس العابد ، وتهيئه لن يكون عبداً مخلصا لربه ، وفردا صالحا في مجتمعه.
وفي معناها الشرعي يتحقق كلا أصليها اللغويين ، فإن قلنا إنها من زكا يزكو –بمعنى طهر يطهر- فلا ريب أنها طهارة للنفس من الشح وآثاره الذميمة ، وللمال المزكى من الأقذار ، وإلى هذا يومئ قوله تعالى: ((خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا)) { سورة التوبة: آية 103 } ، وإن قلنا إنها من زكا –بمعنى نما- فهي أيضا نماء للنفس بما يجعل الله فيها بسببها من الخير ، وبما يغرس من الأخلاق الفاضلة والخصال المحمودة التي لا تؤدي إلا إلى صالحات الأعمال ، كما أنها نماء للمال بما يجعل الله فيه من البركة فيؤتى ثماره هنيئة طيبة ، وإلى هذا يومئ قوله تعالى: ((وَيُرْبِي الصَّدَقَات ِ)) { سورة البقرة: آية 276 }.
وإيتاء الزكاة –كإقام الصلاة- من خصائص المؤمنين والمحسنين ، فقد وصف الله به المؤمنين في قوله: ((وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ)) { سورة المؤمنون: آية 4} ، وقوله: ((هُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ)) { سورة النمل: الآيات2-3 } ، كما وصف المحسنين بقوله: ((هُدًى وَرَحْمَةً لِّلْمُحْسِنِينَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ)) { سورة لقمان: الآيات 3-4} ، ولأجل تأكيد فرضيتها وبيان مكانتها في الإسلام قرنت بأهم ركن عملي من أركانه وهو الصلاة في كثير من الآيات والأحاديث ، وكفى زجرا وتحذيرا من إضاعتها أو التهاون بها أن الله سبحانه جعل عدم إيتائها من صفات المشركين ، ومن أسباب وعيدهم في قوله: ((وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ)) { سورة فصلت: الآيات 6-7 }.
ومزايا الزكاة وفضائلها أكثر من أن تحصى ، وحسبكم ما في الكتاب والسُـنة من الإشادة بذكرها ، والحض عليها ، والثناء على مؤتيها ، والوعد على الوفاء بحقوقها ، والوعيد على التفريط فيها.
وهي من عوامل الوحدة بين الأمة الإسلامية إن حافظت عليها ، لأنها تصل بين طبقتي الأغنياء والفقراء ، وتردم الهوة الفاصلة بينهما ، فهي تعطف قلوب الأغنياء على الفقراء بما ينشأ بسببها من الرحمة الباعثة علىالإحسان ، كما أنها تعطف قلوب الفقراء على الأغنياء بما يجعل الله فيها بسببها من المودة والتقدير لإحسانهم.
والزكاة بحق هي أهم علاج لمرض نفسي اجتماعي يفتك بالأخلاق فتكاً ويقطع الأواصر قطعا ، ويستعصى على العلاج إذا استحكم في النفس واستولى على العقل والقلب ، فكان جبلة لا تتحول ، وجرثومة لا تستأصل ، ذلكم المرض الفتاك هو شهوة المال التي قلما تسلم منها نفس ، وإنما يتفاوت الناس فيها بقدر اختلافهم في العناية بمعالجتها.
وما أعظم الجرائم التي ترتكب بدافع من هذه الشهوة الخفية ، فما السرقة والغش والربا ، وأنواع التحايل على جمع المال بغير وجهه الشرعي إلا من آثارها ، بل كثيرا ما تؤدي إلى القتل والقطيعة ، وضروب من الفتن بين الأقربين والأصدقاء المتأخرين ، فكم غني جنى عليه ماله فتعرض للقتل أو الضرب من أقرب المقربين عنده وأخلص المخلصين في ظنه ، وقد عالج الإسلام بحكمته البالغة هذا الداء العضال ، ففرض ضروبا من النفقات –وعلى رأسها الزكاة- لكف النفس عن غلوائها وشططها في حب المال.
وأهم أساس بنى عليه الإسلام نظامه المالي جعلُ كل ما بيد الإنسان ملكا لله تعالى الذي له ما في السماوات وما في الأرض ، وجعل الإنسان مستخلفا فيه ومؤتمنا عليه كما هو صريح في قوله تعالى: ((وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ)) { سورة النور: آية 33 } ، وقوله: ((وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ)) { سورة الحديد: آية 7 } ، وبنى على ذلك حكمه في الكسب والإنفاق ، فلم يطلق يد الإنسان فيهما كما تسول له نفسه بل بين له فيهما ما يأتي وما يذر ، فليس له أن يتجاوز الوسائل المباحة في الكسب ، كما أنه ليس له أن يتجاوز الحدود المشروعة في الإنفاق فيضع مال الله الذي ائتمنه عليه واستخلفه فيه في غير محله ، ولذلك كان العبد يوم القيامة مسؤولا عن الأمرين معا (الكسب والانفاق) ، كما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تزول قدما ابن آدم يوم القيامة حتى يسأل عن خمس ... إلى أن قال: وعن ماله من أين أكتسبه وفيم أنفقه؟) (24) ، وهو يعني وجوب التقيد بإذن الله تعالى في الكسب والإنفاق.
ومن الإنفاق ما يُـعد من الفروض اللازمة التي لا خيار فيها للإنسان ، ولذلك نرى في آية البر إنفاق المال مقترنا بالعقيدة مقدما على سائر أعمال البر حتى الصلاة نفسها ، وذلك في قوله تعالى: ((وَلَـكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَالْمَلآئِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّآئِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ)) { سورة البقرة: آية 177 } ، وليس ذلك مقيدا بالزكاة فحسب بدليل قوله من بعد: ((وَأَقَامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ)) وفي هذا ما يدل على أن الإنفاق الواجب من المال لا ينحصر في الزكاة وحدها ، ومهما يكن فإن الإنفاق سواء كان من الزكاة أو من غيرها يربي الضمير الإنساني ويجعل الفرد يحس بأحاسيس مجتمعه ، يتألم بآلامه ويسر بسروره ، فيتجسد في المجتمع معنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر) ، وقوله عليه الصلاة والسلام: (لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه) (25) ، وما أعظم سرور الأغنياء عندما يرون إخوانهم الفقراء ينعمون برغد العيش ، ويرفلون في حلل النعيم بما أجراه الله لهم على أيديهم من رزق فيما آتاهم الله من مال ، فكانوا بذلك سببا لسد حاجة إخوانهم بما يوصلهم إلى رضوان الله في الدار الآخرة ، وما ينالوه من مودة الناس في الحياة الدنيا ، وما أسعد أولئك الفقراء الذين يرون حاجتهم تقضى ، وخلتهم تسد على أيدي إخوانهم الذين استخلفهم الله في ماله ، ووسع عليهم من رزقه من غير مَـنٍ ولا أذى ، ولا تعال ولا استكبار ، ومن غير أن يشعروهم بذل ولا صغار.
إن مجتمعا هذا شأنه حقيق بأن يسوده التواؤم بين أفراده ، والتلاحم بين طبقاته ، وإن أمة هذا دينها وهذه مبادئها لجديرة بأن تسود العالم وأن تقود الإنسانية ، وأن تكون رسالتها رحمة للعالمين.
الصيام:
الصيام وإن كان عبادة تركية لأنه ترك للطعام والشراب وقضاء الوطر من الحاجة الجنسية وسائر المفطرات على اختلاف العلماء فيها ، فإنه ذو أثر إيجابي في سلوك الصائمين ، بل هو من عوامل وحدة الأمة وترابطها ، وأسباب تعاونها وتكافلها ، فإن أحاسيس البشر هي مبعث تفاعل بعضهم مع بعض ، وإن الأخلاق الحميدة هي الجسر الذي يعبر عليه التعاطف بينهم ، فيتلاحم أفرادهم ومجتمعاتهم فتندمج فئاتهم وطبقاتهم .
ومن شأن الصيام أن يرهف الحس ويرقق الشعور ، ويذكي في النفس مشاعر الرحمة والإحسان ، وهو بجانب ذلك مدرسة خلقية يتربى فيها الضمير الإنساني ، وتتهذب بإيحاءاتها النفس البشرية ، وينجلي عنها صدأ طبائعها المذمومة ، وأكدار عاداتها السيئة ، وقبل الدخول في تفصيل ذلك أود أن أشير إلى أن استقامة أحوال البشر لا تتم إلا باستعلائهم على الأنانيات الفردية والمصالح الشخصية التي هي أكبر عائق في طريق وحدة الأمة وتآزرها ، وتعاطفها وتآلفها ، وذلك لا يتحقق إلا بتقوى الله سبحانه ، ولذلك نجد الأمر بالتقوى والإشادة بالمتقين والثناء عليهم ووعدهم بحسن العقبى يتخلل آيات الكتاب في معرض الأمر والنهي ، والتبشير والإنذار ، والقصص والأمثال ، والتذكير والإمتنان ، والتشريع والبيان ، إلى غير من الأغراض التي نزل من أجلها القرآن ، ولا نجد في القرآن تكرار الأمر بشيء كما تكرر الأمر بالتقوى ، وما ذلك إلا لأن التقوى إطار واسع يشتمل على كل خير فتدخل ضمنه فضائل الأقوال والأعمال ، ومحاسن السجايا والأخلاق ، كما تدخل فيه العقيدة الصافية القائمة على دعائم النقل الصحيح والعقل الصريح ، وتخرج عن هذا الإطار وتنأى عن حماه جميع الأفعال المنكرة والخصال المذمومة والأقوال القبيحة .
وكما ربط الله سبحانه بين التقوى ومطلق العبادة في قوله : يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ { سورة البقرة : آية 21 } ،خص الصوم بهذا الربط حيث قال: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُون { سورة البقرة آية 183 } ،وهذا لأن الصوم ليس هو مجرد الكف عن المفطرات الثلاث المشهورة فحسب ،ولكنه مع ذلك كف الجوارح واللسان عن قبائح الأعمال والأقوال،والتجرد التام من مذام الأخلاق والخصال ،كما يقتضيه الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وسلم ((لا صوم إلا بالكف عن محارم الله)) وقوله عليه الصلاة والسلام : ((من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه)) (26) ،وقوله : ((الصوم جنة فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يجهل فإن أحد سابه أو قاتله فليقل إني صائم)) (27) ، وفي هذه الأحاديث جميعا تأكيد بأن الصوم المشروع هو الصوم الخالص من شوائب المعصية الصافي من أكدار القبائح , ومما لا يشك فيه أن تعويد النفس على هذا الإلتزام بواجبات الإسلام وآدابه , ومراقبة الله في أحكامه وحدوده أثناء الصوم في شهر رمضان المبارك يجعل النفس تتعود على هذه الفضائل والقيم , وتستمر على هذه الخصال والأعمال في سائر العام حتى تكون كأنها من سجاياها التي جبلت عليها , وبهذا يتحقق المراد من التقوى , وفي الحديث الأخير من الأداب الرفيع ما لا يقدر قدره , ولا يحصر خيره , وكفى بما فيه من مطالبة الصائم باحتمال الأذى من الغير , وعدم مقابلة الإساءة بمثلها , فإذا تعرض لمكروه من أحد من الناس فليس له أن يثأر لنفسه ويطلق عليه يده ولسانه , بل عليه أن يقول إني صائم , ليؤدب بهذه القولة نفسه عن التطلع إلى ما تشتهيه من الإنتقام , وليذكر غيره بأسلوب غير مباشر أن ما جاء به من الأذى ينافي قدسية الصيام , فما أعظم هذا الأدب الذي لا يقف في حدود الكف عن أذى الغير فحسب , بل يتجاوز ذلك إلى احتمال أنواع الأذى التي تأتى من الغير ، وما ابلغ هذا التسامح الذي يطبع عليه الصائم إذا هو أدى صيامه على هذا النحو من الإلتزام ، وإذا كان التسامح ضرورة من ضرورات الوحدة بين الناس فإن الصيام أهم مصدر لهذا العنصر من عومل هذه الوحدة على أن جميع خصال التقوى التي تقوى بالصيام هي من أعمل العوامل في اجتذاب النفوس بعضها إلى بعض ، ومزج مشاعرها وأحاسيسها ، وهدم حواجز الأنانيات بينها ، كيف والله تعالى ينبئنا عن أمة الإيمان أنها أمة واحدة ، وأن اتحادها يجب أن يكون في ظل العبادة والتقوى كما هو واضح من قوله تعالى: إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ { سورة الأنبياء : آية 92} ،وقوله: وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ { سورة المؤمنون : آية 52 } .
وقد أجاد الإمام محمد عبده في شرحه إعداد الصيام نفوس الصائمين للتقوى حيث قال : (وإعداد الصيام نفوس الصائمين لتقوى الله تعالى يظهر من وجوه كثيرة ، أعظمها شأناً وأنصعها برهاناً ، وأظهرها أثراً ، وأعلاها خطراً (شرفاً) أنه أمر موكول إلى نفس الصائم ، لا رقيب عليه فيه إلا الله تعالى ، وسر بين العبد وربه لا يشرف عليه أحد غيره سبحانه ، فإذا ترك الإنسان شهواته ولذاته التي تعرض له في عامة الأوقات بمجرد الإمتثال لأمر ربه ، والخضوع لإرشاد دينه مدة شهر كامل في السنة ملاحظاً عند عروض كل رغيبة له – من أكل نفيس ،وشراب عذب ،وفاكهة يانعة ،وغير ذلك ، كزينة زوجة أو جمالها الداعي إلى ملابستها –أنه لو لا اطلاع الله تعالى عليه ومراقبته له لما صبر عن تناولها وهو في أشد التوق لها ، لا جرم أنه يحصل له من تكرار هذه الملاحظة –المصاحبة للعمل ملكة المراقبة لله تعالى والحياء منه سبحانه أن يراه حيث نهاه ، وفي هذه المراقبة من كمال الإيمان لله تعالى ، والاستغراق في تعظيمه وتقديسه أكبر معد للنفوس ومؤهل لها لضبط النفس ونزاهتها في الدنيا ، ولسعادتها في الآخرة .
كما تؤهل هذه المراقبة النفوس المتحلية بها لسعادة الآخرة تؤهلها لسعادة الدنيا أيضا ، أنظر هل يقدم من تلابس هذه المراقبة قلبه على غش الناس ومخادعتهم ؟ هل يسهل عليه أن يراه الله آكلاً لأموالهم بالباطل ؟ هل يحتال على الله تعالى في منع الزكاة وهدم هذا الركن الركين من أركان دينه ؟ هل يحتال على أكل الربا ؟ هل يقترف المنكرات جهاراً ؟ هل يجترح السيئات ويسدل بينه وبين الله ستاراً؟ كلا ، إن صاحب هذه المراقبة لا يسترسل في المعاصي إذ لا يطول أمد غفلته عن الله تعالى ،وإذا نسي وألم بشيء منها يكون سريع التذكر ،قريب الفيء والرجوع بالتوبة الصحيحة (إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون) ، فالصيام أعظم مرب للإرادة وكابح لجماح الأهواء ، فأجدر بالصائم أن يكون حرا يعمل ما يعتقد أنه خير لا عبداً للشهوات ، إنما روح الصوم وسره في هذا القصد والملاحظة التي تحدث هذه المراقبة وهذه هو معنى كون العمل لوجه الله تعالى) (28) .
ويقول في هذا الإمام محمد الطاهر بن عاشور: (وإنما كان الصيام موجبا لاتقاء المعاصي لأن المعاصي قسمان ،قسم ينجع في تركه التفكر كالخمر والميسر والسرقة والغضب ، فتركه يحصل بالوعد على تركه والوعيد على فعله ، والموعظة بأحوال الغير، وقسم ينشأ من دواعي طبيعية كالأمور الناشئة عن الغضب .وعن الشهوة الطبيعية التي قد يصعب تركها بمجرد التفكر فجعل الصيام وسيلة لاتقائها لأنه يعدل القوى الطبيعية التي هي داعية تلك المعاصي ليرتقي المسلم به عن حضيض الإنغماس في المادة إلى أوج العالم الروحاني ، فهو وسيلة للإرتياض بالصفات الملكية والإنتفاض من غبار الكدرات الحيوانية ، وفي الحديث الصحيح: ((الصوم جنة)) أي وقاية ، ولما ترك ذكر متعلق جنة تعين حملة على ما يصلح له من أصناف الوقاية المرغوبة ، وفي الصوم وقاية من الوقوع في المآثم ووقاية من الوقوع في عذاب الآخرة ، ووقاية من العلل والأدواء الناشئة عن الإفراط في تناول اللذات) (29)
وإذا كان الصوم يضبط غرائز الإنسان الغضبية والشهوانية وهذه الغرائز هي أخطر العوامل في تفتيت وحدة البشر وتقطيع الحبال الواصلة بين الناس عندما يستجيب كل أحد لداعي غريزته غير مبال بعاقبة أمره وأمر أسرته ومجتمعه وأمته ؛فالصوم إذاً من أقوى الضمانات لحفظ كيان الوحدة وإبعادها عما يهددها من مخاطر الأنانيات ، ومعاول الغرائز والشهوات .
وبجانب كل ما تقدم فإن الصيام سبب لإحساس ذوي اليسار بشدة المعسرين الذين تعوزهم لقمة عيش التي يسدون بها مسغبتهم ، فإن استمرار الموسر على شبعة وريه في كل أوقاته وحالاته ينسيه آلام الأمعاء الجائعة والأكباد الصادئة التي يعاني أهلها من مشكلة الفقر ، ويكابدون لأواء الحياة ،يقضون سحابة نهارهم كادحين تحت وهج الشمس ولفح القيظ لينقلبوا إلى أهلهم بشيء من الرزق ، يقسمونه على حواصل طالما عانت من السغب وكابدت من المشقة ، أما إذا شارك الأغنياء الفقراء في جوعهم وعطشهم ، وكابدوا بعض ما يكابدون من شدتهم فإن ذلك يرهف من حسهم ويرقق من شعوره فيتألمون لآلامهم ويواسونهم بما آتاهم الله ، وفي هذا يقول الإمام محمد عبده :
((ومن وجوه إعداد الصوم للتقوى أن الصائم عندما يجوع يتذكر من لا يجد قوتاً فيحمله التذكر على الرأفة والرحمة الداعيتين إلى البذل والصدقة ، وقد وصف الله تعالى نبيه بأنه رؤوف رحيم ، ويرتضي لعباده المؤمنين ما ارتضاه لنبيه صلى الله عليه وسلم ولذلك أمرهم بالتأسي به ووصفهم بقوله : رُحَمَاء بَيْنَهُمْ (30).
وبهذا التعاطف بين الأغنياء والفقراء والاشتراك في الأحاسيس والمشاعر يحصل الإنسجام وتتحقق الوحدة المنشودة)).
ومن صور الاتحاد التي تتحقق للصيام ما نبه عليه الإمام محمد عبده بقوله:
((ومن فوائد عبادة الصيام الإجتماعية المساواة فيه بين الأغنياء والفقراء والملوك والسوقة ، ومنها تعليم الأمة النظام في المعيشة ، فجميع المسلمين يفطرون في وقت واحد لا يتقدم أحدا على آخر دقيقة واحدة ، وقلما يتأخر عنه دقيقة واحدة) (31) . الحج:
الحج أجمع الشعائر الدينية لشمل الأمة الإسلامية ،إذ يلتقي في رحابه ضيوف الله عز وجل الوافدون إليه من أصقاع العالم ، وما من بلد فيه جماعة من المسلمين إلا ويفد منه وافد لأداء هذه الشعيرة ملبياً نداء الله تعالى الذي أطلقه على لسانه عبده وخليله إبراهيم عليه السلام: ((وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ)) { سورة الحج : آية 27 } ، وفي هذا اللقاء يجتمع القاصي والداني ، والأبيض والأسود ، والعربي والأعجمي ، والحاكم والمحكوم ، والقوي والضعيف ، والغني والفقير في صعيد واحد ، مؤدين عملاً مشتركاً ، مرددين بلسان واحد: ((لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك ، لا شريك لك)) ، خالعين جميع ما اعتادوه من أثواب ذات سمات متميزة ، متجرداً كل منهم في ثوبين فقط ، قد نحّوا عن أنفسهم جميع الفوارق والمميزات ، لا يستعلي أحد على آخر بنسب أو حسبٍ أو سلطان أو جاه أو منصب أو مال ، أو لون أو لغة ، وكفى بهذا اللقاء على هذه الكيفية تجسيداً لوحدة الأمة ، وتصويراً لما يجب أن تكون عليه من التواد والوئام ، والتعاطف والإنسجام ، فإن وحدة المظهر تشي بوحدة المخبر.
وإذا كان صرح الوحدة بين الأمة لا يشاد إلا على دعائم التقوى كما سبق ، فإن الحج المبرور من بين الشعائر ذات الأثر في غرس شجرة التقوى في النفس ، ومد ظلالها على المجتمع ، فإنا نجد في كتاب الله من اقتران أعمال الحج بالتقوى أكثر مما نجد في ذكر غيره من أعمال البر ، فقد قال تعالى : ((وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ)) إلى أن قال: ((وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ)) { سورة البقرة / آية 196 } ، ثم قال: ((الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللّهُ وَتَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ)) { سورة البقرة / آية 197 } ، وقال: ((وَاذْكُرُواْ اللّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ)) { سورة البقرة / آية 203 } ، وقال: ((وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ)) { سورة الحج / آية 32 }.
وفي الحج فرصة سانحة للأمة الإسلامية لالتقاء وفودهم في كل عام وتدارس مشكلاتهم في رحاب بيت الله حيث تصفو الأنفس وتسمو الأرواح وتستنير البصائر ، وتتفاعل الأنفس مع ذكريات الماضي العريق من عهد إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام اللذين رفعا بأمر الله قواعد البيت العتيق ليكون رمزاً للتوحيد وعلماً للموحدين وقبلة للمهتدين إلى عهد خاتم النبيين وسيد المرسلين محمد بن عبدالله صلوات الله وسلامه عليه وعلى جميع أنبياء الله المصطفين الأخيار الذي صدع في تلك العراص بالحق ، ونادى به ، وصبر على الأذى وتحمل ما تحمل من الشدائد حتى فتح الله على يديه قلوباً كانت غلفاً ، وبصّر الله بهداه عيوناً عُمياً ، وأسمع الله بدعوته آذاناً كانت صماً ، فتكونت من حوله عصابة ما شهد لها التاريخ مثيلاً أمسكت بزمام الدعوة بعده صلى الله عليه وسلم ، وصبرت على المكروه ، وتحملت الشدائد في سبيل الله وابتغاء مرضاة الله ، فاستحقت حسن الثناء الذي خلده الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله ، وعلى ألسنة عباده ، قال عز من قائل: ((مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاء عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاء بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا)) { سورة الفتح / آية 29 } ، وبتجدد هذه الذكريات في الأنفس يستلهم الرشد ، ويستبان المنهج ، وتتوقد الهمم الخاملة ، وتبعث العزائم الخائرة ، كما أن في تجددها وصلا لحاضر أمة الإيمان بماضيها ، وربطا بين سلفها وخلفها حتى تكون كحلقات سلسلة يشد بعضها بعضاً ، وبما أن الحج يجمع أصحاب الإختصاصات المتنوعة من جميع أقطار الأرض من رجال الفقه والفكر والسياسة والأدب وغيرهم ، ففيه فرصة اللقاء بين أفراد كل طبقة من هؤلاء لتدارس مشكلاتهم في مهبط الوحي ومطلع النور ، ومنطلق الدعوة على ضوء تعاليم الإسلام ، واستنتاج الحلول الناجعة عن كتاب الله الخالد وسنة نبيه المطهرة ومنهاج السلف الصالح ، وبهذا تتحقق حكمة الحج المشار إليها بقوله تعالى: ((لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ)) ، وما أحوج أمتنا في مثل هذا العصر إلى هذه اللقاءات التي تمسح الخلاف ، وترأب الصدع ، وترتق الفتق ، وتقيم الناس على سواء الصراط ، وإنما الأمر يفتقر إلى شيء من التنظيم لإتاحة مثل هذه الفرصة. الاقتراحات:
بعد هذا العرض السريع لعوامل الوحدة في الشعائر الدينية ، أقترح ما يلي:
(1) العناية بخط
المصدر: خاص - الوحدة الإسلامية.
