ثقافتنا القضائية يجب أن نوحدها
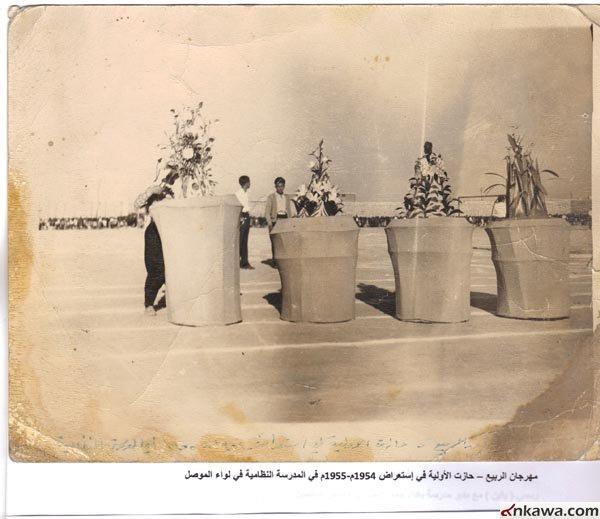
إذا كان من المسلم به بأن الاستعمار الفرنسي قد قضى على وحدة التشريع ببلادنا وهدم كيان قضائنا وبعثر محاكمنا فإن مما ينكر على المثقفين عندنا وخاصة منهم من ينتسبون إلى العائلة القضائية من قريب أو من بعيد أنهم لم يرتاحوا بعد للإصلاحات الهامة التي أنجزت لحد الآن في ميدان القضاء والتشريع فهم يعتبرون أن وجود قضاء مغربي وقانون مغربي يضمنان حقوق المواطنين أمر لا سبيل إلى تحقيقه ما دمنا لم نحدد بعد بكيفية واضحة لا تترك مجالا للشك والتردد المبادئ الأساسية والمبررات المعنوية التي يجب أن ينبني عليها قضاؤنا ويستند إليها تشريعنا... فعلماؤنا الدينيون وقضاتنا التقليديون يرون أن كل تشريع وتنظيم لا يستمد أصوله وفروعه من الكتاب والسنة غير صالح لأن يساير تقاليدنا الإسلامية ويفي بحاجياتنا المشروعة ويحافظ على طابعنا القومي. وقد لاحظ كثير من هؤلاء العلماء والقضاة على وزارة العدل اتجاهها لإصلاح المحاكم العادية وجعلها بمثابة النقطة المركزية في القضاء المغربي على حساب المحاكم الشرعية التي لم ينلها - كما يقولون- إلا بقدر ضئيل من الإصلاح فهم لا يلبثون يطلبون بأن تصبح المحكمة «الشرعية» هي حجرة الزاوية في النظام القضائي وأن يكون الفقه الإسلامي هو القانون الوحيد الذي تحكم به المحاكم في المغرب وأن يكون (القاضي الشرعي) هو الحاكم المختص لتطبيق جميع قواعد التشريع وبعبارة فهم يريدون الرجوع إلى الأصل مقدما ثم التطرق من بعد إلى الإصلاح والتوسع والتوحيد في المحكمة والقانون.
ولا مجال هنا لانتقاد هذه النظرية أو للتعريف بسياسة الوزارة في الخطة التي تنهجها لإصلاح القضاء(1) وإنما أردنا أن نذكر بإحدى طرق الاتجاه في ميدان بعث القضاء والقانون في بلادنا.
أما المثقفون الذين تلقوا دراستهم حسب المناهج العصرية ودرسوا القوانين الأجنبية فقد يرون أن لا سبيل إلى إقرار نظام قضائي صحيح وتشريع يساير مقتضيات العصران نحن لم ننبذ قضاءنا التقليدي وتشريعاتنا (العتيقة) نبذا تاما ونستعض مكانها بنظام قضائي حديث وقوانين جديدة تنبني أسسها المعنوية على مبادئ فلسفية لا تمت بصلة إلى الدين ولا تتصل في شيء بالتقاليد التيوكراسية وبعبارة فهم يريدون أن نقلد هنا بالمغرب التنظيمات القضائية والتشريعات المأخوذ بها في البلاد الغربية لا أقل ولا أكثر ذلك لأنهم يرمون الفقه الإسلامي بالجمود والتحجر والقصور لأداء مهمة القضاء والتشريع الكفيلة بإرضاء رغبات جمهور عصر الذرة والصاروخ. فقد قرأوا فولتير وديكارت وتلقوا عنهما طرق التفكير ومناهج الاستدلال والاستنتاج ودرسوا (روح القوانين) لمنتسكيو وتشبعوا بنظرياته في نظام الحكم والدولة ومبادئ التشريع ولم يتجهوا لدراسة الفقه الإسلامي وتحليل مبادئه الأساسية وأحكامه العملية وموقفه إزاء التشريعات الغربية قبل أن يحكموا عليه سلفا بالتحجر وعدم ملاءمته للحياة العصرية.
وهنا نحيط بمشكل من المشاكل التي خلفها لنا الاستعمار وهو مشكل التفرقة الثقافية لا من حيث تعدد اللغات فحسب بل وحتى من حيث تنوع المشارب والنزعات الفلسفية وتباين اساليب التفكير ووسائل العمل وحرية البحث... فقد يصعب عليك أن تدعو المثقفين من شبابنا ثقافة غربية إلى اعتناق نظرية فقهية من نظريات الإمام مالك أو نظرية في القانون العام من نظريات الموردي. بقدر ما يصعب عليك أن تهيب بعلمائنا الدينيين إلى اعتناق فكرة من أفكار منتسكيو حول الدولة أو التنظيم القضائي أو مبادئ التشريع مهما بلغت هذه الفكرة من سلامة الذوق وسمو المنطق وعدم المساس بالعقيدة الإسلامية فكل فكرة من هذا القبيل تظل في نظرهم أجنبية غريبة وبالتالي غير صالحة للحياة الإسلامية مثل ما لا تعدو نظريات مالك والماوردي في نظر المثقفين ثقافة عصرية أن تكون رموزا وأسرارا يتبرك بها وغير قابلة حتى للدراسة والتحليل فضلا عن أن تكون صالحة لأن يعمل بها في هذا العصر!
أما أن يروح السلفيون من علمائنا إلى المطالبة بتطبيق المبادئ الإسلامية وجعل الكتاب والسنة أساسا للقضاء والقانون فذلك ما لا ينبغي أن يعاب عليهم إذ هو طبيعي بالنسبة لأمة إسلامية كالأمة العربية وجدير بتلاقي ما وقع في بعض الأقطار الشرقية من إهمال القضاء القومي ونبذه نبذا تاما فإنه استجابة لهذه الرغبة العزيزة قد أولت وزارة العدل عنايتها لإصلاح محاكم القضاء والمحافظة على التشريع الإسلامي في إطاره السلفي وعملت على وضع مدونة الفقه الإسلامي ومسطرة قضائية تقي تلك المحاكم من الفوضى والارتباك التي عاشتها طيلة سنين فالوزارة ترمي من وراء هذه المرحلة الأولى في الإصلاح إلى الاحتفاظ لتلك المحاكم بطابعها الخاص وكيانها المعنوي نظرا لما يوليه جلالة الملك من عظيم العناية والاهتمام بكل ما يتعلق بأحكام الشرع والمحافظة على القيم الدينية والقومية «على أن النظام الذي سيتم لوزارة العدل قريبا تطبيقه في البلاد سوف لا يترك إلا نوعا واحدا من المحاكم في درجات مختلفة تنظر في جميع الدعاوي دون ما تمييز وسيكون توزيع الأعمال داخل الغرف والأقسام التي تتألف منها كل محكمة مبنيا على أساس مهني لا غير يراعى فيه تخصيص القضاة ومصلحة تسيير العدالة طبقا للأنظمة الداخلية لكل محكمة»(2) فليطمئن قضاتنا التقليديون وعلماؤنا السلفيون وليدركوا بأن لا مبرر ولا أساس لما يروجه بعضهم من دعاية هدامة وتهريج حول ما يسمونه بإلحاق المحاكم (الشرعية) بالمحاكم (العادية) فسوف لا تبقى هناك محكمة (شرعية) وأخرى (غير شرعية؟) إلا في نظر المتعصبين منهم. هذا وأن الخطة التي تنهجها وزارة العدل من جعل القانون العام في المغرب مستمدا في روحه من التشريع الإسلامي لخير ضمان يطمئن إليه مصير الفقه الإسلامي في بلادنا ويجعل تشريعنا قابلا للتوسع والتطور والتغذية بكل ما كان صالحا من أنظمة الغرب القضائية والقانونية.
أما أن يتنكر بعض المثقفين منا ثقافة غربية لقيمهم الدينية ولتقاليدهم فيرمون الفقه الإسلامي بالتحجر والقصور ويريدون إبعاد الناس عن حظيرة الشرع «لعدم ملائمته للحياة العصرية» ويدعون لتقليد الغرب في أنظمته القضائية والتشريعية تقليدا أعمى فذلك مما يعاب على جيل لم يتلق التوجيه الثقافي الصالح لمستقبل البلاد، فاعتقادهم هذا وإن كان سليما في حد ذاته (يهدفون من ورائه إلى تقدم البلاد بالسرعة الملائمة للعصر) فهو اعتقاد سلبي لا يقوم على الاقتناع الصادر عن الدرس الشامل الصحيح والمقارنة النزيهة لأصول التشريع ومبرراته وتطوراته في الشرق والغرب، فهم اقتصروا على ما درسوه من مبادئ القانون ومدوناته في الغرب ولم يولوا عنايتهم لدراسة التشريع الإسلامي الغربي عن ذلك ببعض المعلومات قلدوا فيها هذا المؤلف الغربي أو ذاك واعتنقوا حول الفقه الإسلامي أفكارا لمجرد أنهم وجدوها في كتب الغرب وهكذا أصبحوا مقتنعين ومتشبثين بكل ما قاله الفلاسفة العلمانيون في أوربا عن مبادئ الدولة والقانون ومحشوي الذهن بأخطاء فادحة عن الفقه الإسلامي لمجرد أن هذا النوع من التشريع مستمد من كتاب منزل فهو قانون دولة تيوكراسية (Théocratie) والدولة التيوكراسية في نظر هؤلاء الفلاسفة كمنتسكيو (Montesquieu) وبرودون (Proudhon) أصل السلطة المستبدة والحكم الجائر.
وهنا أريد أن أوجه سؤالين إلى شبابنا المثقف ثقافة عصرية وخاصة منهم من ينتسبون للعائلة القضائية وأرجو أن لا أضايقهم :
أولا – هل أنتم متفقون مع منتسكيو(3) في كل ما قرره ودعا إليه في كتابه (روح القوانين)Esprit des lois وبالأخص هل أنتم موافقون على ما احتوى عليه هذا الكتاب في موضوع الحكومة التيوكراسية؟ أفلا ترون معي أن الفيلسوف الفرنسي يخلط ما بين هذا النوع من الحكومات وبين الدولة الاستبدادية(Etat despotique) بمعناها القانوني وأنه لا يميز ما بين التيوكراسيات العتيقة من هندوس ومازدوية وفرعونية وبين دولة الإسلام؟ فكيف يمكن يا ترى لمنتسكيو أن يعطينا فكرة حقيقية عن الدولة التيوكراسية بمعناها الصحيح في حين أنه يعرفها في عبارات واصطلاحات مبهمة ولا يبصر حتى مميزاتها الرئيسية؟ أفرأيتم إذ كيف أن أحد أقطاب الفكر والفلسفة الغربية أخطأ في تفكيره واحتذى نظرا في توجيه القانون العام لا مانع لنا من مناقشته وانتقاده والابتعاد عن العمل به؟ إنني أتمنى أن تتاح لي الفرصة – أو لكم – لدراسة هذا الموضوع دراسة وافية وطرقه بكل ما يتطلبه من عناية ودقة.
ثانيا – هل لا حاولتم أن تخرجوا قليلا من محيطكم الغربي وتأخذوا أنفسكم بدراسة الفقه الإسلامي وتحليل موقفه إزاء التشريعات العصرية من غير أن تقيسوه بالمقاييس المنحرفة المتسمة بالتعصب الأعمى التي استعملها الأوروبيون في دراستهم؟ إنني لا أطلب منكم المستحيل وإنما أهيب بكم إلى الاتجاه لدراسته ولو دراسة سطحية فتأخذوا مثلا كتاب (القوانين الفقهية) لابن جزي لوضوحه وجودة تبويبه وطريقة ترتيبه التي لا تقل روعة من أساليب التحليل العصرية مع أنه وضع منذ ما يقرب من سبعمائة عام! فسترون كيف أن هذا الفقه الذي يرمونه بالجمود والغموض سيبدو لكم حيا واقعيا منطقيا، يبرر وجوده بكل دقة ووضوح ينسجم في كثير من مبادئه وقواعده مع روح التشريع الحديث ويختلف معها –طبعا – فيما لا يلائم أعراف وطبائع وقيم الأمم المنضوية تحت لوائه، وهذا أمر ضروري وغير خاص بالتشريع الإسلامي وحده دون غيره ما دام لم يتيسر للبشرية جمعاء أن تعيش تحت كنف قانون موحد. فإني لا أخالفكم غير راغبين في دراسة تشريعكم القومي لتكملوا معلوماتكم القانونية والقضائية ولا أشك في أن كتاب (القوانين الفقهية) لابن جزي سيكون خير مساعد لكم على تربية ذوق دراسة التشريع الإسلامي فيكم وينمي رغبتكم في مزيد البحث والاطلاع حتى تتأكدوا مما أشرت إليه أنفا من أن الحكم على الفقه الإسلامي بالملائمة أو عدم الملائمة للحياة العصرية يجب أن لا يظل اعتقادا سلبيا وأن لا بد من أن يكون مبنيا على الاقتناع الصادر عن الدرس الصحيح والمقارنة النزيهة.
فإلقاء نظرة مثلا على الكتاب العاشر في الفرائض والوصايا من (القوانين الفقهية) وجعل مقارنة بين تشريع الميراث عند المالكية وبين نفس التشريع في القانون الفرنسي القديم والقانون الحديث يكفي –على ما أظن – لإعطائكم فكرة واضحة عما ينطوي عليه قانون الميراث في الفقه الإسلامي من نظريات وجيهة وعناصر تتم عن التوازن وبعد النظر، ولعل موضوع تشريع الميراث في الفقه الإسلامي من أخطر المواضيع التي تشغل بال شبابنا وشاباتنا في الوقت الحاضر خصوصا بعد تحرير المرأة في بلادنا ولكل منا رأي خاص حوله فلتكن ملاحظتي هذه حافزا لنا على طرق هذا الموضوع بكيفية أوسع وأدق ولتكن أيضا نقطة يجتمع حولها قضاتنا التقليديون منهم والعصريون ليتبادلوا الأفكار والآراء وليقصروا المسافة التي تفرق بينهم.
وبعد، فما هي الأزمة التي يتخبط فيها القضاء والتشريع ببلادنا؟ إنها ولا ريب مشكلة مسافة بين ثقافتين متباينتين يجب أن يقطعها علماؤنا وقضاتنا وذلك بأن يعمل كل فريق منهم على الخروج من محيطه الضيق ليقترب بالآخر ويضيف إلى علومه الخاصة علوم الفريق الآخر ويعلم كلاهما أن هناك ميادين أخرى للمعرفة ومناهج في البحث يجب أن يحسب لها حسابها، فإذا ما أخذ أولئك وهؤلاء أنفسهم بالانغمار فيها عملوا على تقصير هذه المسافة للتقريب بين الثقافتين وساهموا في المزج بينهما.
أما وزارة العدل فقد أخذت منذ نشأتها على عاتقها تحقيق هذا الغرض باتخاذها عدة تدابير للتقريب بين قضاتها التقليديين والعصريين وإدماج بعضهم في بعض من حيث الاختصاصات والحقوق والواجبات ووسائل العمل والضمانات وقد تهدف الوزارة مقدما وقبل كل شيء من وراء هذا الإدماج إلى توحيد الثقافة عند القضاة ليتأتى لها فيما بعد توحيد المحكمة وتوحيد القوانين فإذا ما تم لها ذلك –وقد قطعت في سبيله شوطا كبيرا بتوحيد المحاكم في الشمال وصدور عدة مدونات ولا سيما بصدور قانون إطار القضاة – تكون قد أدركت الغاية الحقيقية من وحدة القضاء في المغرب.
وإذن فما دامت سياسة وزارة العدل في ميدان إصلاح القضاء وتوحيده متجهة إلى جعل القانون العام الذي تحكم به المحاكم في المغرب مستمدا في روحه من التشريع الإسلامي وما دام من الضروري من جهة أخرى أن تعمل الوزارة باستمرار على تطور قضائنا باقتباس ما كان صالحا له من أنظمة الغرب مما لا يتنافى مع روح الشريعة الإسلامية الطاهرة وقيمنا القومية، فقد لا يكون بد لقضاتنا الذين أصبحوا ينتمون لسلك واحد ويتمتعون بنفس الحقوق وتجري عليهم نفس الواجبات من أن يعملوا بجد على إعادة النظر في معلوماتهم وتقويم مؤهلاتهم الثقافية والمهنية لجعلها تامة وكفيلة بالاضطلاع بالرسالة السامية التي أنيط بهم أداؤها لصالح مجتمعهم فقد يتحتم عليهم يوم أن يتم إدماج ما يسمى الآن بالقضاء الشرعي والعادي والعصري في قضاء قومي موحد أن يلموا بأطراف القانون المعمول به في البلاد وأن لا يبقى هناك حاجز يعترض سبيلهم من أجل التصرف في مهمتهم بكل ما يتطلبه الحال من تبصر وإحاطة بفروع التشريع لحل المعضلات المعروضة عليهم.
نعم، قد نقول بأن تحقيق ذلك وقف على وزارة العدل التي ينبغي لها أن تزود قضاتها بوسائل العمل الكفيلة بتوحيد الميدان القضائي من جميع وجوهه فتبادر بإنشاء كلية للقضاء على غرار ما يوجد في البلاد الغربية وبتوحيد المحاكم وضم شتات التشريع في مدونات تكون أداة صالحة يستقي منها القضاة مادة القانون ويستنيرون بها في إصدار أحكامهم. إلا أن هذا وإن كان من شأنه أن يساعد على انطلاق القضاة واندماج بعضهم في بعض من الناحية المهنية فإنه لا يكون جديرا وحده بتحقيق الوحدة الثقافية عندهم ولا يكفي وحده لإعطاء القضاء المغربي كل ما هو في حاجة إليه من فعالية وعظمة وأريحية فسيبقى علينا من قبل ومن بعد أن نعمل بجد سواء في الكلية أو في المحكمة على تهذيب عقليتنا كمثقفين وإعادة النظر في معتقداتنا في ميدان القضاء والتشريع وذلك بتوسيع دائرة معارفنا واتجاه كل منا إلى التقريب بين معلوماته ومعلومات الآخر والانغمار معه في محيطه حتى يمتزج به وإذ ذاك يكون من الممكن لنا أن نحقق وحدة ثقافتنا القضائية.
فهل ينبغي التذكير بأن هذا الاتجاه لم يرح بعد الاستقلال من مستحبات وكماليات الثقافة بل أصبح فرضا من فروض الاستقلال وواجبا محتما على جميع القضاة سواء منهم المنتمون للقضاء الجالس أو للنيابة العمومية خصوصا وأن توحيد المحكمة الذي سيتم في القريب سيفرض عليهم التوفر على ثقافة قضائية عامة والقدرة على تطبيق المدونات القانونية من دون ما تمييز بين أجزاء التشريع العام الذي تحكم به المحاكم في المغرب، وبذلك فقط سيكونون جديرين بحمل صفة (قاضي) التي خولهم إياها صاحب الجلالة نصره الله.
(1) راجع في هذا الموضوع ما كتبه حماد العراقي في مجلة القضاء والقانون صحيفة 531.
(2) الأستاذ حماد العراقي: مجلة القضاء والقانون عدد 17 صحيفة 536.
(3) انظر (روح القوانين) لمنتسكيو – الباب الخامس من الكتاب الثاني والباب التاسع من الكتاب الثالث والباب الرابع عشر من الكتاب الخامس.
