الثقافة الإسلامية في عالمٍ متغيّرٍ
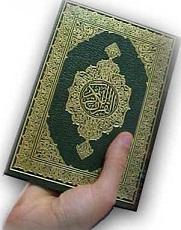
السيد محمد حسين فضل الله(قده)
الحديث عن الثقافة الإسلامية والقيم الإسلامية في عالم متغيِّر، يرتسم أمامنا كسؤالٍ كبيرٍ، سواء على مستوى التصوّر، أو على مستوى حجم الواقع وسعته.فالإنسان الذي يلتزم فكراً ما ويواجه واقعاً ما، يكون الفكر هو الذي يصنعه، وتكون القوّة هي التي تحرّكه، وتبقى جدليّة الأصالة والمُعاصرة تتمحور حول سؤال: كيف تبقى أنت ببقاء فكرك؟ وكيف تحافظ على ذاتيّة الأصالة في المفاهيم والخطط؟ وكيف تعيش مع عصرك فلا تكون غريباً، لتدخل في كهوف عصورٍ سابقةٍ؟ مشكلة الكثيرين ممّن سبقونا أنَّهم أهملوا هذا السّؤال، ومشكلة الكثيرين من النّاس عندما لا يجدون في شخصيّاتهم معنى التجدّد والانفتاح على الهواء الطلق والصحو المبدع، أنَّهم يهربون من كلّ ما يُمكن أن يخرجهم من الزوايا التي اعتادوا عليها.وهذا ليس اتّهاماً لبعض الماضي، لكنَّه دراسة لشيءٍ من حركة الواقع في داخلنا.
لا نحمل عقدة القديم أو الجديد:
الفكرة التي نحملها بشكلٍ تلقائيٍّ، هي أنَّ الدين ثابتٌ في نصّه ومضمونه وشكله، حتى تكاد حركته تحمل شيئاً من الثبات، ما يجعل بعض النّاس يتصوّرون بأنَّه انطلق ليبقى في مكانه، وليُشير إلى الآخرين الذين يتحرّكون، كما لو أنَّه شرطي سير يومئ للجميع بالتقدّم، ويبقى هو واقفاً في مكانه. لذلك فإنَّ الكثيرين من النّاس الذين يحملون هذا التفكير، يقفون أمام كلّ جديدٍ، ويمتنعون عن التفكير في الصواب أو الخطأ الكامن فيه، بحيث يشكّل الجديد عقدةً لديهم، وليس منطلق فكرٍ وحوارٍ، وهو ما يترك أثره على الواقع الثقافيّ لدى الكثيرين من المسلمين، فيكفّون عن قراءة الجديد ومواجهته، لأنَّه يمثّل في نظرهم كفراً وزندقةً وضلالاً، ذلك أنّهم لم يدرسوه من داخله ليتحقّقوا من هذه المعاني، ويعرفوا هل هذا التصور حقيقة أم مجرّد اتهام؟
إنّ ارتباطنا بالإسلام لا يحمّلنا عقدة الماضي، بحيث نستغرق فيه ونبقى في كهوفه ومغاوره، أو حتّى في ساحاته الواسعة، ولا يُسبّب لنا عقدة التجدّد، كما هو حال البعض في تعامله مع دور الأزياء، التي تُريد للرّجل والمرأة دائماً التجديد مع احتمال كونه منافياً للذوق، ولا نريد أن نعيش عقدة الجديد التي تقف أمام عقدة القديم، بقدر ما نعيش المسألة ميدانيّاً، وبحسب طبيعتها.
إنّ الإسلام فكرٌ انطلق من خلال عنصرٍ مقدّسٍ، والمقدّس فيه هو الله، والرسول يستمدّ قداسته من أنَّه ينطلق بوحي الله، ولكنَّ هذا المقدَّس أراد للإنسان أن يفكّر، فالله سبحانه لم يخلق الإنسان حيواناً أو شيئاً يخضع لذهنية معينة يمكن أن تحدده من الولادة حتى الوفاة في حجمٍ معيّن، لا يكبر ولا يصغر، بل لقد خلقه إنساناً يفكّر وميّزه بهذا الفكر عن بقيّة المخلوقات، فالإنسان حيوانٌ عاقل، والحيوانيّة الحيويّة تضجّ في كلّ كيانه، ولكنَّ العقل هو الذي ينظّم هذه الحيويّة الحيوانيّة الإنسانيّة، لذلك قال الله للإنسان عليك بالتفكير:{وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ}[آل عمران/191]، وعن أبي عبد الله(ع)قال:"تفكر ساعة خيرٌ من عبادة سنة"، فأنْ تُفكّر معناه أن تكتشف ذاتك، لأنّ الكثيرين منّا يتحرّكون تلقائيّاً ليكونوا صدى لذات الآخرين الذين يُفكّرون.
لنتحمَّل صدمات الفكر
فالإسلام يُريد للذات الإنسانيّة أن تكون مسؤولةً، لتصنع نفسها بالفكر، فليس مقبولاً من الإنسان أن يكون فكره فكر الآخرين، بل المطلوب أن يكون له فكره، الذي ربّما يلتقي بفكر الآخرين. فالإسلام لا يمنع من اللقاء بالآخرين، بل يحثّ على ذلك، حتّى يلتقي الوجود العقليّ للإنسان مع الوجود العقليّ للآخر، ليتكامل معه في صنع الفكر، ولذلك كانت مسؤولية الإنسان مسؤوليةً فرديةً في الفكر والعمل، حتى في حال العيش داخل المجتمع، قال تعالى:{وَكُلُّهُمْ آَتِيهِ يَوْمَ القِيَامَةِ فَرْدًا}[مريم/95]، وقال تعالى:{يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ نَفْسِهَا}(النحل/111)، فالنفس تجادل عن فكرها وعواطفها ومشاعرها ومواقفها وعن كلّ ما يُحيط بها.فالله أراد للإنسان أن يُفكّر وأنْ يتحمّل مسؤوليّته من خلال فكره، وأكّد له أنَّ الفكر هو الذي يُعطي الواقع معناه وحركيّته، وليس العامل الاقتصاديّ والجنسيّ والاجتماعيّ وحده، فالإنسان بكلّه هو الذي يُغيّر الحياة، وأنت تُغيّر الحياة من خلال ما تختاره من فكرٍ لها، قال تعالى:{إنَّ اللهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ}[الرعد/11]، فبقدر ما تغيّر نفسك يتغيّر الواقع، وبقدر ما تغيّر فكرك يتغيّر التاريخ.
من هنا يمكننا القول، إنَّ الفكر أوّلاً والحياة تتحرّك في خطّه، وإنّ علينا أن نفكّر حتّى لو أظهر هذا التفكير بؤس ما نحن عليه، وحتّى لو أوصلنا إلى أنْ نعرف أنَّ بعض أفكارنا التي عشناها كانت خطأً، وحتّى لو فجعنا بتخلّف آبائنا الذين فكّروا قبلنا، لأنَّهم لم يملكوا مفردات الفكر.
النّص واحتمالات المعنى:
في الأصل والأصالة، الكتاب والسنة هما الخط والأفق والعمق بالمعنى المقدس، ولكنَّ كلام الكتاب والسنة عربيٌ، وللكلام العربي قواعده فيما يفهمه النّاس منه، ولذلك فالنّص بكلماته هو الثابت، ولكنَّ معنى النص بمفهومه هو المتحرّك؛ متحركٌ من خلال أنّ حيويّة اللغة العربيّة في كلّ قواعد المجاز والكناية والاستعارة، تجعل الإنسان يفهم النّص في أكثر من احتمالٍ؛ فالنّص في داخله مملوءٌ بالحيويّة، كما هو مضمون الكلام العربيّ مملوءٌ بالحيويّة، ونحن هنا لا نتحدّث فقط عن الكتاب والسنة لوجود حساسيّة القداسة فيهما، ونحن قومٌ تثقلنا حساسيّاتنا وتدمّرنا. ففي الواقع، ثمة أكثر من فهمٍ لأدباء العرب وشعراء المعلّقات، فهل يلتقي الناقدون القارئون على فهمٍ واحدٍ لامرئ القيس، أو للمتنبّي أو المعرّي أو لكلّ هذا التراث؟
فالكلمة منذ بدأت في وجدان الإنسان، تبدأ تاريخها وتنطلق لتحمل كلّ إيحاءات أفكار الذين استعملوها، إن كان هناك واضعٌ، فليس الواضع هو الذي يُحدّد معنى الكلمة، فهو يُطلق الكلمة، لكنَّ الكلمة حين يستخدمها الإنسان، تأخذ من مشاعره وأحاسيسه وآفاقه وطريقته في تصوّر معناها، ما يجعل الكلمة محمّلةً بكلّ تاريخ استعمالاتها في إطار اللغة العربية.لذلك علينا أنْ لا نعود إلى القاموس لنفهم كلماتنا، ولكن علينا أن ننفتح على كلّ هذه الثقافة التي عاشتها الكلمة، وعندها سوف نجدها محمّلةً بالكثير ممّا فكّر فيه المفكّرون ولم يتحدّثوا به، وبالكثير ممّا استلهمه الشّعراء وأنتجوه شعراً.ونحن نعلم ما تتّسم به اللغة العربية من مرونة، لجهة وجود الكلمات المترادفة، مثل كلمة: بشرٍ وإنسانٍ، لكن لماذا لا تُستعمل مفردة البشر إلّا في مقابل مفردة الملك، ولا يستعمل الإنس إلّا في مقابل الجنّ، ولو استعمل هذا مكان ذاك لكان خطأً، والمعنى واحد؟! إذاً للكلمة ظروفها وإيحاءاتها التي تتحرّك فيها.
نعم، النّص ثابتٌ في الكتاب والسنّة، ولكنَّ المعنى متحرّكٌ، الأمر الذي يُتيح لنا الاجتهاد في فهم الكتاب والسنة.ونحن هنا لا نتحدّث عن الاجتهاد المزاجيّ، الذي يُمارسه بعض النّاس، لأنَّ الواقع يفرض تقديم الفتاوى، ما يدفع إلى تفسير كلّ شيء، حتّى الغيب، بالمفردات الماديّة، لأنَّ عقدة الغرب تستحكم بهم، لذلك توقف هؤلاء مثلاً عند كلمة ذرّة في القرآن ليُثيروا أبحاث الذرة، وعمدوا عند كلّ كلمة يُمكن أن توحي بمفردةٍ علميّةٍ وما إلى ذلك، إلى إخضاع القرآن لاكتشافاتٍ حديثةٍ، ونحن نعرف أنَّ الاكتشافات لا تمثّل الحقائق، ولكنَّها تمثّل النّظريات، التي تتغير بين وقتٍ وآخر، ما أوقعهم في كثيرٍ من الإرباكات، وهذا الأمر يعود أوّلاً وأخيراً إلى عدم فهمهم.
الحوار الإسلامي ومفهوم الغلبة
ولعلّ قيمة الثقافة الإسلامية فيما حدّده الكتاب والسنّة في الأصل، وانطلق به المفكّرون المسلمون في حركة التاريخ، أنَّها ثقافة حواريّة.
ففي البداية، حاور الله إبليس وحاور الملائكة، وحاور إبليس آدم، وحاور هابيل أخاه قابيل، فليس هنالك سماتٌ محدّدةٌ في المحاور، فعندما يُحاور الله إبليس، فمعنى ذلك أنّه ليس هناك أيّ خطٍّ أحمر يعترضنا لمحاورة أيّ طرف.إلّا أنَّه يفترض الالتفات إلى بعض العناوين الأساسيّة التي يُمكن أن تفرض عليك ضوابطها في هذا المجال.قال تعالى:{وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ} (العنكبوت/46)، فإنَّ الظالم ليس محاوراً، لأنَّه يفرض عليك فكره من موقع ظلمه على أساس القوّة التي يملكها، كذلك فإنّ الظالم أو المستكبر لا يعيش في ذاته معنى الحوار، لأنّه بظلمه واستكباره يفقد أوّل شرطٍ للحوار.
إنّ المنهج القرآنيّ يدعونا إلى الحوار مع كلّ النّاس، لأنَّ مسألة الحوار تمثّل رحلة الإنسان مع أخيه الإنسان في البحث عن الحقيقة؛ وأؤكّد هنا، أنَّه لم يستطع أيُّ منهجٍ الاقتراب من الأسلوب الإسلاميّ في الحوار، فضلاً من التقدّم عليه.ففي كلّ حوارٍ هناك الذات والفكرة، ونسبة الصواب والخطأ المئويّة، وهناك الأنا في تمثّل الفكر، وهذه الأنا قد تُحاور الآخر، ولكن على أساس أن يكون على الهامش، ولا يكون معك، أمّا الحوار في الإسلام، فإنَّ الذات تغيب، وتكون على قدم المساواة مع غيرها في البحث عن الحقيقة، قال تعالى:{وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ}(سبأ/24)، وهذا كلام الصادق الأمين الذي عاش الصدق كلّه في معنى وحي الله، وعاش الإيمان كلّه بهذا الوحي والرسالة، ولكنَّه في حركة الحوار ـ المنهج يقول للآخر:قد أكون أنا على ضلالٍ أو على هدى، وكذلك أنت، ولقد استخدم كلمة:"الضلال"ولم يستخدم كلمة "الخطأ"، واستخدم كلمة: "الهدى"، ولم يستخدم كلمة: "الصواب"، لأنَّه يُريد دفع القضية بكلّ قوّةٍ. وهذا هو الأسلوب الذي ليس له مماثل، فرسالة الحوار الذي يدعو إليه الإسلام ليست في أن يغلب أحد الطرفين الآخر، ولكن أنْ يتعاون مع الآخر في اكتشاف الحقيقة، وتلك هي الروح التي غيَّبها المسلمون عندما انطلقوا وفق مفهوم الغلبة، ولو تحت عنوان غلبة الحقّ للباطل.
لا يمكن أن يُصادر منهجنا زمنٌ:
إنَّ مراعاة الرؤية الإسلامية للحوار، تدفعك إلى أن تصبر، فقد تجتاح فكر الآخر بالفكر من دون اجتياحه بالعنف والزندقة والتكذيب والتضليل، فحاول أن تجتاح روحه بروحك، وقناعته بقناعتك؛ ذلك هو معنى الثقافة الإسلامية، إنّها الثقافة الحواريّة، والقرآن هو كتاب الحوار، وحركة حوارية في مدى الرسالات، والحوار هو أساس كلّ حركات الصّراع؛ ولذلك عندما انطلق النبي(ص)، حاور الكافرين والمشركين والمسلمين، لأنَّ الحوار يعني احترام الإنسان الإنسان الآخر، واحترام أفكاره ومقولاته، وإن لم تكن محترمةً في ذاتها.
لهذا نحن نتصوّر أنَّ الثقافة الإسلاميّة الحواريّة لا يُمكن أن يُصادرها عصرٌ، ولا يُمكن أن تُبعدها عن الساحة أيّة متغيّرات، لأنَّ الثقافة التي تدعو الآخر إلى الاشتراك في مهمة البحث عن الحقيقة، هي ثقافة تتجاوز الزّمن. فأيُّ نمطٍ ثقافيٍّ يُمكن له أن يهزم مثل هذا المنهج؟ ! .
موقعنا في العصر!
ربَّما يستبعد الإنسان ما هو غريبٌ في الفكر، وقد لا يألف الحقيقة؛ لذلك علينا الانطلاق من خلال المنهج للدخول في العصر؛ بأنْ نفهم عصرنا، ونعيش ذهنية العصر وذوقه وتطلّعاته وآفاقه، لأنَّ الذهنية لغةٌ، وإذا لم تفهم ذهنيّة الآخر، فكيف يُمكن لك أنْ تُخاطبه أو يُخاطبك؛ لذلك لا بُدَّ من التحديق بعصرنا بكلّ سيئاته وانحرافاته، وأن نختار موقعنا في عصرنا، وأن نعمل ونجرّب في أيّ ساحةٍ يُمكن لنا فيها أنْ تواجه ثقافتنا الثقافات الأخرى.
إن مشكلتنا تتمثل في أنَّ كلّ واحدٍ منّا يُحاور نفسه، وهو يرسم الخطّ الفكريّ للحوار بما لديه، ولا يُحاور الآخر، ولا يُحاول أن يفهم الخطّ الفكريّ للآخر، وفي الحديث:"إنّا معاشر الأنبياء أمرنا أن نكلّم النّاس على قدر عقولهم"، وهذا يعني أنَّ على الإنسان أن يفهم حجم عقل الآخر في عمقه وسعته، ثمَّ يطلق الكلمة التي تخترق هذا العقل أو هذا القلب والروح. وضمن هذا الفهم، لا بُدَّ من أن تنـزل الكلمة إلى الشّارع، وأن ترتفع الكلمات إلى المواقع الثقافية.
الحقائق في الثقافة لا تموت
وفي عالمنا المتغيّر، لا تزال الثقافة الإسلامية تملك أكثر من فرصةٍ لتواجه أكثر من ثقافةٍ أخرى، وقد تكون مشكلتنا، والبعض يتحدّث عن ثقافة عصر، تماماً كما لو كان للعصر عقلٌ يفكّر بثقافةٍ معيّنةٍ، فالزّمان هو الزّمان، ولكن كلّ ثقافة تنطلق من خلال الخطّ الثقافيّ الذي يتحرّك في عقل فلانٍ وفلانٍ، وقد تغلب ثقافة ثقافةً أخرى، لا لأنَّ الثقافة المغلوبة تفتقد الصفة الحضاريّة التي تمنحها إمكانيّة البقاء، ولكن لأنَّ هناك قوةً غاشمةً مستكبرة تنتمي إلى ثقافةٍ معيّنةٍ فتفرضها.
وفي هذا المجال، نتساءل:هل دخلت الثقافة الغربية إلى بلادنا الإسلامية من خلال الاختيار الحرّ والمواجهة الحواريّة، أو أنَّها دخلت لأنَّ الغرب أطبق بكلّ قوته علينا، ففرض علينا ثقافته من دون أن نختارها؟ قد يكون في هذه الثقافات أشياءٌ جيّدة نلمسها في وسائل التربية ومناهج التعليم وحركة الإدارة، وفي كلّ هذه المواقع التي ربَّما لم تملأها الثقافة الإسلامية، ولكنَّنا لم نأخذها باختيارنا، بل فرضت علينا بالقوة. وهنا قد نقع في خطأ، حين نعتبر أنّ كلّ فكر الماضي مرحلة ماتت، ومات كلّ ما فيها، وأنّ الصواب هو الاستغراق في الأفكار المطروحة راهناً، والتمسّك الدائم بها.فنحن نعرف أنَّ هناك من الأفكار ما يولد مع الزّمن ليأخذ كلّ خصائصه، وهناك من الأفكار ما يحتوي الزّمن من دون أن يأخذ خصوصيّةً فيه؛ فالحقائق في الثقافة ولدت في الماضي، ولكنَّها حقائق الحياة، وليس لها عمرٌ ماضٍ أو حاضر أو مستقبل، فهناك أفكار وعقائد أخذت عناصرها من خلال الظروف الموضوعيّة الخاصّة، فهذه قد تموت بموت الماضي، وقد يبقى منها شيءٌ، ونحن نعرف أنَّ القرآن الكريم لم يُهمل الماضي، ولكن جعل منه مدرسةً، قال تعالى:{لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الأَلْبَاب}(يوسف/111)، فالله أراد لنا أن نفهم الماضي، وأن نأخذ منه دون أن نتحمّل مسؤوليّته، لأنّ مسؤوليّتنا هي في صنع الحاضر والمستقبل، قال تعالى:{تلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ}(البقرة/134). أمّا القيم الإسلاميّة، فنحن مسؤولون عن حملها، لأنَّها تمثّل كلّ حركة الإسلام الأخلاقيّة والروحيّة التي توجه السّلوك الإنسانيّ.
الحق بين العدل والحريّة
والقيم الإسلامية التي نطل عليها تجمعها قيمةٌ واحدةٌ هي العدل، ولذلك جعله الله أساس الرسالات، قال تعالى:{لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الكِتَابَ وَالمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالقِسْطِ}(الحديد/25)، فالقيام بالقسط هو القيمة التي انطلقت منها كلّ الرسالات، وعندما ننفتح على العدل، نراه ينطلق من فكرةٍ بسيطةٍ جداً، وهي أنْ تُعطي لكلّ ذي حقّ حقّه، ولذا نحن نفهم أنَّ هناك عدلاً مع النّفس، وأنّ هناك ظلماً للنفس، فمن حقّ نفسك عليك أن تجلب لها كلّ ما ينفعها، وأن تبعد عنها كلّ ما يُضرّها.
وقد حدثنا الله عن الظالمين أنفسهم، قال تعالى:{وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ} (النحل/118)، وقال تعالى:{إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ المَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ}(النساء/97) الذين ظلموا أنفسهم بالكفر والضلال على أساس خضوعهم لأصحاب القوة، بحجّة أنّهم كانوا مستضعفين في الأرض.ولكنّ الله يقول لك إنّ الاستضعاف ليس مبرّراً لك للخضوع والانحراف ما دامت لك فرصة الهجرة إلى بلد آخر لكي تأخذ القوة، ثمّ ترجع لتصنع قوتك من الداخل.
العدل يرسم حدود الحرية:
في ضوء هذه الأفكار، نقول إنّ الإسلام ربَّما يختلف عن الاتّجاهات الأخرى، في أنَّه لا يُريد للإنسان أن يحمي الآخر من نفسه أو يحمي نفسه من الآخر فحسب، بل، وكما جاء في دعاء للإمام زين العابدين:"اللهم فكما كرهتني أن أُظلَم فقِني أن لا أظلِم"...لقد أراد الله للإنسان أن يحمي نفسه من نفسه. صحيحٌ أنّ للإنسان إرادته، ولكنّ الله لم يعطِ الإنسان حريّة التصرّف بهذه النفس وفقاً لأهوائه، لأنّ نفسه هي ملك الله، وليس له أن يتصرّف بملك الله بما لا يريده، فليس من حرية الإنسان الانتحار مثلاً، لأنّ في ذلك إضراراً للنفس، فالحرية لا تنطلق وفق مزاج الفرد.
إنَّ حدود حرية الإنسان هي ما يحفظ حياته وحياة الآخرين، وحركة الحرية تحددها ضوابط العدل والحقّ، ومن بينها "حقّ جسدك وعقلك عليك"، كما في الحديث.فليس الآخر هو فقط من تحدق به عيوننا، ولكنَّه أيضاً من الذي نعيشه في داخل وجودنا، لأنَّ مسألة الحياة لا تتجزأ، فكما لا يجوز لنا أن نُسقط حياة الآخر، لا يجوز لنا أن نسقط ما يتعلق بحياتنا.
وهنا نستطيع أن نعتبر أنَّ كلّ القيم الإسلامية تجتمع في قيمة العدل، والعدل ساحةٌ واسعة يمكن أن تنطلق في عالم متغيّر أو عالم ثابت، وربَّما اختلف الإسلام مع التيارات الأخرى التي فرضت التغيير على الواقع في مفهوم الحقّ، لأنَّ الحقّ عدلٌ، وهذا ما يدفعنا إلى الدخول مع هذا العالم المتغيّر في حوار حول تحديد ما هو الحقّ لنحدد ما هو العدل أو الظلم، وكذلك أن نتحاور حول القيم والكثير من المفردات على ضوء هذا المنهج.
قيمنا ليست تجريديّة:
من جهة ثانية، نحن نرى أنَّ القيم في الإسلام ليست شيئاً تجريديّاً خارج الإنسان، وليست قيمنا هي قيم الدار الآخرة وإن كانت تنفتح عليها، قال تعالى:{وَابْتَغِ فِيمَا آَتَاكَ اللهُ الدَّارَ الآَخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا}(القصص/77)، لكنَّها القيم التي جاء بها الإسلام من أجل مصلحة الإنسان. ولذلك فالقيم في الإسلام ثابتةٌ في العنوان، ولكنَّها متحركة في الواقع.
وخلاصة الكلمة، هي أنَّ العالم المتغيّر قد انطلق في تغيّره في مواقع ومساحات ليست بينها وبين الإسلام أيّة مشكلة، سواء في العلم وفي أساليب التربية والتكنولوجيا، أو في القضايا التنظيمية، أو في وسائل الاتصال والمعلوماتية وغير ذلك.
أما المشكلة، فتتصل بالموقف من الرؤى الفكرية حول الكون والحياة والإنسان والمجتمع، فهذه قد تشكّل مواضيع للصّراع، ما يتطلّب منّا أن نعرف كيف ندخل ساحة الصّراع وكيف نخترقها، وكيف نمنع الآخرين من أن يمنعونا من الدخول إلى السّاحة لننطلق مع الإنسان كلّه.
