أثر الاجتهاد في استمرار الحضارة الإسلامية
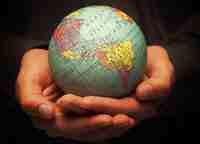
إذا كان دين الإسلام قد خطا بالناس خطوات واسعة في سبيل تحقيق حياة اجتماعية، وفي سبيل تثبيت دعائم الأخوة الإنسانية، وفي اطراد نمو هذه الحياة واستقرارها عن طريق صلتها بالدين وعن طريق إلهاماته إلهاب شعور الناس وتفاعلهم معه، فإنه لم يكن ليستقر ذلك في أعماق الناس، ويبلغ منهم مرتبة الإيمان، ويسكن في مساكنه من سريرتهم وتشوقاتهم ـ إلا عن طريق تحرر الفكرة الإنسانية، وخصوبة مقاييسها الصحيحة التي تتلاءم مع الدين ومع العلم ومع الامتدادات الحضارية الأخرى، وتجتمع معها في صعيد واحد.
ولئن اعترضت المواكب البشرية الرائعة ـ في طريقها إلى الخير العام وفي اتجاهها إلى سلام دائم ـ ضروب من التقلبات، وألوان من المفاجئات بكثير من المخاطر والصراعات المتصلة الضرام، فإن لها أداة قوية ذاتية نابعة من نفسها تتمثل في (التفكير الحر) الذي كافحت به الطبيعة وسخرته لفائدة المجموعة البشرية، ومحت به أوزار الأوضاع، ونسقت به جهود المجتمع.
تلك حقيقة لا جدال فيها مهما كانت الأخطاء التي ارتكبتها الحضارة ومهما بلغت تصرفاتها من عنف وقسوة، ومهما كانت الوسائل التي استخدمتها للسيطرة على الشعوب والتسلط عليها.
والفكرة الإسلامية هي ـ في جوهرها وفي عرضها ـ فكرة إنسانية متحررة من قيود الزمان والمكان تملك من وسائل الوصل بين مطالب الحياة ومفاهيم الإنسانية المنحذرة عن البيئات والأوضاع المختلفة، في ظل الاتزان والشمول، وفي ظل التوفيق والتصفية بين متناقضات الحياة، ما قطعت به أشواطا في سبيل ازدهار الحياة الإنسانية، وفوق هذا فيها العروض السخية لتوفير راحة الناس وتحريرهم من الأسر النفسي والاجتماعي.
تحررت العقلية الإسلامية من رق الوثنية، وتحررت من أسر الوهم والخوف والكهانة المحترفة، وعبادة غير الله تعالى التي كانت مفروضة على الناس بحكم عادات موروثة، فانفتحت أمامها الدنيا على صورتها الواضحة، وتغيرت حياتها الاجتماعية والدينية والنفسية، وتغيرت إحساساتها ونظرتها إلى هذا الكون.
وكان هذا التغير وهذا الانقلاب جديرا بأن يؤدي إلى انقلاب عام في أساس الحياة الاجتماعية، وإلى تطور مستمر يقتات من جميع العصور والأدوار ويمتص من جميع جذور الحياة متى ما صادف من عقول الناس استجابة لهذا التجاوب الإنساني الأصيل وإيلافا لهذا الدفء الإنساني.
وقد كان تقويم المسلمين الأولين من سلف هذه الأمة ـ لهذا المجهود العقلي تقويمه الصحيح وتكيفهم مع مقتضيات التشريع الإسلامي، ومع أصوله العامة، وتزودهم منها بمقدار بالغ خير تراث لهم ولمن بعدهم من الأجيال المتعاقبة، وخير طريقة لبناء حضارة إسلامية خالدة.
كان من العسير عليهم أن يوفقوا بين تقاليد وأوضاع البلاد التي استظلت بلواء الإسلام ـ وخاصة بعد ما تلاحقت الفتوحات الإسلامية ـ وبين النظم الإسلامية لولا ارتفاع هذا الحجر الفكري، وقدرتهم على التصرفات الدقيقة بعقول واعية بوحي من أهداف الإسلام الكبرى ـ الذي مهد السبيل لضروب الالتقاء في ميادين واسعة، ومهد للناس أيضا الاجتماع على كلمة سواء لا فروق فيها ولا طبقات ولا رسوم ولا أقاليم.
كان ربح المسلمين من ذلك عظيما، وكسبهم كان كبيرا مد لهم في سياسة الشعوب ذات التقاليد والأوضاع المختلفة، وعصم الحياة الاجتماعية ـ بصفة عامة من التدهور والفراغ والتخلي، فأبقى على الروح الإسلامية سلطانها وأثرها في النفوس وأثرها في الحياة، وأبقى عليها أيضا أصالتها في الاضطلاع في التوفيق بين ظروف وقطاعات ومفاهيم وأذواق مختلفة.
وإن يكن الإسلام يعتمد في إقناع الناس بصواب منهجه وبعموم معروفه ونفعه على مبادئه وتعاليمه، فإنه يعتمد كذلك ـ بالقصد الأول ـ على حسن فهم هذه المبادئ وعلى حسن عرضها ودقة تطبيقها على صور الحياة القائمة وعلى العقل البشري المتجرد الذي لا تختفي عنه حريته وإرادته.
ويجب الاعتبار بأن كل ما حدث في العالم الإسلامي من فجوات، وما لحقه من نكبات كانت نتيجة لتحوله عن هذه الفكرة، وجفافه عن الاستجابة النابعة من التشريع الإسلامي لمطالب الحياة، وقد كان هذا وحده كافيا في أن يجر وراءه ظلالا كثيفة من الريبة واللبس والعقد المستعصية في حياة المسلمين، فيها تخلف مستوياتهم وفيها ـ بالتالي ـ عكس لمعطيات هذا الدين وتحريف لوثائقه ومقرراته عن مناهجه الواضحة في تحرير البشرية أفرادا وجماعات من التسلط والاستغلال.
إن في فساد الذهنية كل الآثار السيئة التي تهدم كيان الفرد والمجتمع، وتخدم ألوان التخلف والتفاهة وتسيء إلى ارتباط المسلمين بدينهم وبمجتمعهم وبالناس جميعا، وتغذي تلك المفارقات الإسلامية وملاحقة أعداء النهوض الإسلامي.
والإسلام الذي كان جهادا من أول يوم ـ ضد النفس المسترخية وضد الأوهام وضد الأثرة والاحتكار كان أيضا جهادا ضد الاجترار الفكري وضد التبعية المفروضة.
ويجب التذكير بأن الدعوة لتحكيم الرأي وتقديس الاجتهاد وتسويده على النقل والمتابعة ليس أمرا جديدا في الإسلام ولا أمرا اقتضته الأحوال أثناء اصطدامه في سيره بعقبات، ويكاد يكون الإسلام ـ كما قال الفيلسوف الفرنسي « كيزو » : (منفردا بين الأديان بتقريع المعتقدين بلا دليل، وتوبيخ المتبعين للظنون، وتبكيت الذين يتخبطون في ظلام العماية، هذا الدين يطالب المتدينين بأن يأخذوا بالبرهان من أصول دينهم، وبأن السعادة من نتائج العقل والبصيرة، وبأن الشقاء من لواحق الغفلة وانطفاء نور البصيرة). وجدير بنا أن نعرف الحدود التي تخطاها الفكر الإسلامي أيام روعته ـ لنستطيع أن نجد التفسيرات الواضحة لسخافة المسلمين وتأخرهم إلى المصاف الخلفية زمن انتكاسهم وذلتهم، ولنجعل من وحدة الشعور الإنساني ووحدة أهداف الحياة الإنسانية العليا مادة واحدة على طريقة اعتبار الإنسانية شخصا واحدا من ناحية المعرفة ـ على نظرية « باسكال » وإضرابه.
وعلى كل حال كانت نظرة الإسلام إلى الالتجاء إلى البرهان، والتقوى بالاجتهاد، والأخذ بالدليل نظرة بعيدة المدى يخلق منها تكاملا عضويا ومدا قويا ووقاية طبيعية ضد قوى التخلف والرخاوة والانحلال.
لذلك كان أول ما يسند بأبطال الإصلاح الإسلامي ـ في كل زمن ـ بعد ما أحسوا إحساسا متزايدا بالحاجة إلى تلافي انحدار الذهنية الإسلامية ورفع مستواها وتلقيحا بلقاح قوي من المرونة والاستقلال في الفهم وفي التصرف المسارعة إلى مكافحة هذا الفساد ومحو أوزاره، وتتبع آثاره، ولهم ما يبرز موقفهم في هذا، فقد رأوا كيف انتهى الحال بالحرص على فساد العقلية الإسلامية تحت تأثير الدس والإيقاع والتحديات الزمنية، وترويج الشكوك والمفتريات إلى خلق مستويات فكرية ضحلة هي أتفه من التافه.
فقد تمثل لك فكرة الجبرية، والقضاء والقدر، والكسب والتوكل بمفاهيمها العكسية المقلوبة، وشطحات الصوفية ومواجيدهم، ونشاط الباطنية حتى في عصرنا هذا ـ وتهالكها على خذلان الدول الإسلامية وعكوف العلماء على أساليبهم المريضة في الدرس والبحث والتحصيل ومناصرتهم للمذهبية الجامدة وإعلانهم لغلق باب الاجتهاد الذي كان له بعض التوجيهات المقبولة عقب تآلب الترتر والمغول على الدول الإسلامية والقضاء على مقدساتها، فأرادوا بذلك قطع الطريق على اندساس المندسين وعبث العابتين تحت ستار حرية الفكر، ولكن الأمر استحال إلى توظيفه في قطاعات أخرى ظهر للعيان زيفها وغرضها وبطلانها.
ولا داعي إلى التدليل على ما قاساه هؤلاء المصلحون من عنت وعلى شدة صراوة الناس بخصومتهم وعلى فتح واجهات شتى للضرب على أيديهم، والنيل منهم والتعجيل بهزيمتهم.
وفي استطاعة الباحث أن يعزو انتشار التقليد ورواج المذهبية المتعصبة إلى عاملين أساسيين: ردود الفعل والتحديات الزمنية ممن يريدون إفساد الإسلام والتخليط عن أهله. والتلويح لهم بالشعارات ليسهل عليهم اقتناصهم حتى لا يجدوا في الأرض مقعدا ولا في السماء مصعدا، وهذا العنصر الهدام قد مشى مع الإسلام واستدار معه حيث دار في جميع مراحله، وركب الناس له من أجل ذلك كل مركب.
ولم يتورعوا عن كل ما من شأنه أن يصرف الناس عن دينهم، وكان لهذا الخطر صيحاته المدوية بين جوانب المسلمين له من القوة والنفاذ والسرعة والقفز من بلد إلى بلد الشيء الذي تجاوز تقديرات الناس وتحرياتهم، وعامل آخر وهو عامل السياسة فإنها بعد أن امتدت خاصرتها واتسعت حظوظها ووثقت من كفالتها للمجتمع من سبيل غير سبيل الدين، فكرت فيما يضمن لها هذه الكفالة وهذا النفوذ الواسع، فاهتدت إلى اتخاذ الحيطة المقنعة كشعار للضرب على يد الأحرار والتظاهر بالحرص على سلامة الأمة الإسلامية وتحصينه مما قد يصيبها من هذا التسامح الفكري الذي قد تصبحه آثار سيئة قد تنتهي به إلى طائفية ممقوتة، وإلى أفكار متسلطة، وإلى تشييد دعوات مناهضة للإسلام قد تنقسم معها الأمة على نفسها ويدب إليها دبيب الوهن ويسودها القلق، وخاصة بعد موت الرسول (ص) واختفاء الخلافة الإسلامية وظهور طلائع فساد الحكم وفساد الذمم وفساد الضمير الديني، هكذا يكون، والله أعلم بما يبيتون. فهذه الوسيلة يريد دعاة السياسة أن يستقبلوا الأحداث والمفاجئات حتى يتم لهم القضاء على الأفكار الواعية، وقد ظهر على مسرح الحياة الإسلامية نماذج من هذا القبيل كانت مثار فتن ومخاض شديد وسبب خصومات متصلة الضرام، وسبب انتصارات وهزائم.
ومن أجل ذلك كانت تنظر إلى العقلية الإسلامية في حريتها وفي قوة إرادتها وترى فيها أعظم خطر يتهددها من حين لآخر، فماذا تعمل إزاء هذا الاجتهاد الذي يشاطرها هيمنتها على المجتمع وعلى الوضع العام، والحال أنها لا تتوفر على الحظوظ الكافية من التمثيل الإسلامي الذي استأثر به العلماء المجتهدون الذين يحتكم إليهم الناس في جميع ارتباطاتهم وعلاقة بعضهم ببعض على نطاق واسع؟ وما هو الضمان الوحيد لقلب أنظار الناس وتحويلهم إلى إسلام مقاليدهم إليهم عن ثقة وشعورهم بالحاجة إلى ولاء السياسة العامة للبلاد. وبأي وسيلة يمكن لها أن تجمع ـ في قطاع خاص ـ بين ثقل ميزان السياسة وتحقيق المصلحة الخاصة، وبين تأكيد الصلة بالمجتمع وبدينها أمام الجماهير؟ كل هذه الخواطر كانت تجول في أذهانهم للتخلص من تحرشات الطبقة الواعية التي يسندها الدين، فما هي الخطوة الأولى في توهين قواهم واستنامة الجماهير وارتياحهم إليهم؟ أمامها وسائل جمة، ولكنها شعرت ـ في الأخير ـ بأن كل شيء يبدو أمامها قائما إذا لم تستهدف نقطة الانطلاق الرئيسية، والمد الحقيقي في ومبدأ حركة، ومبدأ ألفة وصفاء وتسامح. ولذا قامت بأكثر مما يلزم في هذا السبيل لما ارتاعت من وفرة المجتهدين، وتدفق العلماء من أهل الرأي والبصيرة على الأقطار الإسلامية بعد ما استفحلت الحضارة الإسلامية واتسعت فتوحاتها، فتقدر بعض الموسوعات التاريخية عند حديثها على نهضة الاجتهاد في الإسلام أنه بلغ عدد المجتهدين من الاجتهاد في الإسلام أنه بلغ عدد المجتهدين من الاجتهاد المطلق ـ في عصر ما بين آخر الدولة الأموية وأوائل خلاقة أبي جعفر المنصور خمسمائة مجتهد.
وإزاء هذا إذا هي ما سلكت سبيل العسف والمصادرة فإن ذلك يقتل في الشعوب روح الاطمئنان إليها والالتفاف حولها.
فلذا سارعت إلى اصطناع المذاهب بمساهمتها في تأسيسها وحمايتها والمبادرة إلى التدخل بجميع ما تملك من ضروب النشاط على شرط أن تتسم بطابعها وتمشي في فلكها، وفي الجانب الآخر كانت هناك اضطهادات ولعنات تصب على المناوئين الذين استوثقوا من صلابة دينهم وضميرهم وعقليتهم فباعوا أنفسهم لله.
وأسهام السياسة في تأسيس المذاهب كان ملء سمع التاريخ وبصره، فيذكر الإمام ابن حزم قدس الله روحه : أن مذهبين قد انتشرا في بداية أمرهما بقوة السلطان : الحنفي بالعراق والمالكي بالأندلس.
ويظهر أن محاولة المنصور العباسي علي أن يحمل الإمام مالكا على تدوين الموطأ لتسير في الآفاق ويحمل الناس عليها كانت تهدف من غير شك إلى هذا الحجر المذهبي، ولكن جلالة مالك واسترشاده بدينه حالت دون الانتهاء إلى رأي أمير المؤمنين فوافقه على مبدأ التصنيف، وألح عليه في أن يترك المسلمين في حل من تقليد علمائهم، ما داموا متحرين لكتاب الله وسنة رسوله.
هذا بالإضافة إلى مسائل أخرى كانت تعرض على العلماء ـ لا ليأخذوا رأيهم ـ ولكن ليحملوهم على ترسم آثار سياستهم، وكانت في الحقيقة امتحانا لضمائرهم ومحنة عليهم. ولم يقف الأمر عند هذا الجد بل انتقلت هذه العدوى السياسية من الشرق إلى أرض الأندلس تحت تأثير ما لمسوه من قوة الدفع في صفوف العلماء ومن التفتح الاجتماعي، ومن وعيهم المتدفق في الشريعة الإسلامية والوقوف على أسرارها، بقلوب هذبها الدين، وبعقول راضها الإسلام، فماذا كان موقفهم، وما هي الفطنة التي يستريحون إليها؟
عمدوا إلى إنشاء مجلس الشورى لكبار العلماء ليناط بهم الاجتهاد (الرسمي) وحدهم فيما يعرض من أحكام ترجع إلى التشريع والأمور العامة للدولة والأوقاف لتصاغ الأقضية ـ في كل جانب ـ صياغتها الملائمة. وربما نجد بين ثنايا هذا المجلس من لم يألف الاحتراف بأفكاره، والارتزاق بدينه، فذاقوا من صنوف النكال والمهانة والتعذيب ألوانا، ولئن أظلتهم السجون على مهاد التاريخ.
وكانت تروج ـ في هذه المجالس ـ صور قضائية من حين لآخر لو دونت ـ بأمانة وتجرد ـ لكانت مرجعا سياسيا ضخما يطالعنا بكثير من تقلبات الدولة الإسلامية وبطابعها السياسي وبالاتجاه الاجتماعي وبالفكرة العامة التي تستولي عليها لذلك العهد.
ومن الشذوذ التاريخي أن المغرب الأقصى لم يتأثر بهذه العدوى السياسية بل بقي بمنجاة منها وخاصة على عهد المرابطين ـ الذين كانت فروض السياسة وعلاقة الأنظمة وازدهار الدولة تسرع بهم إلى اتخاذ مثل هذا الموقف.
فقد كان الفقهاء والقضاة يتسمون بطابعهم المتميز وفي مكانهم البارز من الدولة لهم حظوظهم الواسعة في المجالس وفي الانتهاء إلى آرائهم.
فقد أعطى يوسف بن تاشفين للقضاة سلطة مطلقة لا ترد أحكامهم ولا يتدخل فيها ولا تخضع لنظام الشورى السائد بالأندلس، وقد جر هذا النفوذ الواسع القاضي ابن أحمدين في أواخر دولة المرابطين على الاستقلال بملك بعض الأقاليم، كما حاول قاض آخر أن يحل محل عبد الله بن ياسين في إشرافه الفعلي على الدولة وصيرورة مقاليد الأمور إليه. ولئن كان الناس يعللون هذه الظاهرة الاجتماعية بخفة وزن الدولة وضعف حظها من الاختمار السياسي، وانطباعها بمسحة البداوة التي تعلو سائر تصرفاتها، الأمر الذي دعا كثيرا من المستشرقين إلى إطالة الوقوف على مئاثر هذه الدولة التي طالت معها حسرتهم، وإلى إصدار أحكامهم العفوية فإن أمرا واحدا يسكب الماء البارد على حرارة هذه الأحكام وهو تزود الدولة بمقدار بالغ من الهدي الإسلامي وتأثرها به إلى مدى بعيد.
وإذا كانت مسحة البداوة تتمثل في الإخلاص والتجرد والتمسك بالدين وإزاحة الخلل والانتقاض بين صفوف المسلمين، والعمل المتصل لإيصال الخير إلى الناس كافة، فإن واحدا لا يشك لحظة في أن هذا ما يطلب من كل نظام عام في كل عصر وفي كل دولة.
على أن يوسف بن تاشفين لم يكن طرازا وحده في هذا الميدان فهناك غيره من ملوك المغرب من ارتاح إلى القضاء على المذهبية المتصلبة، ونبذ التقليد، فنجد عبد المومن بن علي حوالي سنة 550 قد تنبه هو أيضا إلى هذا الخطر بعلماء المسلمين، إذ وجد الفتور العام، والقنوط الفكري يستوليان عليهم في تقليد مميت، وفي إطار الفروض والفروع، وأسلوب التأليف المريض إلى معارك جدلية، ومماحكات ومناقشات تلفظية تقتل المواهب كما تقتل الزمن في فراغ وعقم، فأمرهم بالاجتهاد ونبذ التقليد والعكوف على الدراسة الإسلامية من ينابيعها الصافية. هذا بالإضافة إلى انتفاضات فكرية حرة تحاول مساندة الاجتهاد تظهر في فترات متفرقة يكاد يكون له سلطانها وتفوقها ـ لولا منافسة البيئة والسلطة الزمنية والظروف الغير المناسبة، وعقد الجمود المستعصية التي تريد إشباع حاجتها تحقيقا لمطالب شتى.
ودعاة الاجتهاد والتحرر الفكري حينما يدعون الناس إلى الاقتناع بالدليل، وتعويد أنفسهم على تحكيم المنطق النفسي ـ لا يريدون إلا شيئا واحدا وهو : أن يرتبط المسلمون بدينهم وبمجتمعهم، ويعملوا على تقوية تلك الصلاة الوثيقة ويسهلوا على الناس طريق الاتصال بهم كي يتعرفوا على ما عندهم ويتعرفوا هم أيضا على ما عند الناس.
ويجب أن لا ينسى ما لأهل الاجتهاد من علمائنا المتقدمين من جهود في رعاية تلك المواريث الضخمة الإسلامية، وما لهم من أعمال مشكورة في تشييد الفكرة الإسلامية، ويجب أن نذكرهم ولا ننساهم ونخلق من مدرستهم أفكارا متفتحة واعية نبني على غرارها ونستفيد من خبراتها، ونستهدف الحصول على ضروب الالتقاء معهم على أساس تلك المئاخذ والمدارك التي تحروا فيها كل الدقة والعمق والوضوح والملاءمة مع الخطوط الإسلامية الكبرى.
وأخال أنك تذكر قول الإمام الشافعي رحمه الله : كل ما نزل بمسلم ففيه حكم لازم، أو على سبيل الحق ففيه دلالة موجودة، وعليه إذا كان فيه أتبعه، وإن لم يكن فيه طلب الدلالة على سبيل الحق فيه بالاجتهاد.
كما يجب أن لا يغيب عن أذهاننا قول الشيخ عز الدين بن عبد السلام قدس الله روحه: لم يزل الناس يسألون من اتفق من العلماء من غير تقيد بمذهب ولا إنكار على أحد من السائلين إلى أن ظهرت هذه المذاهب ومتعصبوها من المقلدين فإن أحدهم يتبع أمامه ـ مع بعد مذهبه عن الأدلة مقلدا له ـ كأنه نبي أرسل.
ولا داعي الآن إلى إجهاد الفكر في صياغة قواعد لتلتقي مع المقاصد الإسلامية ـ ما دام المفروض أن علماء الإسلام القدامى قد أوغلوا في سيرهم لاستثمار هذه الأصول وتفهم المعاني الحقيقية لها وتخير أحسن الطرق للاستفادة منها ولإبداء مناسبات الحكم لمقصد التشريع، فكل واحد من العلماء، وإن كانت له طريقته في الأخذ والعطاء وله طريقته في فهم النصوص ـ إلا أن الكل كان يعمل على تقريب مئاخذ الشريعة الإسلامية إلى أذهان الناس تحقيقا لميزة تعميم التشريع وتحقيقا للاعتبارات الإنسانية الهادفة في غير إخلال وفي غير إرهاق.
ولابد لي ـ في هذا الإلمام ـ أن أسوق إليك جملة من هذه الأصول، فالقول بالاستحسان والمصالح المرسلة وأنواع القياس والمصلحة العامة على طريقة نجم الدين الإمام الطوفي المتوفى سنة 716 وما تعم به البلوى والاستصحاب وسد الذرائع ومراعاة الخلاف وإزالة الضرر واليقين لا يرفع بالشك، والمشقة نجلب التيسير والبراءة الأصلية والاستقراء والعادة محكمة، والأخذ بالأخف والاستدلال وتحكيم الحال والرجوع إلى المنافع والمضار وعمل أهل المدينة ومعقولية النص كل ذلك كان في الحقيقة ارتيادا لمقاصد الإسلام الكبرى وانتصارا لضمان سير هذا الدين ولانتظامه وهو يسير مع الزمن ومع الفكر ومع مطالب الحياة ومع الناس جميعا في كل عصر.
وإذا كان لابد من طريق لعلمائنا في عصرنا الحاضر فلا يكون غير هذا الطريق الذي سلكه أسلافنا والذي دلت فيه التجربة بمرور الزمن ـ وكشف الواقع على صلابته وعلى الوثوق به، فإذا ما صحت العزائم واستقامت الأحوال وتجردوا عن الملابسات، وجردوا من أنفسهم إيمانا صادقا بالحاجة إلى ضروب الالتقاء مع روادهم القدامى في كل ميدان، فإن ذلك سيسهل عليهم ـ ولا شك ـ طريق وحدة فكرية إسلامية، المناط الوحيد لبناء وحدة اجتماعية قوية متماسكة فيها قوة الدفع وفيها الحركة المستمرة وفيها رسم للجوانب الإنشائية وسيبلغون بذلك مدى ما يصل إليه الناس في مبادرتهم وفي مواصلة سعيهم إذا ما فهموا ذلك فهما مجردا عن كل شرح وحاشية وتقرير.
