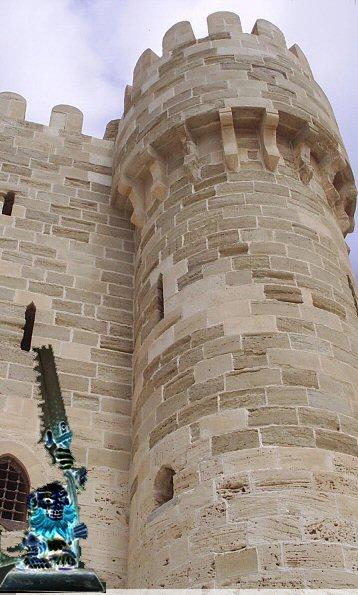|
نبيل شبيب
نبيل شبيب
استشراف ما يمكن أن تسفر عنه التطوّرات المرتبطة برسوم الكاريكاتور المسيئة، يتطلّب أوّلا وضع الحدث في إطار تاريخي ومعاصر، رغم صعوبة هذه المحاولة في ظلّ الأجواء الساخنة التي تصنعها التطوّرات، وتكاد تغيّب الرؤية الموضوعية لأبعادها العملية مع العنصر الوجداني الكامن فيها.
العجز عن استيعاب الحدث
عكّاز حرية التعبير
احتمالات مستقبلية
العجز عن استيعاب الحدث
أصبح السؤال الرئيسي المطروح غربيا في متابعة انفجار التحرّك الوجداني الشعبي تجاه رسوم الكاريكاتور المسيئة لمقام النبوّة، هو ما إذا كانت الأحداث ستجري في اتجاه صدام حضاري ثقافي وصراع ديني عقدي. ويبقى الخطّ العام فيما عدا ذلك هو "الدفاع عن حرية التعبير تجاه المتطرّفين والمتشدّدين"، ليس فقط في جانب المسلمين وفق ما اعتادت الكتابات الفكرية والإعلامية الغربية عليه، إذ تتزايد تدريجيا الأصوات التي تنبّه لتطرّف استخدام حريّة التعبير للإساءة إلى معتقدات الآخرين وقيمهم أيضا.
من التساؤلات المطروحة أيضا ما يشكّك في وجدانيّة الاحتجاجات الجماهيرية، فعلام لم تنطلق "تلقائيا" إلاّ بعد مضيّ عدّة شهور على نشر الرسوم. ويمكن في الأصل الإجابة برؤية العامل الزمني بعد إخفاق محاولات المسلمين في الدانيمارك في طلب اعتذار الصحيفة المعنية بأسلوب الحوار، وإخفاق أحد عشر سفيرا في محاولة تطويق المشكلة إذ رفض وزير الخارجية الدانيماركي استقبالهم، ومن جهة أخرى لعبت أحداث محلية (في مصر وفلسطين مثلا) دورها في تعزيز الثقة بالنفس من منطلق إسلامي، أمّا التشكيك المعتمد غربيا فهو زعم وجود جهات أرادت تفجير الموقف، فحرّكت الاحتجاجات، وهو تفسير يتهاوى سريعا عند وضعه في مواجهة حجمها وامتدادها جغرافيا ونوعيّا. فقد كانت رسوم الكاريكاتور "شرارة" أشعلت الغضب وكشفت عن تراكم قدر كبير من الأحاسيس التي صنعتها سياسات القهر الصهيوأمريكية.
عناوين سقوط كابول وبغداد، ومخازي أبو غريب وجوانتانامو، والفتك بالفلسطينيين وما جدّ غربيا لاستهداف مزيد من البلدان الإسلامية، عناوين معروفة، ولا ريب في وجود المزيد ممّا انتشر في الميادين العقدية والفكرية، كتعامل السلطات الفرنسية مع الحجاب ثمّ مع المهمّشين اجتماعيا واقتصاديا من السكان المسلمين، إلى جانب مسلسل تشريع قوانين غربية تنضح بالروح العنصرية بحجّة "مكافحة الإرهاب"، وكذلك المشاريع الإملائية لتعديل المناهج بأساليب تسلّطية قهرية.. جميع ذلك أعطى تنبؤات صموئيل هننجتون عن صدام الحضارات أبعادا فكرية وثقافية ملموسة إلى جانب الأبعاد العسكرية والسياسية المأساوية، وأوصل الوجدان الإسلامي، عقديا وحضاريا، إلى احتقان برز للعيان في التفاعل مع حدث رسوم الكاريكاتور المسيئة.. فكانت -كما يقال- القطرة الأخيرة التي أحدثت الطوفان.
والقليل فقط من الأقلام الغربية، الفكرية والإعلامية، من يتجاوز الروح العدائية فيحذّر بإلحاح من مغبّة هذا الاحتقان وعواقب انفجاره، ومن محاولات الالتفاف حوله أو تجاهله، فضلا عن تصعيده. وهي أصوات تنطلق من منظور المصلحة الغربية الذاتية ومن خطورة الصدام الحضاري على الغرب، كما كان مثلا مع المستشرق والكاتب المعروف بيتر شولاتور الفرنسيّ الأصل في عدد من كتبه التي أصدرها مواكبة للصحوة الإسلامية وسقوط الشيوعية، أو مع الكاتب والإعلامي الألماني ميشائيل لودرس في كتاباته ومواقفه الإعلامية العديدة، وشبيه ذلك ما يمكن رصده مواكبا لحدث الإساءة الكاريكاتورية بأقلام أخرى.
إنّ غلبة العجز عن استيعاب الحدث، أو الانحراف في محاولات تفسيره، لا تعود فقط إلى عنصر المفاجأة إزاء حياة الوجدان في المنطقة الإسلامية رغم سائر التنبّؤات بوأده سابقا، بل تكشف أيضا عن هشاشة القول بأنّ التطرّف المقصود ينمو نتيجة استغلال المتطرّفين لأوضاع الفقر والبؤس والفساد المصنوعة محليّا فحسب، وهي نظرة "حصرية" تستهدف تبرئة الغرب وممارساته.
ويرتبط العجز عن استيعاب الحدث ارتباطا وثيقا بوهم كبير صنعه توارث النظرة المركزية الغربيّة عبر مئات السنين الماضية، فكلّ معارضة للغرب وسياساته وممارساته، لا تكاد تجد تفسيرا غربيا لها، إلاّ من زاوية جهل "الآخر" بالغرب، أو نوازع الحسد والحقد بسبب تقدّمه، وهو تفسير غريب بلغ مداه في هالة "البراءة" المعروفة، المحيطة دون قصد أو المصطنعة قصدا حول التساؤل الأمريكي "عن أسباب كراهية أمريكا".

عكّازة حرية التعبير
هنا تتّخذ الحريّة الشخصية ومنها حريّة التعبير مكانة محورية، فهي وفق التصوّر الغربيّ في قمّة منتجات "القيم الغربية" منذ عصر تنوير أوروبا، وهي بالتالي في مقدّمة ما يعطيه الغرب للبشرية، ولا يمكن تصوّر التخلّي ذاتيا عنها، أو التخلّي عن التبشير بها والمطالبة بتبنّيها، ولكن يوجد من أصبح يتساءل على ضوء حدث الغساءة الكاريكاتورية، ما هي هذه "الحرية الشخصية" وما حدودها؟
لا حاجة هنا للخوض في الفكر الفلسفي التاريخي الغربي من عصر "ديمقراطية الإغريق" الطبقية التي عارضها -على نواقصها- كبار فلاسفة الإغريق مثل سقراط وأفلاطون وأرسطو، وحتّى عصر التمرّد على الاستبداد مع كانط وفولتيير وروسّو، إنّما يمكن الوقوف عند الانحراف المعاصر لمسار الحرية الشخصية مع غلبة العوامل المادية على عوامل القيم الأخلاقية الكامنة وراء دعوات الحرية. فقد كان للحرية الشخصية حدودها على الدوام، وما يزال، ولكن بدلا من تثبيت القيم الإنسانية مصدرا لحدود الحريّة الشخصية، ليتحقّق التوازن في المجتمع وفي الحياة البشرية، أصبحت المصالح المادية هي التي تقرّر تلك الحدود، وهو واقع قائم رغم سائر ما يُنشر من مزاعم عن كونها حريّة مطلقة. ولم يسبق تاريخيا أن وجدت حرية شخصية مطلقة، ولا توجد في الوقت الحاضر في أيّ بلد غربي على الإطلاق، وهذا ممّا يتبيّن عند التأمّل في تداعيات حدث رسوم الكاريكاتور المسيئة لمقام النبوّة. إنّ إطلاق الحرية لتنال من القيم الدينية وغير الدينية دون حساب، يرتبط بالنشأة التاريخية للتمرّد المعروف على الاستبداد الذي كان يرفع "زورا" عناوين القيم الدينية في الدرجة الأولى، ولكن لا يمكن بالمقابل أن يوجّه صاحب قلم اليوم إهانة مباشرة أو افتراء مختلقا لإنسان آخر في الغرب، سواء كان في موقع المسؤولية أو خارج نطاقها، دون أن يواجه صاحب القلم المعنيّ تشريعات وقوانين وأنظمة تقرّر للحرية حدودها، فيجد المحاسبة القضائية، أمّا عند غياب القدرة الشخصية للدفاع عن النفس، لأسباب مالية مثلا، أو غياب الجهة المعتبرة قانونا لتدفع الإهانة والافتراء -وذاك ما يسري على معظم ما يرتبط بالإسلام- فإنّ سيادة القانون والقضاء تبقى في هذه الحالة مجرّد مبدأ جيد، ساري المفعول نظريا دون تطبيق عملي.
وتظهر هنا هشاشة الحجّة الرسمية التي يطرحها الساسة الغربيّون عندما يقولون إنّ حرية التعبير حرية يكفلها القانون فلا يمكن منع وسيلة إعلامية، كالجريدة الدانيماركية ومن تابعها، من نشر ما تريد، فالمسألة هنا ليست مسألة بقاء الإساءة إلى "الآخر" عقديا وحضاريا دون حساب، بسبب غياب القانون، وإنّما هي مسألة "تغييب" القانون. أو بتعبير أوضح بسبب الإهمال الصادر عن منطلقات فكرية فلسفية ذاتية، والقائم على الصعيد التشريعي للقوانين، فالفكر "المادي المركزي" الغربي الذي تنبثق القوانين عنه، يمكن أن "يشرّع" الكثير ليمنع الإساءة في مسألة "المحرقة النازية" كمثال كثر الاستشهاد به، أو ليمنع الإساءة المهينة لشخص آخر، أو ليمنع اتهامه بالاختلاس مثلا دون دليل، أو حتّى اتهامه بالإرهاب ودعم الإرهاب، أمّا أن يوجّه الاتهام أو الافتراء بشكل تعميمي معروف، لدين "الآخر" أو نبيّ "الآخر" أو ثقافة "الآخر"، فهذا ما "لا يريد" المشرّع القانوني الغربي أن يمنعه بقوّة القانون وسيادة القضاء، ويستطيع أن يمنعه لو أراد.

مخاض حضاري إسلامي
على أنّ التركيز على السؤال المطروح بمنظور غربي عن احتمالات الصدام والحوار مستقبلا، لا ينبغي أن يلفت الأنظار أنّنا لا نعاصر مرحلة تحوّل تاريخي من حالة حوار وتعايش حضاري ثقافي قائم الآن إلى حالة مستقبلية أخرى، إنّما نعاصر ذروة ما بدأ منذ عدّة أجيال ويوصف -في إطار المنظور الحضاري الإسلامي- بالغزو الغربي، الفكري والثقافي والاجتماعي، إضافة إلى عسكرة الهيمنة في الميادين السياسية والاقتصادية. وبالتالي ليست النقلة المحتملة التي يُخشى منها غربيا، هي نقلة إلى الصدام بعد الوئام بين طرفين يتعاملان تعامل الأنداد، بل هي نقلة محتملة في اتجاه تعديل وضع منحرف يتمسّك الغرب به وبانحرافه، ولا يلغي ذلك أصلَ السؤال ما إذا كان التصحيح المرجو سيأخذ أسلوب الصدام أو الحوار، أو يكون خليطا بين هذا وذاك.
إنّ قسطا كبيرا من السياسات والممارسات الغربية لا يمكن تفسيره بالحجج والذرائع المعلنة، رغم أهمّيتها، كالأخطاء الأمنية المرتبطة بظاهرة الإرهاب، أو التهديدات المحتملة في حالة امتلاك الدول الإسلامية قوّة رادعة من أسلحة متطوّرة، أو تحقيق استقلال فعلي في تعامل البلدان الإسلامية مع الثروات والطاقات الذاتية لا سيّما مصادر الطاقة النفطية، إنّما يمكن تفسيره بالخشية من نموذج حضاري إسلامي "لا يلغي" الآخر الغربي، ولكن يضع حدّا لتجاوزات النموذج الغربي بنظرته المركزية للذات وفرض هيمنته على الآخر، في الميادين المذكورة وسواها.
وبقدر ما تمثّل الصحوة الإسلامية -على علاّتها- دليلا على إخفاق الوسائل المستخدمة على امتداد ثلاثة أجيال سابقة على الأقلّ لتثبيت النموذج الغربي بديلا عن الإسلامي، في البلدان الإسلامية نفسها، بقدر ما تعبّر عسكرة الهيمنة الصهيوأمريكية في هجمتها الجديدة المعاصرة عن إفلاس غربي في الوسائل الفكرية والقيمية في ميدان العلاقة الحضارية، سواء وضعت تحت عنوان المواجهة والصدام أم التعايش والحوار.
إنّ التعبير الشعبي المباشر عن حياة الوجدان في المنطقة الإسلامية، كما بدأ بالظهور مجدّدا مع ولادة انتفاضة الأقصى، وبلغ ذروة جديدة في الردّ الجماهيري التلقائي -رغم غلبة الجانب العشوائي عليه- على رسوم الكاريكاتور المسيئة، هو العنصر الأخطر البارز للعيان في أنّ عنصر الحرية بالذات، وبالتالي التعبير عن إرادة الشعوب المقيّدة بالاستبداد الداخلي والدولي حتى الآن، وهو العنصر الذي يركّز الغرب عليه في سائر دعواته إلى درجة ادّعاءات احتكارية له، يمكن أن يؤدّي -عند الأخذ به بموازين القيم وليس بموازين غلبة القوّة المادية- إلى زوال الخلل الراهن في موازين العلاقات الحضارية البشرية.

احتمالات مستقبلية
لا يمكن في إطار ما سبق تصوّر الوصول بمجرى الأحداث حول رسوم الكاريكاتور المسيئة، إلى صدور مواقف وتصريحات غربية في صيغة اعتذار حقيقيّ، ناهيك عن استصدار تشريع قانوني منصف في التعامل مع "الآخر" الإسلامي. وسيبقى التركيز على محاولة وضع مبدأ "حرية التعبير" مقابل "حرية المعتقد" وإن ظهر انحراف هذه المعادلة بصورة كاملة. فالتخلّي عنها يعني التراجع حضاريا، سواء في صدام أم حوار.
ولكن هل يصحّ مقابل ذلك ما يُطرح أحيانا بصيغة التعميم من "إنّ القوى الغربية لا تفهم سوى لغة المصالح المادية، فمقاطعة البضائع كما في حالة الدانيمارك ستحقق أغراضها"؟.. إذا كان المنطلق صحيحا، فأسلوب التعميم فيه، وكذلك أسلوب التطبيق العملي للمقاطعة، ينطوي على أسئلة يحتاج كلّ منها إلى بحث منفصل، وتشير إليها تنويهاً النقاط التالية:
1- تعليل المقاطعة الشعبية بسبب مباشر لاندلاعها، مثل رسوم الكاريكاتور المسيئة، لا يكفي لمواصلتها من جهة، ولاستيعاب أسبابها عند الجهات المستهدَفة وعند الرأي العام، لتؤدّي مفعولها، من جهة أخرى. والمقاطعة ميدان واحد من الميادين المطلوبة للتفاعل مع "مسلسل" من الأحداث المتتابعة. هنا يظهر مدى النقص الناجم عن افتقاد صيغة شمولية "استراتيجية" يتلاقى على وضعها أصحاب الفكر والاختصاص، بمبادرات تصدر عن جهاتٍ مرشّحة لتعزيز القيادات الشعبية، كالاتحاد العالمي للعلماء، والحملة العالمية لمقاومة العدوان، وغيرها، بل يمكن أن تنطوي هذه الجهود المرجوّة على التواصل مع جهات غربية مختارة، لطرح البدائل العملية عن علاقات الصراع ومن يديرونه في الوقت الحاضر.
2- يتبع ذلك أن حملات المقاطعة، للبضائع الأمريكية والإسرائيلية سابقا، ولمنتجات دانيماركية ونرويجية وربما أوروبية لاحقا، ما تزال شعبية المنطلق، وجدانية المسار، ولا ترافقها خطوات تصدر عن الهيئات المشار إليها وسواها، لإيجاد الأطر والآليّات التنظيمية التنفيذية والتقويمية التطويرية، كتشكيل لجان محلية وعبر الحدود، تتولّى ما يحتاج نجاح المقاطعة إليه من دراسة، وتخطيط، وإدارة ومتابعة، وربط كلّ هدف مرحلي بالأهداف البعيدة، مع تجنّب وقوع الأضرار، ووضع المقاطعة في إطار حركة التنمية للطاقات والإنجازات على المستويات الوطنية والإقليمية، والتواصل الهادف عالميا.
3- التفاعل مع حدث الإساءة الكاريكاتورية هزّة تركت أثرا "إيجابيا" تكشف عن بعض جوانبه عمليات استطلاع الرأي في عدد من المواقع الشبكية الإعلامية، كما أثار قلقا كبيرا على الصعيد الرسمي، تشير إليه محاولات التهدئة على نواقصها، ولكنّ القصور في مبادرات عملية تالية، يمكن أن يساهم في اضمحلال المفعول الإيجابي بعد ركود الاحتجاجات الوجدانية، فلا يبقى سوى المحاولات الغربية المنتظرة لاتخاذ إجراءات وقائية مستقبلية، مثل وضع آلية مناسبة لمنع انفراد دولة غربية -كالدانيمارك- في التعرّض لحملة احتجاج تلحق ضررا بها.
4- لا تصحّ "المبالغة" في النظرة إلى المصالح المادية، فالمنطلق الغربي في مواجهة التفاعل مع حدث الإساءة لا يقتصر عليها وحدها، بل ينطوي على جوانب عقدية وفكرية، ومع العمل للحدّ من الأضرار المادية اعتمادا على المركز المادي الأقوى للغرب، يُنتظر توظيف الجانب المادي السلبي المرتبط بالمقاطعة، لتأكيد المنظور المنحرف عن الإسلام والمسلمين وقضاياهم، وهو المعتمد في الترويج والتسويغ لمشاريع معروفة كما في ميادين تبديل المناهج، ووضع المرأة، وكبت مظاهر الصحوة، وغيرها.
5- لا ريب أنّ الموقفين الرسميين، الأمريكي والبريطاني، استهدفا محاولة الحدّ من سوء صورة البلدين في المنطقة الإسلامية بسبب أحداث العراق وفلسطين وسواهما. وبالمقابل لا يُستبعد أن يكون من آثار الاحتجاجات الشعبية الكبرى دعم مواقع الجناح الرافض للممارسات العدوانية الراهنة في البلدين وفي الغرب عموما، وهو ما قد يسفر عن إعادة النظر في خطط تصعيد تلك الممارسات واحتمالات انتقالها إلى بلدان أخرى في المستقبل المنظور.
6- قد تنجح الدول الإسلامية في مبادرتها لاستصدار "توصية" عن الجمعية العامّة للأمم المتحدة بشأن ربط حرية التعبير بعدم الإساءة إلى الأديان، ولكنّ بقاء الخلل في توازن القوى الدولية، مع افتقاد صيغة إسلامية شمولية "استراتيجية" للتعامل معه، يمكن أن يحوّل "التوصية" إلى سلاح لكبت حرية التعبير في البلدان الإسلامية تجاه أصحاب "التصوّرات" الغربية، أكثر من استخدامها إسلاميا لمواجهة من يتجاوز حرية التعبير بالإساءة إلى الإسلام.
7- يبقى في الختام سؤال جوهري عن مستقبل العلاقات الاقتصادية بين الدول الغربية عموما والمنطقة الإسلامية، وهو سؤال تستحيل الإجابة عليه ما لم تتحوّل المقاطعة وهي موقف سلبي، إلى موقف إيجابي، يتمثّل في إنجازات محلية قائمة على التخطيط والإنتاج والتسويق والتعاون الإقليمي، بما يضع حدّا لعلاقات دولية تفتقر إلى التوازن، ويمكن توظيفها باستمرار في غير مصلحة المنطقة الإسلامية.
|