على طريق التغيير
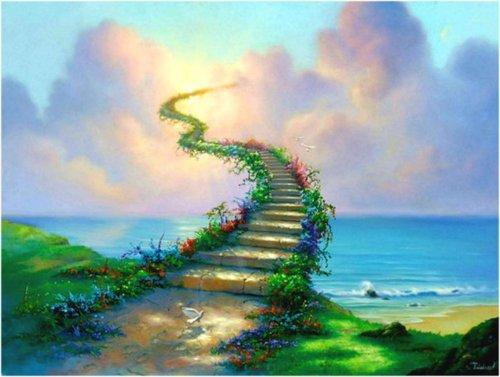
نقلة نوعية مطلوبة من أرضية الحوار إلى أرضية العمل
نبيل شبيب
التغيير الذي نحتاج إليه في بلادنا العربية والإسلامية تغيير متميّز بذاته، لا يصحّ ربطه بسواه تشبيها، لا من حيث المضمون ولا من حيث كيفية الوصول إليه، إنّما يرتبط هذا التغيير الضروري والمطلوب بأوضاعنا الذاتية، واحتياجاتنا الذاتية، وتطلّعاتنا الذاتية. والتغيير لا يوصل إلى أوضاع مستقرّة دون أن ينسجم مع المعطيات الحضارية الخاصة بنا، ودون أن يسلك الطريق التي تراعي هذه المعطيات في واقعنا نحن في عالمنا المعاصر. من هنا تجدر الإشارة إلى:
1- إلى ضعف سلامة المقارنات التي كثيرا ما تربط ربطا متسرّعا بين ما (لم نحققه) و(حقّقه) سوانا، من أمثال اليابان وألمانيا في الخمسينات أو الدول الأوروبية الشيوعية سابقا في التسعينات من القرن الميلادي العشرين.
2- عدم جدوى التساؤل ما إذا كان المطروح من صور التغيير القسري من خارج حدود بلادنا وخارج دائرتنا الحضارية قابلا للتنفيذ أو غير قابل، إذ ناهيك عن التساؤل عن حجم الفوائد وحجم الأضرار فيه فيما لو وقع، فالأصل اعتبار الأمر مفروغا منه مسبقا، مع إدراك أنّ أيّ تغيير "من الخارج" يستحيل أن تستقرّ نتائجه، أو أن تغلب إيجابيّاته على سلبياته.
خطر الذوبان حضاريا - رفض مشترك وانتماءات متفرّقة - من شروط التغيير - المرجعية الحضارية الذاتية
ليس التغيير المطلوب في بلادنا العربية والإسلامية تغييرا سطحيا قابلا للتحقيق بمجرّد تبديل سلطة حاكمة، سواء وقع ذلك بانقلاب داخلي، أو بحرب احتلال أجنبي، أو نتيجة عمليات عنف. ولا يتحقق المطلوب بمجرّد إقرار جانب واحد أو بعض الجوانب من التغيير الضروري على صعيد الأوضاع الاقتصادية والسياسية وغيرها، أو في ميادين الفساد والتسلّط، أو ما شابه ذلك ممّا نشعر بواجب تغييره وندرك ضرورة العمل لذلك. بل لا يتحقّق التغيير الحقيقي المطلوب إذا كان الجانب المعنيّ الذي يشهد تغييرا ما من الجوانب البالغة الأهمية، ما دام سواه مهملا أو مُستثنى، مثل إقرار الحقوق والحريات على مستوى الأفراد والأقليات، هذا ناهيك عن استحالة تغيير جانب واحد من جوانب الحياة والحكم على هذا النحو، دون أن يرتبط بتغيير جوانب أخرى، فالأوضاع متشابكة يؤثر بعضها على بعضها الآخر، ولا يستقّر بناء على أعمدةِ أساسِه، إن كان بعضها صالحا والآخر فاسدا.
إنّ التغيير المطلوب (والممكن) هو التغيير الشامل للبنية الهيكلية للمجتمع والنظام، وللرؤية الفردية والتعايش المشترك، ومثل هذا التغيير الجذري مرتبط بالضرورة بترسيخ المرجعية الحضارية (الواحدة) مع ضماناتها لنجاح حدث التغيير أوّلا، واستمراره ثانيا، واستقرار حصيلته ثالثا، ثم سيّان بعد ذلك كم تتعدّد التصوّرات والتيّارات والأحزاب والمجموعات السياسية وشبه السياسية في نطاق تلك المرجعية الحضارية الذاتية المشتركة.
وقد ساهمت الحساسيات المرتبطة في حقبة سابقة بالصراع العنيف بين العلمانية والإسلام إسهاما لا بأس به في تغييب طرح مشكلة المرجعية الحضارية بصورة مباشرة، لحساب الحديث عن التعددية وتعدّد السلطات والحريات وغير ذلك ممّا لا يخفى أنّه يمثّل قضايا هامّة، لكنّها تبقى قضايا فرعية مرتبطة بالهيكل التطبيقي وليس بمنطلقات التغيير الضروري والأسس التي يقوم عليها. وصحيح أنّ كلمة الانتماء، أو الهوية، كانت مطروحة باستمرار غير أنّ الطرح كان في غالب الأحيان أشبه بحلقة إضافية إلى حلقات المرحلة الماضية بعناوين جبهات الصراع فيها، الإسلامية والقومية مع الخلفية العلمانية للقومية منها.
هذا ما تبدّل نسبيا في الآونة الأخيرة تحت تأثير الإحساس المشترك بوطأة الموجة الجديدة من الهجمة الصهيوأمريكية وعنفها، على محوري الانتفاضة الفلسطينية واحتلال العراق بعد أفغانستان، فما تطرحه الهيمنة الخارجية على المنطقة لا يخرج في حصيلته عن مرحلة جديدة من مراحل الإكراه على الانضواء أكثر ممّا مضى تحت رداء "المرجعية الحضارية" لتلك الهيمنة.
بغضّ النظر عن تقويم تلك المرجعية الحضارية "الأخرى" والتي اعتدنا (حرصا على ترسيخ معاني المنهجية والواقعية في التعامل مع الآخر) على القول بوجود سلبيات وإيجابيات فيها.. بغض النظر عن ذلك يبقى أنّ التأمّل الهادئ في الهجمة الجديدة المنطلقة منها، يبيّن أنّها لا تستهدف فرض تغيير بمعنى إيجاد واقع جديد مكان الواقع الراهن، من حيث جذوره وبنيته الهيكلية الفكرية والتنظيمية، وإنّما المطلوب هو الانتقال بالبلدان العربية والإسلامية مرحلة أخرى على الاتجاه نفسه الذي بدأ به التغيير (المعاكس حضاريا) قبل قرن كامل. ويتبيّن هنا أيضا قصور النظرة التي تحصر الحديث في إطار ما إذا كانت عناوين الديمقراطية المرفوعة في هذه المرحلة عناوين صادقة أم مخادعة، سواء ارتبطت بتحقيق مصالح ومطامع أجنبية أم لم ترتبط. هذا أمر جانبي إلى حدّ بعيد في نطاق الرؤية الشاملة لمجرى الأحداث والتطوّرات!.
إنّ المشكلة الحقيقية للديمقراطية في البلدان العربية والإسلامية ليست في حجم الزيف أو الصدق في الحديث عنها ممّا يسهل كشفه، بل كانت وما تزال ترتبط ارتباطا مباشرا بالمرجعية الحضارية التي لا غنى عنها في مجتمع من المجتمعات ونظام من الأنظمة، هل تكون علمانية غربية المنشأ منطلقا وفكرا ونظاما، أم تكون مرجعية حضارية إسلامية، لتكون الديمقراطية في إطارها "نظاما" يؤخذ منه ويترك، وهنا يمكن القبول بأشكال تطبيقية متعددة، كما هو ظاهر للعيان عند المقارنة بين الديمقراطيات الأمريكية والبريطانية والفرنسية والألمانية والسويسرية وغيرها.
إنّ عملية التغيير التاريخية الجارية في "الاتجاه الحضاري المعاكس" بمنظور بلادنا وتاريخها ومستقبلها، وصلت في المرحلة الراهنة إلى مفصل تاريخي جديد يتمثل في طرح هدف "تذويب المنطقة حضاريا"، سواء كانت صياغة حمل هذا الهدف بهذه العبارة المباشرة، أو اختيرت لها عناوين وشعارات ونظريات ما، من قبيل الصراع الحضاري ونهاية التاريخ وعولمة النهج الغربي-الأمريكي وما شابه ذلك، بما في ذلك الحديث المخادع على ألسنة الساسة الغربيين عن "ترسيخ القيم الديمقراطية مع مراعاة الخصوصيات الحضارية!".
لا ريب أنّ الإحساس العام بأنّ خطر التذويب حضاريا أصبح ماثلا للعيان، شاملا للجميع، هو الذي أثار بالمقابل مشاعر القلق، ومواقف الرفض، على تعدّد التيارات والمنطلقات، وهو الذي يوجب طرح مشكلة المرجعية الحضارية طرحا مباشرا، وإعطائها موقع الصدارة عند الحديث عن أيّ "تغيير"، كهدف ذاتي وليس كهدف تطرحه الهيمنة الأجنبية.
لم يعد خطر الذوبان حضاريا خافيا على الغالبية العظمى من أصحاب القلم من مفكرين ومثقفين على تعدّد انتماءاتهم في البلدان العربية والإسلامية، بل بات من العسير في إطار رفض الحملة الصهيوأمريكية التمييزُ تمييزا كبيرا بين قلم إسلامي وآخر قومي وثالث علماني، ولا يكاد يشذّ عن هذه القاعدة سوى فريق لا ينبغي الوقوف عنده طويلا، من أصحاب أقلام ومواقع إعلامية وسياسية، بلغ بهم "الذوبان حضاريا" مبلغه من قبل، فتراهم أشدّ أصولية من الأصوليين المتطرّفين المسيطرين على صناعة القرار في الحملة الصهيوأمريكية، وهو ما يستدعي الاستغراب الشديد على الأقل، عندما ننظر في بعض ما يكتبون وحجم ما فيه من التماشي مع تلك الحملة، أو تسويغها، أو الدعوة إلى التراجع والانكفاء أمامها، أو التهوين من أبعادها وأهدافها، فضلا عن تركيز الهجوم على كلّ من يواجهها، سيّان هل يوصف بالمعتدل أو الإرهابي أو المتطرف بموازين أصحابها، ثم يتضاعف الاستغراب والاستهجان عندما نقارن هذا "الإنتاج الكتابي" مع مواقف وكتابات صادرة عن كثير من أصحاب القلم الفكري داخل البلدان الغربية نفسها، وهم يرفضون بشدّة تلك الهجمة الصهيوأمريكية، سواء في ذلك مَن ينطلقون من واقع التعدّدية الحضارية والثقافية عالميا وضروراته ويدافعون عنها، أو مَن يشاركون سواهم في التطلّع إلى هدف ذوبان البلدان العربية والإسلامية في البوتقة الحضارية الغربية، إنّما يختلفون مع قادة الحملة الصهيوأمريكية على "عنف" وسائلها العسكرية فحسب.
تبقى الحصيلة، وهي أنّ معظم ما نقرؤه في الساحة الفكرية والثقافية الرصينة الجادّة في بلادنا حاليا، يتلاقى على رفض الذوبان حضاريا، ويعبّر هذا الرفض عن نفسه بصيغ متعدّدة تنطوي على معاني متطابقة أو شبه متطابقة. ولكن سرعان ما تفترق الأطر الأوسع نطاقا المطروحة حول هذا الرفض، كما تفتقر باستمرار إلى طرح صيغ مناسبة ما لأرضية مشتركة ترتفع بالجميع من مستوى الرفض إلى مستوى المبادرة، فضلا عن محاولة إيجاد معالم عامّة لجهد مشترك في مجال من المجالات.
لا شكّ أنّ بعض ما يطرح تحت عنوان التلاقي على ثقافة الصمود والمقاومة، يكتسب قيمته الذاتية من خلال تأثير مسلسل أحداث الواقع الذي نعايشه عربيا في العراق وفلسطين ولبنان والصومال والسودان، ونعايشه إسلاميا في أفغانستان والشاشان وسواهما.
كما أنّ بعض ما يطرح حاليا تحت عنوان المجتمع المدني أو الديمقراطية أو الإصلاح يكتسب قيمته الذاتية من خلال تأثير مسلسل أحداث الواقع الذي نعايشه على مستوى المواجهة بين السلطات والشعوب أو السلطات والجماعات "المعارضة".
ولكنّ تأثير هذه الصيغ الجزئية نحو إيجاد أرضية مشتركة للعمل -لا منهج الرفض فقط- يبقى تأثيرا محدودا في نطاق البحث عن "وسائل" ما للتحرّك، كما يضمحلّ سريعا عندما يصطدم بموروث حقبة سابقة، إذ يربط كلّ فريق ما يطرحه بما لديه من منطلقات مرجعية، إسلامية وقومية وعلمانية، وهنا يقتصر التجاوب مع ما يُطرح على من يتجاوب مَع هذه المرجعية أو تلك ابتداءً ممّا ينذر -إذا ما تفاقم- بتكرار مخاطر صدامات ومواجهات سابقة، بدلا من إيجاد أرضية تعامل مستقبلي جديدة، ناهيك عن أخطار إضافية يعبّر عنها عنوان الفتنة الطائفية.
بعض الصيغ المطروحة يربطها أصحابها بمرجعيّتهم فقط مسوّغين ذلك بضرورة إعطاء الأولوية لِما يفرضه واقع الأحداث، وضرورات المواجهة في ساحات الجولة الراهنة للهيمنة العدوانية الأجنبية. ولا يُنتظر في الأصل من أحد التخلّي عمّا يعتقده، في حوار مع الآخر أو تعاون في عمل مشترك، إنّما لا يتحقق بالمقابل أيّ حوار مثمر وتعاون فعّال من خلال تجاوز الآخر أو تجاهله.
أبرز ما يظهر من ذلك للعيان في الوقت الحاضر بعض ما يتردّد في الحديث عن ثقافة الصمود والمقاومة، بدرجة تؤثّر أحيانا على النظرة الموضوعية للوقائع وللمعطيات الثابتة، من ذلك مثلا تأكيد المنطلق الإسلامي "وحده" في واقع المقاومة الفلسطينية، أو على المنطلق القومي "وحده" في واقع المقاومة العراقية، أو الانزلاق إلى التبرؤّ شبه المطلق من حديث ما عن "تحرير أفغانستان أو الشاشان" مثلا، بحجّة عدم علاقة ذلك بالواقع العربي، أو عدم فتح جبهات "خارجية"، بل حتّى للتنصّل من أيّ شبهة "إرهابية" بعد الانحراف بالحديث عن هاتين القضيّتين في الإعلام وعلى المستوى السياسي عن جذورهما ومشروعيّتهما ومكانتهما في القانون الدولي العام والإنساني.
إنّ الخروج -فكرا ومبادرات عملية- من الحلقة المفرغة المرتبطة بمفعول التعدّدية المرجعية هذه، إلى دائرة البحث عن أرضية مشتركة، أصبح ضرورة لا غنى عنها، ولا يكاد يحصل ذلك إطلاقا، أو يحصل ببطء شديد لا يعطي سرعة التطوّرات والأحداث حقّها، وممّا يشهد على ذلك عدم الانتقال حتى الآن بالحوار القومي-الإسلامي الجاري منذ بضعة عشر عاما، من مستوى المواقف والبيانات، إلى مستوى مبادرات مباشرة تصنع "أعمالا" مشتركة.
إنّ حجم الأخطار الخارجية (وقد بات مفعولها المباشر منتشرا في الداخل) وتوسّع نطاق الرفض المشترك للذوبان حضاريا تحت الهيمنة الأجنبية، سيّان بأي عنوان، يفرضان سلوك سبيل تغيير جذري وشامل، يتطلّب بدوره إيجاد أرضية مشتركة لعمل مشترك، وبالتالي تصوّرات مشتركة تجمع على أرض الواقع بين عدّة عناصر أساسية توفّر الشروط اللازمة لكلمة: "مشتركة"، وفي مقدّمة هذه العناصر كما يراها كاتب هذه السطور:
1- الالتزام بأنّ المرجعية الحضارية التي نحتاج إليها هي مرجعية ذاتية في بلادنا، وكلّ ما عدا ذلك يدخل في نطاق التعدّدية الحضارية التي نتعامل معها في عالمنا.
2- الالتزام بالتعاون بين التيارات المحلية لا التعايش "السلبي" فيما بينها فحسب.
3- شمول أهداف التغيير المطلوب مختلف ميادين الحياة والحكم.
4- الالتزام بتحكيم الإرادة الشعبية على صعيد تثبيت المرجعية الحضارية وعلى صعيد آليات صناعة القرار والالتزام بنتائج ذلك التحكيم.
5- رفض التبعيات الأجنبية بجميع أشكالها فكرا وتطبيقا، وتثبيت الأولوية للعلاقات البينية وتطويرها على مختلف المستويات، ابتداء من المستوى القطري الداخلي إلى مستوى التكتل الإقليمي الشامل.
6-تبنّي أهداف كبرى مشتركة أهمّها التحرّر (للأرض والإرادة والطاقات الذاتية)، والتقدّم، والوحدة (بطريقها المرحلي الواقعي).
ظاهر من تسارع الأحداث والتطوّرات أنّه لا ينبغي الانتظار، ولا يوجد في الأصل ما يستدعي انتظار أي طرف إلى أن يتمّ التلاقي الشامل على مرجعيته هو لتكون هي المرجعية "المشتركة" التي يقبل بها الجميع وتكون إمّا إسلامية أو قومية أو علمانية!.. إنّ مثل هذا التلاقي لا يتحقّق بصورة مثالية في الظروف الاعتيادية، فضلا عن إمكانية تحقيقه في ظروفنا الراهنة.
كما لا يفيد الإنكار أو التجاهل لحقيقة أنّ اختلاف التيّارات القائمة في بلادنا العربية والإسلامية، لا يعود في جوهره إلى الفروع بما في ذلك جانب تشريع القوانين وتحديد شكل الحكم وغير ذلك، إنّما يعود إلى اختلاف ما تقرّره المرجعية التي ينطلق منها كلّ طرف على حدة، فيحدّد من خلالها نظرته التطبيقية إلى تنظيم شؤون الحياة والحكم، فالمقارنة القويمة -مع غياب وجود حرية مطلقة لاستحالتها- هي المقارنة بين مجال الحركة الذي تتركه كلّ مرجعية تختارها الإرادة الشعبية لأصحاب مرجعية أخرى لا تختارها الغالبية، مع قابلية الاتفاق على قواعد لذلك لا تقبل التبديل والتغيير.
قد تبدو إمكانات التقارب في بعض الفروع ممكنة، فتغري بالتركيز عليها، ولكن يصعب تحقيق تقارب بهذه الطريقة مع ضمان أن يستقرّ ويستمرّ، إذا ما قام التقارب على أساس تجاهل اختلاف المنطلقات. وهذا ما نعايشه مثلا عندما يتحدّث الإسلاميون والعلمانيون والقوميون -في المعارضة لا السلطة- عن "الديمقراطية"، وكلّ ينطلق من مرجعيته، فيحدّد مصطلحاته ومفاهيمه على أساسها، ويتصوّر الحصيلة في حدودها، ويسري شبيه ذلك على الحديث عن الصمود والمقاومة وعن أهداف التحرّر والوحدة، وعن سبل الرقيّ والتقدّم.. وهكذا.
ولو أنّ هذه الأهداف وأمثالها تحقّقت على أرض الواقع المعاصر وفق أيّ مرجعية بمفردها، فقد يسوغ اعتبار القضية قضية اختلاف فكري أو حوار (أو حتّى صراع على السلطة كما يقال)، أمّا أن يسبق مثلُ هذا الاختلاف والحوار العملَ على تحقيق تلك الأهداف، في مرحلة يتهدّدنا فيها خطر الذوبان حضاريا بما يشمل الجميع، فهذا ضرب من ضروب التفكير العقيم أو العمل العقيم.
من الوهم تصوّر التوصّل بالحوار دون العمل المشترك لدفع الخطر إلى وضع عادل ومستقرّ يتوفّر فيه استقلال الإرادة وتحرير الأرض والطاقات الذاتية. وبتعبير آخر: إنّ ما يمكن أن ينشأ نتيجة "صراع المرجعيات" بدلا من التوافق على صيغة عمل مشترك خارج نطاق الصراع، لن يكون إسلاميا، ولا علمانيا أو قوميا، ولن يثبت على مرجعية ذاتية راسخة ما دام يُفرض فرضا نتيجة لغلبة أحد أطراف الصراع. هذا ما يؤكّده المنطق مثلما تؤكّده تجارب تاريخنا المعاصر.
إنّ ضرورة التلاقي على العناصر المذكورة كحدّ أدنى، أصبحت ضرورة "وجود ومصير"، وأصبح تحديد مضامينها تحديدا مشتركا مقبولا هو ما يتطلّب الحوار الفعال الهادف، للتوصل إلى صيغة عملية تجمع ما بين الأرضية الفكرية أولا، وآليات العمل رغم تعدّد الاقتناعات الذاتية ثانيا، وبين الاطمئنان إلى أنّ هذه الاقتناعات ستكون موضع تنافس نزيه على الحصول على تأييد الإرادة الشعبية ثالثا.
لعلّ الإقدام على ما يسمّى عادة "إجراءات بناء الثقة" يفتح أبوابا ما تزال موصدة، ومن ذلك ما تساهم به الكتابات الفكرية التي تتجنّب عرض ما لدى أصحابها بأسلوب التنديد بالآخر ومعاداته. ولكن هذه الكتابات محدودة كمّا، ولا ترقى إلا نادرا إلى مستوى فتح باب التفاهم والتعاون مع الآخر، ليس في حدود الدعوات المجرّدة أو فيما يشبه "اتفاقيات عدم الاعتداء" وإنّما بما يشمل خطوات عملية ممكنة ولعلّها هي الأهمّ في هذه المرحلة، وبما يشمل ميادين عديدة لا يلعب الحَجْر الاستبدادي دورا مباشرا فيها، فهنا يمكن (ويجب) الانتقال من أساليب "الحوار الكلامي" إلى مرحلة المشاركة في صناعة القرار خارج قاعات الحوار، ويوجد ما يسمح بتطبيق ذلك في ميادين فكرية وثقافية وأدبية وإعلامية وغيرها، فضلا عن صياغة المواقف المشتركة من الأحداث والتطوّرات الجارية، وحملات الصمود والمقاومة ومناهضة الهيمنة ومواجهة الاستبداد، المحلي والدولي.
وسيبقى نجاح سائر "إجراءات بناء الثقة" وخطوات العمل والحوار على السواء، أو إخفاقها، مرتبطا بتثبيت معالم رؤية مشتركة لمرجعية حضارية ذاتية، وهو ما يتطلّب طرحَ مثال على ما يمكن تصوّره من عناصر من الضروري تثبيتها، لمثل تلك الرؤية، وأبرزها:
1- الالتزام الإسلامي بالمرجعية الحضارية الذاتية يقوم على أساس العقيدة والمنهج بما يشمل التركيز على مبدأين ثابتين إسلاميا: (1) لا إكراه في الدين تجاه أي طرف من أطراف المجتمع، و(2) ليس غيرُ المسلمين في دائرة الحضارة الإسلامية أقليّات، إنّما هم جزء من المجتمع المشترك، تسري عليهم صفة المواطنة، وهو ما سبق أن طرحه عدد من العلماء والمفكّرين الإسلاميين.
2- الالتزام بالمرجعية الحضارية الذاتية لدى القوميين يقوم على أساس رابطة القومية العربية انتماء والحضارة الإسلامية رسالة، بما يشمل التركيز على مبدأين ثابتين قوميا: (1) لا عداء للدين عقيدة فردية، ولا لدعوته ودعاته منهجا جماعيا، و(2) ليس غيرُ العرب في دائرة القومية العربية أقليّات، إنّما هم جزء من المجتمع المشترك، تسري عليهم صفة المواطنة دون أن يكون لانتماءاتهم أثر سلبي على حقوقهم الفردية والجماعية
3- الالتزام بالمرجعية الحضارية الذاتية لدى العلمانيين قائم على أساس فكري يقتصر على ما يدعون إليه من مناهج تطبيقية لتنظيم المجتمع، لا تتضمّن عداء للدين، عقيدةً فردية ولا لدعوته ودعاته منهجا جماعيا، كما لا تتضمّن إعطاء الأولوية لمنظومة قيم ما من خارج نطاق الدائرة الحضارية العربية والإسلامية
4- ربط (نية) الاحتكام إلى الإرادة الشعبية بإيجاد آليات وضمانات كفيلة (1) بأن يمارس كل فريق حقّه في بيان ما يتبناه وفي الدعوة إليه، وكفيلة (2) بأن تظهر للعيان نزاهة الآليات التطبيقية المتفق عليها، بحيث برسخ الاقتناع المشترك بصحّة السبل الموصلة إلى بيان ما تقرّره الإرادة الشعبية، كما يرسخ الالتزام القاطع بنتائجه.
5- التلاقي على التزام مشترك، يقضي بأنّه حالما تتوفّر الشروط العملية للاحتكام إلى الإرادة الشعبية، فإنّ هذا سيشمل تثبيتَ صيغة المرجعية الحضارية الذاتية، من بين الأطروحات الرئيسية للتيارات الإسلامية والقومية والعلمانية، وهي المرجعية التي تحدّد المعالم المشتركة لتنظيم جوانب الحياة والحكم، مع القبول مسبقا بما يعنيه ذلك من قواعد وحدود وقيود يكون نصيب الداعين إلى صيغ أخرى هو النصيب الأكبر من الداعين إلى الصيغة الحاصلة على تأييد الإرادة الشعبية.
إن هذه الأفكار العامّة المبدئية محاولة أولية لفتح أبواب الخروج من حلقة مفرغة، باتت من أسباب تحويل وجود الاختلاف الطبيعي داخل الأمة الواحدة، إلى سدود منيعة دون عمل مشترك وتحرّك مشترك، وهما السبيل المحتّم لنتمكّن في بلادنا العربية والإسلامية من مواجهة الهيمنة الأجنبية، وهجمة تذويبنا حضاريا، لا سيّما وأنّ هذا وذاك يصيب جميع الأطراف بأخطاره، وهي الأخطار التي نساهم في مضاعفة تأثيرها وعواقبها المحتملة، بقدر ما نساهم نحن في تأخير اتخاذ خطوات عملية للتلاقي على أرضية مشتركة لمواجهتها بسلوك طريق التغيير الهادف للواقع الراهن.
ومن باب تأكيد إحدى البدهيات التي يفرضها مجرى الأحداث والتطوّرات يمكن التنويه دون التفصيل في هذا الموضع، أنّ سائر ما سبق لا يمثل دعوة موجّهة إلى التيّارات القائمة في بلادنا بصورة "منفصلة" عن الحكومات، إنّما هي الدعوة المفتوحة في سائر الاتجاهات، والتي ترى أنّ في مقدّمة ما يتوجّب على مَن يتحرّك على مستوى ما يوصف بالمعارضة في الوقت الحاضر، هو رفع شعار العمل على دعم الحكومات على طريق التخلّص من أثقال الهيمنة الخارجية، والتبعية الداخلية، والاستبداد بمختلف أشكاله، فجميع ذلك من الأخطار التي تهدّد وجودها أيضا، وكذلك رفع شعار التحرّك لتحقيق التلاقي بين الشعوب والأنظمة، بقدر ما تتجاوب تلك الأنظمة مع هذا التحرّك وقد بات مصيريا في رسم معالم مستقبل المنطقة وأهلها.
المصدر: http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.midadulqalam.info/midad/u...
