دور المسلمين في الحضارة الغربية
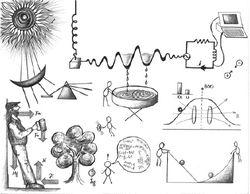
د/ راغب السرجاني
الإدارة العامة في الفكر الإسلامى:
الإدارة العامة هي تلك المعنية بإدارة شؤون الدولة، ويرى د. أحمد سلمان في ورقته التي قدم فيها مقارنة بين الفكر الغربي والفكر الإسلامي في الإدارة العامة - المؤتمر العربي الرابع، للمنظمة العربية للتنمية الإدارية والذي عقد بالقاهرة -، يرى أن الإدارة العامة الإسلامية محورها الأساسي العقيدة والإيمان، وبهما يتجاوز الفرد المسلم المنافع الشخصية والدنيوية إلى سعة التكليف الرباني الذي جعل الحياة كلها لله، وأن غاية خلق الإنسان هي العبادة والخلافة في الأرض تحقيقاً لقوله تعالى: "وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون (56) ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون (57)" (الذاريات ).
أما الفكر الغربي فإنه يعالج المشكلة الإدارية في إطار نظريات ذات نظرة تعتمد على المنافع الشخصية أو الجماعية، أو المنافع المشتركة في إطار العلاقات بين الدول دون أدنى نظرة للدين أو العقائد.
ومن خلال المقارنات نجد أن الإدارة العامة الإسلامية تتميز عن نظيرتها المعاصرة بثلاث خصال هي:
1- الإدارة العامة الإسلامية تسعى بصفة أساسية لخدمة الأهداف المشروعة من خلال أنشطتها الخدمية والسلعية المباحة، ويحكمها في ذلك الإيمان والعقيدة الربانية.
2 - يؤدي المكلف بالعمل في الإدارة الإسلامية واجبه على أساس أنه قيمة إيمانية يسعى من خلالها للعبادة.
3 - التعامل في الإدارة الإسلامية يتم على أساس الأخوة الإسلامية، والمساواة، واحترام إنسانية العامل، ونوع العمل الذي يؤديه. عبدالحافظ الصاوي موقع مجلة المجتمع
أهم الإنجازات ودور المسلمين في الحضارة الغربية:
ومن الضروري أن نعرف أنه من أهم الإنجازات التي أسهمت فيها الإدراة الإسلامية في العالم أجمع أنه لولا إدارة إسلامية قوية وحازمة لما استطاع أحد التقدم في المجالات الأخرى من فروع الحياة..
فمثلاً نجد أنه في خلال الفترة الذهبية في تاريخ الإسلام، أُنشِئَتِ المدارسُ في مختلف البلاد الإسلامية شرقاً وغرب، وكثُرَت المكتبات، وامتلأت بالمؤلفات في مختلف العلوم..
وفي التجارة كان المسلمون رواد العالم الحديث، فقد أنشأوا النقابات، وعرفوا نظام الحوالات، وخطابات الاعتماد ووثائق الشحن.
وهناك من العوامل التي جعلت المسلمين يُؤثِّرون في الأمم الأخرى، ويتركون بصماتهم واضحة: من ذلك المراكز الحضارية التي أقامها أو اتخذها المسلمون قواعد لنشر الإسلام والحضارة الإسلامية، فالمدينة المنورة كانت أولى تلك المراكز التي انتشرت منها حضارة الإسلام والمسلمين، ثم انتقل الثقل الحضاري بعد ذلك إلى دمشق ومنها إلى بغداد، وكان لقرطبة والقاهرة دورهما الكبير في نشر الحضارة الإسلامية في غرب الدولة الإسلامية.
كذلك كان لاهتمام الخلفاء وأولي الأمر -في الدولة الإسلامية- بالعلم والعلماء أثره البالغ في تشجيع العلماء، وتوفير المناخ الملائم للبحث والدراسة والتفرد والامتياز.
هذا بالإضافة إلى المناخ الحرِّ الذي أتاحه الإسلام للعلماء المسلمين، والإمكانيات التي وفرها الرخاء الذي تمتعت به الدولة الإسلامية، ونعم مواطنوها بالسلام والاستقرار.
كان لبغداد وما وصلت إليه من رخاء ورفاهية خاصة في العصر العباسي الأول دورها المهم في نشر الحضارة الإسلامية والفكر الإسلامي في بلاد المشرق.
فمن بغداد خرجت الوفود والرسل إلى أقاليم الشرق تحمل رسالة الإسلام إلى بلاط ملوك الشرق، كما تحمل أفكار وتعاليم الإسلام إلى أهل تلك المناطق.
وحين تمتعت الدولة الإسلامية بذلك المستوى الكبير من الرخاء والأمن استقرت نظمها وقوانينها متمثلة في الدواوين ومن أهمها ديوان البريد مما جعل الطرق آمن،ة والتجارة رائجة، والقوافل منساحة، والسفارات متتالية والأخبار، واصلة مما أشاع الأمن والطمأنينة في ربوعه.
واتضحت مظاهر الرفاهية في قيام الفنادق والبيمارستانات والمدارس والمراصد، واتسع نطاق الزراعة والصناعة وما ترتب على ذلك من تجارة ازدهر خلالها تبادل السلع والبضائع التي مرت إلى مختلف المناطق. ومن أشهر تلك السلع كان الحرير الذى قامت مصانعه في الموصل وحلب ودمشق، واستغل المسلمون ثروات بلادهم؛ فاستخرجوا المعادن كالحديد والرصاص والكبريت والملح وغيره.
كذلك استدعى الخلفاء العلماء من مختلف البلدان إلى بغداد، وليس من قبيل المبالغة القول بأن المسلمين قد توصلوا إلى درجة رفيعة من العلم والتقدم، فقد بلغ علم الفلك على سبيل المثال درجة عظيمة من التفوق، إذ استطاع علماؤه التوصل إلى نتائج سبقوا بها الشرق والغرب على السواء، ويمكن إيعاز ذلك إلى أن المسلمين بعد أن أتموا مهمتهم الأساسية في نشر الإسلام وإنجاز الفتوحات الإسلامية كانت المرحلة التالية هي مرحلة الاستقرار والبناء، وهنا تتاكد نظرية ابن خلدون في بناء الدولة، حيث يكون على الجيل الثانى ترسيخ دعائم تلك الدولة تمهيدا لقيام نهضة حضارية تميز تلك المرحلة.
كان للمسلمين منهج في إدارة البلاد المفتوحة وخاصة تلك البلاد التي شهدت قيام دول أول حضارات قديمة وكان ذلك ما فعلوه في بلاد فارس التي شهدت حضارة الساسانيين لفترة طويلة، كما شهدت نظما إدارية واقتصادية وعسكرية عريقة، وهنا نجد موقف الفاتحين من هذه الحضارة موقف المتعلم الذى يريد أن يفيد ممن سبقه؛ فاقتبسوا من حضارة الفرس ما وجدوه ملائما لقيمهم ومبادئهم، ومن ثم تأثروا بفنونهم وعمارتهم، لكن سرعان ما تأثر الفرس بما أبدع العرب بعد أن تمت عملية الصهر والاندماج الحضاري بين الحضارتين.
وكان أثر الحضارة الإسلامية كبيرا على بلاد الفرس، وخاصة فيما يتعلق بأمور الدين واللغة والعلوم.
أما بالنسبة لبلاد الهند فقد تقدم المسلمون إلى أراضيها حتى وصلوا إلى (كابل)، وأدى ملكها الجزية للعرب وذلك منذ عام 34 هـ / 664م، وتمكن للمسلمين الأمر في تلك البلاد حين فتح المسلمون مملكة السند في 93 هـ / 711 م، واستمرت صلات المسلمين بالهند والصين من خلال علماء المسلمين أمثال: البيروني حيث نقلت كثير من العلوم والمعارف إلى تلك المناطق، ومن الطريف الإشارة إلى أن الهندوس نقلوا بعض تلك الكتب نظمًا إلى السنسكريتية.
ويبدو أن ما اقتبسه الصينيون من العرب أهم مما فعل الهندوس فقد عرفوا رسالة الفلك لابن يونس وذاع صيته، كما دخل الطب العربي منذ القرن الثالث عشر إلى بلاد الصين.
المصدر: http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.qeyamhome.net/uploads/exp...
