الحوار: الغائب الأكبر بين ‘الفلاسفة’
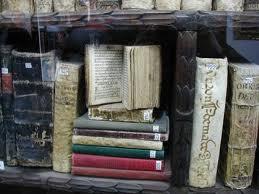
بقلم: أيت حمو محمد
لعل أقل ما يمكن أن يقال عن الفكر المغربي خصوصا، هو عدم قبوله للاختلاف والتغاير، واغتياله للحوار والنقد والمناظرة. فالحوار هو الحلقة الأضعف في سلسلة هذا الفكر المنغلق على نفسه. ولعل من بين أهم الانتقادات التي يمكن أن تقال عن مشروع ‘نقد العقل العربي’ لمحمد عابد الجابري، ما ورد على لسان بنسالم حميش عندما قال: ‘ما أقل حضور الفلسفة في كتاب كنقد العقل العربي
الذي يوزع التراث الإسلامي إلى أنظمة ثلاث (بيان/عرفان/برهان) ويتغيى مهمة تجريدها عن التاريخ، لإخضاعها للإبستيمولوجيا، حيث يقيم بينها مفاضلات عكاظية، غير مبررة ولا معقولة، ويشعل بين منشطيها نيران حرب مفهومية وهمية، مع ما تقتضيه فنون الحرب من هجمات ودفاعات، ومن ضربات قاضية أو تحالفات ومصالحات. فلو أن صاحب الكتاب أخذ بعين الجد مفهوم العقل الذي يرادف تاريخ الفلسفة كلها (بدل الاكتفاء بتعريفه في قاموس لالند وأقلمته في العنصر العربي)، ولو انه تمثل قول كانط ‘الأنا المفكر [والناقد] يلزم أن يصحب كل تصوراتي’، لكان ربما أحجم عن معالجة القضايا بالجملة، وعن التناول ‘الأعرابي’ للنقد والمفاهيم، وكذلك عن التهرب من اللغات (كأدوات عمل لا غنى عنها) ومن اللغة البيانية كوعاء ضروري لكل فكر فلسفي يتقصد الثقافة والتواصل’ .
وإذا كان محمد أركون لا يخفي مؤاخذته لهشام جعيط الذي لم يتقيد بتطبيق المنهج التاريخي بشكل صارم ، ناهيك عن محمد عابد الجابري الذي طالما أشار إليه بالبنان، فإنه لا يخفي إعجابه بتفرد المؤرخ المغربي عبد الله العروي في كتاباته، وخاصة مفهوم العقل الذي يقع جملة وتفصيلا خارج هذا النقد، لدرجة حدت بالأستاذ محمد أركون إلى الحديث صراحة عن الاتفاق بينه وبين عبد الله العروي الذي سلك مسلك محمد أركون في نقد العقل الإسلامي، بيد أن عبد الله العروي الذي لم يفعل سوى ما سبق أن فعله محمد أركون لا يشير من قريب أو بعيد إلى مواطن الاختلاف مع زميله محمد عابد الجابري في مشروعه الكبير ‘نقد العقل العربي’. ‘على العكس من ذلك أشعر بالسعادة إذ أجد في عبد الله العروي رفيق درب، وبخاصة في كتابه الأخير مفهوم العقل. ففيه يقدم أمثلة توضيحية عديدة وموثقة جيدا على بعض المهام التي كنت قد ركزت عليها في كتابي نقد العقل الإسلامي الصادر عام 1984. بعد أن اطلعت على كتابه وجدت أن نقاط الاتفاق بيننا في ما يخص التوجهات الأساسية في النقد عديدة جدا إلى درجة أني دهشت لأنه لم يشر إلى أي كتاب من كتبي، أو إلى أي فكرة من أفكاري. أقول ذلك وبخاصة أنه يتعرض في كتابه السابق الذكر للعديد من الموضوعات والمؤلفين (أو المفكرين) والمناقشات المنهجية والإبستمولوجية التي كانت قد شغلتني طويلا في الماضي. كذلك الأمر فإن العروي لا يشير من قريب أو بعيد إلى أعمال زميله في الجامعة محمد عابد الجابري. أقول ذلك خاصة وأن أعماله في ‘نقد العقل العربي’ معروفة ومشهورة. كان بإمكانه أن يذكره على الأقل لكي يبين أوجه الاختلاف معه في الأسلوب وطريقة المعالجة للموضوعات المطروحة. فهذه الاختلافات تساعدنا على رسم خريطة تصنيفية لأنماط المثقفين المغاربة المعاصرين’ .
إن عدم إشارة عبد الله العروي إلى محمد أركون، وعدم ذكره صراحة أو ضمنا لاسم محمد عابد الجابري، يقودنا حتما إلى الحديث عن قضية خطيرة في الفكر العربي المعاصر عموما والفكر المغربي خصوصا، ونعني بها قضية الحوار الغائب الأكبر بين المثقفين المغاربة والعرب. ‘والحال أن مفارقاتنا الأليمة كثيرة، وأن أشدها مضاضة يقوم في كوننا نكتب كتبا لا وجود لها، أي لا تأثير ولا إشعاع. وكيف لها أن توجد والثقافة الرابطة بيننا هي ثقافة اللاحوار، بل وحتى اللاقراءة، بمعنى أن لا أحد يقرا لأحد، وبالتالي لا أحد يحاور غيره على ضوء ما قرأ له. وقد لا يفلت من هذا الغبن إلا من فرضته المطرقة الإعلامية فرضا، أو أتى إلينا من خارج الأسوار، أو عبر قنوات حازمة كاسحة. هكذا يبدو وضعنا، وكل بما لديه فرح مغتبط، يدفع به باسم ‘البرهانية’ و ‘العلم’ إلى حلقات الدوغمائية المتشنجة والأنانية المنغلقة، وكل بما ليس لديه غفل عنه سواه، يصرف الأيام كما شاء لها الدهر، متوقيا قلق المواجهة والشك والسؤال’ . وكأني بالعديد من الكتابات منزهة عن الانتقادات، ‘مع أن أنفع خدمة ـ من الوجهة الفلسفية ـ يمكن لمفكر أن يؤديها لمفكر آخر هي أن يوقظه من سباته الدوغمائي. وكان هذا، كما نعلم، فضل ارتيابية د.هيوم على إ.كانط ، باعتراف هذا الأخير’ .
ويمكن القول بأن غياب المصالحة والتواصل بين المفكرين العرب المعاصرين أصبح ظاهرة ملفتة للنظر وقضية مؤسفة. ‘إذ لا يجد القارئ للمشاريع النقدية في الفكر المعاصر أي تجاوب أو تعاون مثلا بين أركون والجابري، أو بين الجابري وطه عبد الرحمان، أو بين طه عبد الرحمان وهشام جعيط، أو بين هشام جعيط وبرهان غليون…إلخ وهو تسرب خطير للبنية الميتافيزيقية داخل أذهان مفكرينا المستنيرين’ . ولذلك أصبحنا أمام المشاريع النقدية الفردية التي يعرض فيها المفكر الواحد عن تجارب معاصريه من بني جلدته بدل المشاريع النقدية الجماعية التي يلتفت فيها المفكر الواحد إلى تجارب معاصريه. ‘فالواحد من أهل الفكر المغاربة لا يحاور غيره، فهو إما يعتزل في برجه العاجي، ظانا أن قوله هو القول الفصل في كل شيء، وإما يعتمد الشذوذ في أقواله، مطبقا للقاعدة السارية: ‘خالف تعرف’، وإما أنه إذا اعترض على غيره أبهم اسمه وأخفى عنوانه كما لو أن التصريح بالاسم أو ذكر العنوان تنقيص من منزلة، وإما أنه إذا اعترض عليه غيره، أعرض عن الجواب وحث أصحابه على الإعراض كما لو أن في الرد على الاعتراض قدحا في علمه’ . ويواصل طه عبد الرحمان كلامه في موضع أخر: ‘والتيه الفكري الذي أصابنا ينطق به حال الشتات الذي يوجد فيه أهل الفكر بين أظهرنا، وهذا الشتات ألوان شتى: شتات في المكان، فلا رواق يظلهم ولا مجلس يضمهم ولا ملتقى يشملهم، وشتات في الزمان، فلا حضور في عالم القرار لأفكارهم، ولا أثر في أفق المستقبل لمواقفهم، ولا تحاور بين أفراد الجيل الواحد منهم، ولا تخاطب بين مختلف أجيالهم، وشتات في الأفكار وهو أسوأ ألوان الشتات. فهذا واقع تحت طائلة التقليد، داعيا إلى الترديد والانكماش، وذاك واقع تحت طائلة التنميط، داعيا إلى التكيف والاندماج، وهذا يتشبث بكل قديم خوفا على فقدان الهوية، وذاك يتقلب مع كل جديد، طمعا في التحقق بالغيرية، وهذا كل يوم في إشكال، فتارة يندمج وتارة ينكمش وتارة بين بين، وذاك لا في إشكال، يفكر لساعته لا يعدوها، لكن على تباينهم، درج كل واحد منهم على أن يفكر مزكيا لنفسه، وهيهات أن يفكر معترضا عليها ! والحق أنه لو اشتغل بالاعتراض على نفسه لأدرك أنه في تيه عظيم’ .
ومهما كانت الأسباب التي تقف وراء غياب هذا الحوار الذي يجعل هؤلاء الباحثين يقعون في ما يسميه محمد أركون بـ ‘الانغلاق السكولاستيكي’، فإن غياب هذا الحوار يشكل في حد ذاته خسارة ثقافية وخطأ علميا فادحا لا يخلو من عواقب وخيمة ! ‘ولكن للأسف فإن المثقفين العرب (والمغاربة بشكل خاص) لا يستشهدون ببعضهم البعض، إنهم يأنفون من ذكر أسماء بعضهم بعضا، ربما كانوا يخشون من إغضاب البعض إذا ذكروا البعض الآخر وأهملوه. وربما كانوا يريدون مراعاة الحساسيات. وهذا شيء وارد في الأوساط الثقافية والجامعية. إنهم يريدون تحاشي المعارك الجدالية إذا ما ذكروا اسم هذا المثقف وأهملوا ذكر المثقف الآخر. كل ذلك قد يجوز، ولكن هذا الانغلاق السكولاستيكي داخل الذات يكلف ثمنا باهظا على صعيد الحياة الثقافية والمناقشة العلمية في المجتمعات العربية بشكل عام. إني آسف لأن الوقت كان دائما ينقصني فلا أستطيع تحقيق تلك الأمنية القديمة التي كانت دائما تراودني، ففي كل مرة كان يصدر فيها كتاب مهم لأحد هؤلاء المثقفين كنت أتمنى أن أقطع الصمت وأكتب عنه مراجعة نقدية شمولية. كنت أتمنى لو أن الوقت يساعدني لكي أعلق بشكل مطول على أعمال خمسة من المفكرين المغاربة: محمد طالبي، هشام جعيط، محمد عابد الجابري، محمد قبلي، عبد الله العروي. في الواقع إننا جميعا ننتمي إلى الجيل نفسه، كما أننا جميعا مدينون للجامعة الفرنسية بتكويننا العلمي ومواقعنا الإبستمولوجية المختلفة والمتشابهة في آن معا. يضاف إلى ذلك أننا نشعر بالتضامن التاريخي مع الفضاء المغاربي الكبير الذي ولدنا فيه والذي هو في حالة بحث عن الهوية. إن مساهماتنا تتلاقى حول عدد كبير من المواقع النقدية، ولكنها تختلف في ما يخص طريقة المعالجة واستراتيجيات التدخل العلمي والراديكالية الإبستمولوجية. في ما يخص النقطة الأخيرة يمكن القول بأني كنت دائما ألح أكثر من عبد الله العروي على النقطتين الأساسيتين التاليتين: الدور التاريخي لما كنت قد دعوته بجدلية القوى المركزية / والأطراف الهامشية وبخاصة في المغرب الكبير، ثم الانعكاسات الثقافية والمعرفية المترتبة على ذلك. وأما النقطة الأساسية الثانية فتخص ما يلي: دور مختلف المدونات الرسمية المغلقة (أو النصوص الرسمية المغلقة)، وأولها القرآن نفسه، في التشكيل التاريخي والوظائف الدائمة لما كنت قد دعوته بالسياج الدوغمائي المغلق. ولكن على الرغم من ذلك فإني أود أن أثني على مجمل أعماله وبخاصة كتابه الأخير الذي ذكرته آنفا. فأعماله تتميز، في رأيي، بالنظرة النقدية المتواصلة في الزمن، والمتماسكة في التطبيق، والمرنة في إستراتيجيتها التدخلية، والصارمة تجاه كل أنواع الترقيع العلمي أو الخطابات التبجيلية والإيديولوجية. إن العروي ما انفك يدين بكل حزم وبدون أي تهاون تلك الاستخدامات التبجيلية للتراث، تلك الاستخدامات البالية التي عفا عليها الزمن. إنه ماانفك يذكر العقل الإسلامي بأنه لن يستطيع التحرر من التركيبات الأسطورية والاجترارات السكولاستيكية إلا إذا استخدم كل الأدوات والمكتسبات المنهجية الخاصة بالنقد التاريخي الحديث. وماانفك أيضا يكشف عن عدم التطابق الفكري والتفاوت التاريخي والمجربات البالية للموقف الإصلاحي كما يتجلى لدى محمد عبده وابن خلدون. هذه هي الدروس التي يركز عليها العروي دون كلل أو ملل مثلي أنا. إنه ما انفك يعود إليها أو عليها منذ حوالي ثلاثين سنة بكل صبره التربوي. ونأمل أن تؤتي هذه المحاولات ثمارها الطيبة في نهاية المطاف. فقد طال انتظارنا’ .
وقد لا حظ محمد ألوزاد بدوره ما تحدث عنه محمد أركون في النصين السابقين من عدم إشارة الأساتذة الجامعيين المشتغلين بالفلسفة إلى بعضهم البعض، محملا المسؤولية في ظاهرة حوار الصم المنتشرة بينهم إلى النظام الجامعي المغربي الذي ينبغي تصحيحه وتعديله حتى تنشأ ثقافة الاعتراف والحوار، وتصبح الخلافات إيجابية وليست سلبية. ‘أما فيما يتعلق بهذا النمط من حوار الصم المنتشر بين الممارسين للفلسفة وغير الفلسفة، فأعتقد أنه يرجع إلى ظاهرة كان يعرفها المغرب قديما في مدارسه العتيقة، وكان يعرفها علماؤه القدامى، أعني ظاهرة التنافس غير الإيجابي. وأذكر هنا على سبيل المثال أن أساتذة الجامعة قل أن يشيروا إلى كتاب لزميل لهم، وأعرف حالات كانت فيها الاستفادة قائمة والإشارة منعدمة ! وهذه كلها أوضاع تنافس غير سليم في الجامعات، أعتقد أن حلها يكمن في تصحيح النظام الجامعي المغربي وإخراجه من الطريق التقليدي. أعني أن يمنح الأستاذ الجامعي صاحب الكرسي فريقا للعمل يعمل معه، يوجهه في أبحاثه، وينسق مسألة التضامن العلمي، ويخلق هذه الروح الجمعية منذ بدايات السلك الثالث. فالشعور الذي يظل في النفوس ويكرس هذا التنافس غير المحدود، هو أن كل شخص يظن أنه خطط لنفسه وحده، وأن لا فضل لأحد عليه، ومن ثم، فإنه يتوهم نفسه دائما على حق وأن الآخرين على باطل…هذه الأمور يجب أن تتغير بتغيير نظام التعليم، وإلا، فمن الطبيعي أن تحدث في الجامعات ظواهر سلبية من هذا القبيل. أما الخلاف في المواقف والنقد المتبادل، هادئا أو عنيفا، فكله أمر محمود. فالجامعة ما كانت إلا مكانا للخلافات المذهبية وللخلافات في وجهات النظر. ولو توفرت الشروط الصحية لكانت هذه الخلافات إيجابية ولأنتجت مدارس وأعمالا ترقى إلى مستوى مشرف’ . وقد وجدها محمد ألوزاد فرصة سانحة لتبرئة طه عبد الرحمان ـ وهو من فرسان الحوار وأرباب التناظر ـ عن مزاعم خصومه. ‘فطه عبد الرحمان إنما يخالف في مصادر أو منابع التفكير الفلسفي، ولكنه يسلم بالتفكير الفلسفي وبوجاهته وأهميته، وهذا شيء لا يجب إنكاره’ .
فقد أصبح المثقف المغربي خصوصا، والمثقف العربي عموما، في جزيرة دونها جزيرة حي بن يقظان، يفكر لنفسه ولوحده وبمعزل عن زملائه في الصناعة والتخصص! يتضايق من الحوار ولا يقبل النقد، بشهادة أحدهم، وهو من أهل الدار. ‘لقد أطلعتني تجربتي في هذا الميدان عن واقع مؤلم مرير، مفاده أن أغلب مثقفينا، وحتى البارزين منهم، تربطهم ببضائعهم الثقافية علاقة الكينونة وليس علاقة العندية. ومعناه كما لو أن الناطق باسمهم يقول: إني هذا الكتاب، أو يقصد هذه العروة حتى يقول: لي كتاب. وهذه’ الإنية’
تبلغ عند الكثير حد والغلو مما قد لا نجده إلا في حالة الأمومة، أو في علاقة البدوي بنعجه وقطيعه. لهذا فإياك أن تظهر في كتابات هذا أو ذاك ما تراه منطقيا أو فكريا، أو حتى ذوقيا من قبيل المتناقضات والثغرات أو الحلقات الضعيفة والمهزوزة، إياك أن تمارس حقك في نقدها في إطار ما يسميه الجميع حرية التعبير. أما إن تجرأت وفعلت، فأنت بين خيارات ثلاثة: الأول أن تثني على البضاعة وتحصي محاسنها إلى حد يهمش ذكرك لعيوبها، والثاني أن تبرز الإيجابيات بلسان صريح طليق، وترمز إلى السلبيات بلسان خشبي أو دبلوماسي رقيق، وذلك حفاظا على طيبوبة’ العلاقات’، أما الخيار الثالث فأن تقول جهرا ما يمليه عليك ضميرك وفكرك في شأن البضاعة، ولو أدى ذلك إلى جني خصومات وعداوات قد تصل بمعلنيها على سن القطيعة…وكل هذه المعطيات المزاجية والمناخية تدل على أمرين سلبيين في بيئتنا الثقافية: من جهة، عجز المثقف عموما عن أخذ البعد الضروري إزاء منتوجه وحتى ذاته، وبالتالي عن ممارسة النقد الذاتي الذي بدونه لا تطور في المسار، ولا سيادة إلا للنرجسية الرعناء وذكر الأنا صباح مساء، ومن جهة أخرى تدني التربية الديمقراطية الذي يجعل كل ممارسة حرة للرأي والنقد تنعكس سلبا على العلاقات الإنسانية، وتظهر ضعف قبول الاختلاف والتغاير’ .
ويحضرني هنا ما يسميه علي حرب بـ’حروب الإلغاء الرمزية على الساحات الثقافية’ تارة، و’النرجسية لدى المثقفين’ مرة، حيث يقول عن هذه الأخيرة: ‘كفى المثقفين مزاولة مهمتهم المزيفة بممارسة وصايتهم الخلقية أو السياسية على الحقيقة والحرية والعدالة، لكي تترجم على يدهم كوارث أو فضائع تعود معها الأوضاع المراد تغييرها إلى الأسوأ. أليس على هذا النحو ترجمت شعارات الوحدة والحرية والاشتراكية والعلمانية والعقلانية؟!’ . ولا يخفى على الفطن الأريب أن علي حرب يلتقط في هذا النص ذبذبات بعض الفلاسفة الغربيين، مثل جان بول سارتر وميشيل فوكو، وغيرهم من الفلاسفة الذين حكموا بالانتهاء والاختفاء على المثقف الذي يفكر بالنيابة عن الآخرين ومن أجلهم. وفي هذا المعنى أيضا يقول محمد ألوزاد: ‘أعتقد أن الوقت قد حان للباحثين في الجامعات المغربية أن بتخلصوا تماما من فكرة ‘المثقف/النبي. يجب أن تنتهي هذه الأطروحة التي تعود إلى زمن النضال منذ قرن على الخصوص، بين الحربين العالميتين الأولى والثانية. هذه الأشياء قد أصبحت الآن متجاوزة كثيرا. فاليوم أصبحنا نتحدث عن المثقف/الخبير، المثقف/المتخصص، المثقف المتواضع الذي يدرك حدود عمله ويعرف أين يجب أن يقف’ .
من خلال كل ما ذكرنا من مواقف ومجالات، يتبين لنا بأن الفلسفة الإسلامية قد لا تكون أفضل أجناس القول تأسيسا للحوار والاختلاف في الإسلام بسب ادعاء الفلاسفة امتلاك الحقيقة اليقينية البرهانية التي لا شكوك عليها ولا ارتياب. وهذا الادعاء البرهاني هو الذي يرخي بسدوله وينيخ بكلكله على المفكرين العرب المعاصرين الذين جعلوا من الفلسفة الأسرة الفكرية التي ينتمون إليها وينتسبون لها، فتحولوا إلى أرخبيل من جزر متفرقة ومبعثرة لا يتحاورون ولا يقرأ بعضهم لبعض لدرجة لا يجد كل واحد منهم غضاضة أن يغني على ليلاه، وحرجا أن يفرح بما لديه. وهكذا بقي الفيلسوف أو المفكر المغربي المعاصر الممارس للفلسفة منزويا حتى عن زملائه في المهنة والتخصص ! وهذه ظاهرة سلبية تنذر بالتشتت في المجال الفكري ولا تبشر بالتراكم، وتوحي بالانغلاق والتقوقع ولا تشي بالانفتاح والتناظر.
فهل يعقل أن يكتب المؤرخ المغربي عبد الله العروي مفهوم العقل ولا ينبس ببنت شفة عن مشروع نقد العقل العربي للفيلسوف المغربي محمد عابد الجابري!
وهل يعقل أن يكتب الباحث المغربي علي أومليل السلطة الثقافية والسلطة السياسية ولا ينبس ببنت شفة عن كتاب المثقفون في الحضارة العربية الإسلامية للفيلسوف المغربي محمد عابد الجابري رغم أن كتاب الأستاذ على أومليل من ألفه إلى يائه ردود على كتاب الأستاذ محمد عابد الجابري!
وهل يعقل أن نتحدث عن الحوار مع الآخر المغاير الأمريكي والغربي المشكل بمعيتنا للأسرة الممتدة في الوقت الذي لا نؤثث فيه بيتنا ونتحاور حتى مع الآخر المخالف في أسرتنا النووية!
وهل يعقل أن يكتب المفكر المغربي، وكأنه لا ينزلق ولايخطئ، بينما ‘أن يخطئ الإنسان تلك هي فدية الفكر’ ‘ se tromper est la ran’on de penser ‘، كما يقول الكاتب الفرنسي الشهير Alain.
وهل يعقل أن يغني كل مفكر على ليلاه ويبقى فارسا وحيدا بينما يرفض النزال عندما يجتمع الفرسان!
وهل يعقل أن يخصي كل مفكر مغربي كل شيء تقريبا ليكون هو الفحل الوحيد!
أما محمد أركون الذي دمغ الجابري بالعنصرية وأكثر في بعض مؤلفاته ، ويكاد أن يتهم عبد الله العروي بالسرقة منه في إحدى نصوصه التي أوردناها سابقا، بالنظر إلى الاتفاق الكبير بينهما، فلا يجد سوى هذا الوقت الضئيل للسب والشتم واتهام الآخرين. أما وقت النقاش والتحاور والتحليل الأكاديمي الرصين، فلا وجود له عند محمد أركون. فوقته أثمن من التعليق والتحاور مع زملائه (محمد طالبي، هشام جعيط، محمد عابد الجابري، محمد قبلي، عبد الله العروي)! وهكذا يضرب محمد أركون رفاقه فيبكي، ويسبقهم فيشكي، ويطالبهم بقراءته والكتابة عنه وتأييد اجتهاده، وهو ما لا يفعله أركون بكتابات هؤلاء الذين قال عنهم بأن وقته لا يسمح له، فهو بمفرداته الواردة في بعض نصوصه السابقة ‘آسف’ و’الوقت كان دائما ينقصه’ وكان ‘يتمنى أن يقطع الصمت ويكتب عنهم’ و’كان يتمنى لو أن الوقت يساعده لكي يعلق بشكل مطول عليهم’…إلخ. وبعد كل ما سبق كيف يلوم أركون هؤلاء، إذ ‘يجد عددا من زملائه المثقفين يتجاهلون ما يصدر وينشر ويضربون صفحا عما قرأوا أو قرروا ألا يقرأوا، ولا يشيرون مرة واحدة لا بالقبول ولا بالرفض إلى اجتهاد يستحق الذكر والتأييد’ .
أسئلة ذات طابع استنكاري نروم من خلال طرحها التحذير من ثقافة الغرور والأنانية أو اللااعتراف التي تكتم أنفاس المفكرين المستنيرين العرب المعاصرين المتخصصين في الفلسفة، وهي الثقافة التي دعاها بنسالم حميش بثقافة اللاحوار واللاقراءة في إحدى نصوصه التي استشهدنا بها في هذا العرض.
إن المفكر الحقيقي هو الذي يشيع روح التفكير والنقد والتراكم المعرفي الذي يؤدي إلى قفزات كيفية ولا يحنط النصوص ويجمدها، بل يصغي لنبض الحياة الصاخبة فيها كحوار متجدد ودائم بين العظماء عبر المسافات المقفرة من اللاحوار.
قائمة المصادر والمراجع
ـ بنسالم حميش، ‘تأملات في ممارسة الفلسفة بالمغرب’، ندوة الفكر الفلسفي بالمغرب المعاصر، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، سلسلة ندوات ومناظرات رقم 23، جامعة محمد الخامس، المملكة المغربية1993، ص. 67
2 ـ محمد أركون، قضايا في نقد العقل الديني: كيف نفهم الإسلام اليوم؟ ترجمة وتعليق هاشم صالح، دار الطليعة، بيروت، الطبعة الأولى 1998، ص. 55
3 ـ محمد أركون، قضايا في نقد العقل الديني: كيف نفهم الإسلام اليوم؟، سبق ذكره، ص. 55- 56.
4 ـ بنسالم حميش، ‘تأملات في ممارسة الفلسفة بالمغرب’، سبق ذكره، ص. 65
5 ـ المرجع نفسه، ص. 66
6 ـ مختار الفجاري، نقد العقل الإسلامي عند محمد أركون، دار الطليعة للطباعة والنشر ـ بيروت، الطبعة الأولى، آيار (مايو) 2005، سبق ذكره، ص. 8
7ـ . طه عبد الرحمن، حوارات من أجل المستقبل، منشورات الزمن، العدد13، أبريل2000، ص. 6.
8 طه عبد الرحمن، ‘الكلمة السواء’، جريدة أوار، العدد 2 ، غشت 2002، ص. 112
9 ـ بنسالم حميش، ‘تأملات في ممارسة الفلسفة بالمغرب’، سبق ذكره، ص. 56-57
10 ـ محمد الوزاد، ‘حوار مع الدكتور محمد ألوزاد’، مجلة مدارات فلسفية، العدد 14، صيف 2006، دار أبي رقراق للطباعة والنشر، ص. 34 ـ 35
11 ـ المرجع نفسه، ص. 35
12 ـ بنسالم حميش، ‘عن الكتابة والسلطة والتاريخ: حوار مع بنسالم حميش’، مجلة مقدمات، ملف رقم 2، طبع: النجاح الجديدة، الدار البيضاء 2001، ص. 58 ـ 59.
13 ـ علي حرب، ‘حوار الثقافات والخروج من المأزق: تمرس في سياسة معرفية جديدة’، مجلة المنطلق الجديد، العدد الثالث، صيف، خريف2001، ص. 113.
14 ـ محمد ألوزاد، ‘حوار مع الدكتور محمد ألوزاد’، سبق ذكره، ص. 29
15ـ أ نظر: محمد أركون، أين هو الفكر الإسلامي المعاصر ؟ ترجمة وتعليق هاشم صالح، الطبعة الثالثة، 2006، دار الساقي، ص .XIV .
16 ـ المرجع نفسه، ص . XIII
