حضور الثقافة العربية في المهاجر الشرقية والغربية
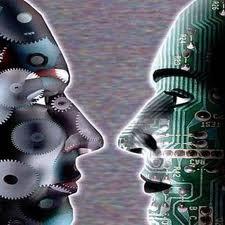
مسعود ضاهر
|
من الصعب جدا فصل الدراسات العربية في اليابان عن الدراسات الإسلامية والدراسات الشرق أوسطية. علما أن الدراسات العلمية في هذا المجال حديثة العهد ولا ترقى إلى أبعد من نهاية الحرب العالمية الثانية. هناك أسباب كثيرة كانت وراء دمج تاريخ العرب بتاريخ الشرق الأوسط، والثقافة العربية بالثقافة الإسلامية أو الشرق أوسطية. فالبعد الجغرافي قبل بزوغ فجر الاتصالات الحديثة، البحرية منها والجوية، شكل عائقا كبيرا أمام التواصل الانساني وتطوير العلاقات الاقتصادية بين العرب واليابانيين. فلم تتطور تلك العلاقات بصورة مكثفة إلا بعد اكتشاف النفط وحاجة الاقتصاد الياباني إليه بصورة متزايدة، ما ساعد على توليد المعجزة الاقتصادية اليابانية في ستينيات القرن العشرين والتي تعرضت لأزمة حادة بسبب حظر النفط العربي عام 1973. عالجت هذه الدراسة نماذج ثقافية لأبحاث يابانية متنوعة ذات أبعاد عربية واضحة. وركزت بشكل خاص على بدايات الاهتمام الياباني المبكر بالتاريخ العربي وبالثقافة العربية. فقد حاولت الإمبريالية اليابانية توظيف الإسلام لخدمة مخططاتها العسكرية ونزعتها التوسعية في بلدان آسيوية تضم مجموعات إسلامية كبيرة. فأنشأت مراكز عدة لدراسة الإسلام مع نشر الدعوة إلى تعاون ياباني – إسلامي في مواجهة الاستعمار الأوربي والأمريكي في دول جنوب وشرق آسيا. لكن تلك المراكز أقفلت جميعها بعد هزيمة اليابان في الحرب العالمية الثانية ووضعها تحت المظلة الأمريكية كدولة منزوعة السلاح ومحرومة من التسلح. قبلت اليابان تحدي الحظر الأمريكي فحولت الدراسات العربية والإسلامية والشرق أوسطية فيها إلى دراسات علمية كتبت غالبيتها في النصف الثاني من القرن العشرين.وتحرر الباحثون اليابانيون من التوجهات الاستعمارية السابقة وبات هاجسهم تحويل المراكز التي تعنى بالدراسات العربية في اليابان إلى مراكز علمية للتفاعل الإيجابي والمباشر مع المثقفين العرب ومع الثقافة العربية بأبعادها التاريخية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والتربوية، والأكاديمية، والفلسفية، والأدبية، والفنية وغيرها. ونجحت تلك المراكز في توليد أجيال متعاقبة من الباحثين اليابانيين المهتمين بدراسة الثقافة العربية عبر دوائرها الثلاث: الثقافات والنظم الاسلامية، والثقافات الشرق أوسطية، والثقافات المتوسطية.واهتم باحثون يابانيون بالثقافة العربية بصفتها مسألة بحثية مستقلة بذاتها. قدمت الدراسة تحليلا معمقا لأربعة نماذج يابانية بارزة أثارت نقاشات مهمة في اليابان، ومنها ما أثار بعض الاهتمام في العالم العربي. وساهمت تلك النقاشات في تعريف اليابانيين بتاريخ العرب، وتراثهم، وثقافتهم، وفنونهم، وآدابهم، وبقضايا التحرر الوطني والاجتماعي في العالم العربي وخاصة قضية فلسطين، وبقضايا التنمية البشرية والاقتصادية المستدامة في الدول العربية. وتمثل النماذج المختارة مناهج معرفية متنوعة لعبت دورا ملحوظا في تطوير وعي اليابانيين بأبرز القضايا العربية المعاصرة، ومنها قضايا نظرية ذات طابع سجالي حول مناهج التاريخ العربي، وملفات توثيقية تضمنتها مجلة «العرب» في اليابان، وسجالات أدبية معمقة أطلقها كتاب نوبوإيكي نوتاهارا «العرب، وجهة نظر يابانية»، ودراسات يابانية في الأنطروبولوجيا الثقافية عن مصر والعالم العربي. في كتابه «إساءة فهم الإسلام» الصادر باليابانية عام 1983، أشار الأستاذ المتميز يوزو إيتاغاكي Itagaki Yuzo إلى أن بداية تعرف اليابانيين إلى القضايا العربية تعود إلى العام 1884 حين زار جو نيجيما Niijima Jo جزيرة سيلان واجتمع بأحمد عرابي، القائد المصري المنفي إليها. وفي عام 1886 زار تاتيكي تاني Tani Tateki، وزير الزراعة في حكومة الإمبراطور مايجي مصر ومن بعدها سيلان للتعرف عن كثب إلى أحوال المجتمع المصري الأسباب الحقيقية لثورة أحمد عرابي. وكانت أبرز ثمارها العلمية أن سكرتيره سانشي توكاي Tokai Sanshi نشر رواية بعنوان: «كاجينو كيغوو» Kajinno Kiguu، وكان بطلها الرئيسي أحمد عرابي. في السنوات التالية زار عرابي في منفاه أكثر من مسئول ياباني، منهم ضابط الجمارك سائيجي نومورا Nomura Saiji الذي زاره عام 1888 في طريق عودته من أوربا. في عام 1889 نشر توكاي كتابا بعنوان «بدايات تاريخ مصر الحديث »، فكان باكورة انطباعات شخصية قدمت إلى اليابانيين عن تاريخ أول دولة عربية. ثم تلاحقت الدراسات الانطباعية لدى اليابانيين عن دول عربية أخرى. ففي العام 1912 نشر كوتارو ياماؤكا Yamaoka Kotaro ذكريات رحلته للحج إلى مكة المكرمة وكانت بعنوان «ذكريات حاج إلى حدود العالم العربي». وفي العام 1922 زار الجغرافي الياباني شيغا شيغيتاكا Shiga Shigetaka سلطنة عمان.وبصفته رجل دولة يابانياً قابل السلطان تيمور بن فيصل بن سعيد في قصره بمسقط. ومنها عبر مناطق الجزيرة العربية إلى العراق ثم فلسطين.ونشر في العام 1926 كتابا تضمن ذكرياته عن تلك الرحلة تحت عنوان «بلدان مجهولة». عندما زار الحاج ياماؤكا مكة كان برفقة الداعية الإسلامي عبـــد الــرشــيد إبراهيم التتري.ثم زار عبد الرشيد لاحقا اليابان لمدة سبعة أشهر في أواخر 1908 ومطالع 1909. وعاد إليها مجددا في العام 1933، وبقي فيها لسنوات طويلة، إلى أن أصبح إماما لمسجد طوكيو الذي أنجز بناؤه في العام 1938. وتعلم اللغة العربية على يديه الأستاذ توشيهيكو إيزوتسو Izutsu Toshihiko، الذي أصبح واحدا من أبرز الباحثيين اليابانيين في الدراسات الإسلامية. إيزوتسو رائد الدراسات الاسلامية المعمقة في اليابان تميزت اعماله بكثير من الدقة والموضوعية.درس في جامعتي كيو، وطوكيو.مارس التدريس في جامعات يابانية وكندية وإيرانية.كتب دراساته باليابانية والإنجليزية، وكان على معرفة بالعربية، والفرنسية والألمانية. في سنة 1957 ترجم القرآن الكريم من العربية مباشرة إلى اللغة اليابانية، فتميزت ترجمته عن باقي الترجمات التي اعتمدت لغات أخرى غير العربية إلى اليابانية. نشر باللغة الإنجليزية دراسات عدة أبرزها «بنية المصطلحات الأخلاقية في القرآن»، و«مفهوم الإيمان في الدين الإسلامي»، و«المفاهيم الأخلاقية الدينية في القرآن»، و«دراسة مقارنة للمفاهيم الفلسفية المفتاحية في الصوفية والطاوية».هذا بالإضافة إلى دراساته العلمية الكثيرة المنشورة باللغة اليابانية. وأصدر إيزوتسو كتابه «الله والإنسان في القرآن»، للمرأة الأولى بالإنجليزية عام 1964 بطوكيو، عن معهد جامعة كيو Keio للدراسات الثقافية واللغوية.وبعد تسع سنوات على وفاته عام 1993، صدرت طبعته الثانية بالإنجليزية أيضا في ماليزيا عام 2002. وهي الطبعة التي اعتمدت لترجمة الكتاب إلى العربية مع مراجعة مهمة للباحث الإسلامي فضل الرحمن، كانت قد نشرت في عدد يونيو للعام 1966 في مجلة «دراسات إسلامية» في إسلام أباد. صدرت الترجمة العربية بعنوان: «الله والإنسان في القرآن، علم دلالة الرؤية القرآنية للعالم»، عن منشورات المنظمة العربية للترجمة، بيروت 2007. وتضمن الموضوعات التالية: علم الدلالة في القرآن، المصطلحات المفتاحية القرآنية في التاريخ، البنية الأساسية للرؤية القرآنية للعالم، مفهوم «الله» لدى الوثنيين واليهود والمسيحيين والحنفاء، العلاقة الوجودية بين الله والإنسان، العلاقة التواصلية بين الله والإنسان، الجاهلية والإسلام، العلاقة الأخلاقية بين الله والإسلام.وضمت مكتبة البحث مصادر عربية من الدرجة الأولى دلت على سعة اطلاع المؤلف بالدراسات العربية والإسلامية في تلك الفترة. بالإضافة إلى مصادر ومراجع باللغات الإنجليزية والفرنسية والألمانية واليابانية.وقد وصف فضل الرحمن جهد المؤلف إيزوتسو بقوله: «لا يمثل هذا الكتاب إضافة سارة إلى الأدبيات الموجودة عن الإسلام فقط، بل يقدم مقاربة جديدة لفهم الإسلام، وخاصة من قبل غير المسلمين، وهي المقاربة العلم – لغوية». كان إيزوتسو متعمقا بالدراسات الإسلامية من مختلف جوانبها. وكان لديه تقدير خاص لدى الباحثين اليابانيين الذين اعتبروا دراساته عن الإسلام ركيزة صلبة لولادة تيار من الباحثين المهتمين بالدراسات العربية والإسلامية في اليابان في النصف الثاني من القرن العشرين. تتلمذ على يديه جيل كامل من الذين تخصصوا في حقول معينة في تراث وآداب وتاريخ الشعوب العربية والإسلامية. وعالج موضوعات التراث العربي والإسلامي بكثير من الدقة والموضوعية وخاصة في تناوله لقضايا دينية ذات طابع خلافي بين علماء المسلمين من جهة، وبين الباحثين في التاريخ الديني من جهة أخرى. لكن معرفة إيزوتسو بالثقافات الآسيوية سهلت عليه سبل إكتساب معرفة عميقة بالثقافة العربية الإسلامية. وكانت لديه خبرة واسعة بعلم الدلالة الأوربي الذي شكل ركيزة صلبة لتحليل السمات الأساسية للمفاهيم اللغوية ودلالاتها الإجتماعية والثقافية والروحية والصوفية. فكان من رواد التحليل السميولوجي في اليابان. وقد ساعده على تحليل القضايا العربية والإسلامية بأسلوب جديد في مجال رؤية الإنسان لذاته، ولمحيطه العام، وللكون اللامتناهي. واستكشف مستويات عدة للنص اللغوي في القرآن ليقدم دراسة رائدة عن دلالات النص القرآني لم يسبقه إليها إلا قلة من الباحثين العرب في مجال التحليل السيميولوجي للنص القرآني. قضايا نظرية ذات طابع سجالي حول مناهج التاريخ العربي حتى نهاية الحرب العالمية الثانية لم تكن للباحثين اليابانيين معرفة معمقة بتاريخ العالم العربي، وبشكل خاص حركات التحرر التي قادت تباعا إلى استقلال الدول العربية. كانت هناك قلة من اليابانيين الذين كتبوا دراسات باليابانية عن منطقة الشرق الأوسط فكان منهم :ريئيتشي غامو Gamo Reiichi، وإئيجيرو ناكانو Nakano Eijiro، وتاكاشي هاياشي Hayashi Takashi. علموا في جامعات طوكيو وأوساكا، وقدموا دراسات عامة عن الهند وإيران والعالم العربي. وكان إلى جانبهم دبلوماسيون يابانيون من أمثال أكيو كاساماKasama Akio، والباحث بالقضايا العربية شوجي تامورا Tamura Shuji.بالإضافة إلى الباحثين توراؤ كاواساكي Kawasaki Torao، وماساناؤ أوداكا Odaka Masanao، وتوشيو تادا Tada Toshio. في الفترة ما بين 1950 و1973، برز نوع جديد من الباحثين اليابانيين المهتمين بالدراسات العربية. واتجه بعض الباحثين الجدد لدراسة حركات التحرر في البلدان العربية والإفريقية. كان الاختبار صعبا نظرا لغياب الدراسات العلمية الامبيريقية عن العالم العربي في اليابان. كان عليهم التعرف بدقة إلى تطور التاريخ العالمي لمعرفة موقع الدول العربية فيه بهدف تعزيز علاقات اليابان معها. كانت الكتابة عن الثورة المصرية للعام 1952، ومؤتمر باندونغ، وتأميم قناة السويس، من الأبحاث المهمة التي أثارت اهتمام الرأي العام الياباني فتعاطف مع قضايا العرب والعالم الثالث التحررية. استمر ذلك التعاطف لعقود طويلة. وأرسلت اليابان بعثات علمية متلاحقة إلى مصر، ودول دول عربية وإفريقية للتعاطف مع شعوبها. وفي العام 1958 أسس تاكيو ناكاتاني Nakatani Takeyo الجمعية العربية اليابانية. وفي العام 1961 أنشئ مركز اللغة العربية في جامعة طوكيو للدراسات الأجنبية. وفي العام 1966 أطلق كيئيتشي كاوامورا Kawamura Kiichi، من جامعة واساداWaseda بطوكيو، مشروعا لدراسة تاريخ مصر القديم الذي بدأ تنفيذه عام 1972، وشاركت فيه نخبة من الأساتذة منهم كانئيتشي ناكازيما Nakazima Kenichi، وساكوراي كيوهيكوSakurai Kiyohiko، وساكوجي يوشيمورا Yoshimura Sakuji. وفي خريف العام 1968، تأسس مشروع «دراسات معمقة حول الإسلام والتحديث». وفي إطاره دعي المؤرخ المصري محمد أنيس، من جامعة القاهرة، لإلقاء محاضرات عن تاريخ العرب. آنذاك، كانت الأفكار الماركسية في فهم التاريخ تستقطب المثقفين في اليابان وخارجها. وكان المؤرخون الماركسيون اليابانيون ينعتون نظام الحكم في اليابان بالفاشية اليابانية. وركزوا في دراساتهم على حركات التحرر الوطني، والتحديث السليم، والديمقراطية، وشرعية الثورة الاجتماعية، ورفض كل أشكال التسلط السياسي. تأثر مؤرخو تلك الحقبة بدراسات المؤرخ الماركسي بوكورو إيغوتشي Bokuro Eguchi (1911-1988) الذي رفض المركزية الأوربية كمنهجية وحيدة لكتابة وتحليل التاريخي العالمي. وشدد على دور حركات التحرر الوطني في مختلف دول العالم. وحلل بعض قضايا التاريخ العربي بصورة معمقة. ونشر دراسة مهمة باليابانية عن اتفاقية سايكس – بيكو في مجلة العالم الإسلامي. وأدان سياسة اليابان الامبريالية تجاه دول الجوار الآسيوية، ونبه إلى مخاطر تضخيم النزعة القومية الهادفة إلى السيطرة على قوميات أخرى. خلال العامين 1959 و1960 كتب إيغوتشي مقالات مجد فيها السياسة الخارجية المصرية التي تبنت شعار الحياد الإيجابي على المستوى الكوني positive Neutralism. واشاد بتأميم قناة السويس، وندد بالتحالف الأمريكي - الياباني بعد توقيع اتفاقية 1960 التي وضعت اليابان تحت الحماية الأمريكية. برزت قضايا سجالية مهمة في اليابان عن التاريخ العربي بشكل خاص بعد صدور كتاب مشترك للمؤرخ الاقتصادي الاجتماعي سن إئيكي ناكاؤكا Nakaaoka San Eki بالاشتراك مع المؤرخ السياسي يوزو إيتاغاكي Yuzo Itagaki وكان بعنوان: «تاريخ العرب الحديث والمعاصر»، الصادر باليابانية عام 1959. Nakaoka And Itagaki :Modern And Contemporary History Of The Arabs ,Tokyo 1959. تضمن الكتاب تحليلا معمقا للهجمة الامبريالية الأوربية على العالم العربي منذ القرن التاسع عشر، ومازال العرب يعانون نتائجها السلبية حتى الآن.وقدم دراسات مفصلة عن واقع العالم العربي المعاصر مع التركيز بشكل أساسي على الثورة المصرية للعام 1952 وتأثيراتها على الدول العربية الأخرى. حملت عناوين فصوله الموضوعات التالية: تشكل العالم العربي الحديث، العرب وأوربا، استعمار مصر، تحولات السلطنة العثمانية، العرب والحرب العالمية الأولى، العرب ونظام فرساي، حقبة الثلاثينيات من القرن العشرين كمنطلق لتاريخ العرب المعاصر، عن القومية العربية، مشكلات العرب، من الثورة المصرية إلى الثورة العراقية، تطور النظام الناصري، الامبريالية ونظام ملكية الأراضي. كانت مساهمة إيتاغاكي أكبر في الجوانب التاريخية والسياسية والقومية العربية والزعامة السياسية في تاريخ مصر الحديث والمعاصر. في حين تناول ناكاؤكا المشكلات الاقتصادية والاجتماعية، والإصلاح الزراعي، وسياسة التعاونيات الزراعية، وبنية القرية المصرية. وتشاركا معا في دراسة عن الثورة العراقية. واعتمد كلاهما على أعمال باحثين أوربيين وعرب، مع تقديم إضافات نوعية جديدة. أشارت مقدمة المؤلفين إلى أن الدراسات اليابانية عن المنطقة العربية تأخرت كثيرا لأسباب ذاتية وموضوعية، ما أعاق بناء رؤية عقلانية متبادلة بين العرب واليابانيين طوال النصف الأول من القرن العشرين. أما إيديولوجيا القومية العربية، فتعبر عن رغبة أمة كبيرة تبحث عن استقلال العرب وموقعهم في التاريخ العالمي. تأثرت دراسات إيتاغاكي عن الحركات القومية في مصر والجزائر بآراء إيغوتشي الماركسية، وبانتصار الثورة الشيوعية في الصين عام 1949. وكانت له مواقف جريئة في نقد تبعية اليابان لأمريكا، ولحروب الولايات المتحدة والدول الأوربية في الهند الصينية وخاصة فيتنام وكمبوديا ولاوس. وندد بالنزعة الستالينية في ضرب ثورة المجر الديمقراطية. انطلق في دراساته العربية من شرح مقولة «الاستقلال القومي» في عالم تتنازعه قوتان كبيرتان: الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي.امتدح مواقف الرئيس المصري جمال عبد الناصر، وقادة الثورة الجزائرية، وزعماء حركات التحرر في الدول العربية والإفريقية. فأثارت آراؤه نقاشات حادة بين الباحثين اليابانيين الذين تساءلوا عن معنى القومية العربية كمفهوم نظري. ودعوا إلى شرح مبادئها، ومقولاتها النظرية للرأي العام الياباني، وكيفية تنفيذ المشاريع العملية لإنجاز التضامن العربي وبناء الوحدة العربية على أرض الواقع. تساءل بعض النقاد عن القوى التي تدعم القومية العربية وتعمل من أجل الوحدة، والقوى التي تقف ضدها وتمنع تحقيقها.وهل أن النظرة الماركسية للقومية كانت سليمة أم أنها وضعت القومية في مواجهة الأممية؟ وهل أن دعاة الدعوة القومية سعوا إلى طمس الحركات الوطنية في الدول العربية وضربها، وحاربوا الداعين إلى الاستقلال التام وقيام الدولة الوطنية في دولهم؟. فشهدت الساحة الثقافية اليابانية آنذاك نقاشات مهمة في أوساط المؤرخين اليابانيين المهتمين بالقضايا العربية، ما اضطر المؤلفين لعقد ندوة خاصة عام 1959 تحت عنوان «الامبريالية والقومية في التاريخ المعاصر» للرد على تلك الانتقادات. عقدت الندوة في مقر «الجمعية اليابانية للعلوم التاريخية» التي تأسست عام 1931. شهدت الندوة نقاشا علميا معمقا حول طبيعة الثورة الناصرية، وموقع الطبقة الوسطى في تاريخ العرب الحديث والمعاصر ودورها في الإعداد للثورة الناصرية، ومدى قدرتها على حماية منجزاتها التي استفادت منها البورجوازية الوطنية المصرية.وجرى التذكير بالأصول الطبقية للزعامات السياسية المصرية.وتمت مقارنة تشكل الطبقة الوسطى في المجتمعات العربية الحديثة مع مثيلاتها في المجتمعات الغربية. ووجهت انتقادات حادة لمفهوم «الرأسمالية الوطنية» من حيث هو مفهوم ضبابي وغير علمي. هذا بالإضافة إلى مفاهيم «تحالف قوى الشعب العامل»، وموقع كل من البورجوازية الوطنية وملاك الأراضي في «الوحدة الوطنية». فتولى المؤلفان الرد على تلك الانتقادات بتوضيح مدى تأثير الجذور الطبقية للقيادات السياسية في الثورة المصرية على مسار الثورة.ونشر إيغوتشي مقالة مهمة علق فيها على المقولات النظرية التي تفسر طبيعة العلاقة بين البنية الاقتصادية - الاجتماعية والثورة. واعتبر الكتاب لسنوات طويلة مرجعا أساسيا في الدراسات اليابانية عن تاريخ العرب الحديث والمعاصر. وتربت عليه أجيال متعاقبة من الباحثين اليابانيين المهتمين بتاريخ العرب وتراثهم وثقافتهم. لقد بالغ الجيل الأول من المؤرخين اليابانيين في الدفاع عن مبادئ الثورة المصرية، وكفاءة الرئيس جمال عبد الناصر وقدرته على توليد حركة قومية عربية جامعة. وأبدوا تعاطفهم معها على غرار عدد كبير من القوميين العرب في تلك الحقبة. ورحب ناكاؤكا بالإصلاح الزراعي في مصر على أساس أن المسألة الزراعية من أشد المسائل تعقيدا في العالم العربي، ولابد من معالجتها بحكمة وجرأة وفق مخطط طويل الأمد. واعتبر أن حلها بطريقة عقلانية يشكل مدخلا لبناء حداثة عربية سليمة وبنى اقتصادية واجتماعية قوية. ونوه بتدابير النظام المصري الداعية إلى بناء «العزبة الرأسمالية» أي توظيف الرأسمال في الزراعة للانتقال من الزراعة التقليدية والتجمعات القروية إلى المشاريع الزراعية ذات الطابع الرأسمالي الحديث. وتحفظ ايغوتشي على التفاؤل المفرط الذي ابداه ناكاؤكا في هذا المجال. وشكك بقدرة مصر على الانتقال من مجتمع تقليدي قروي إلى مجتمع رأسمالي متطور. إلى جانب من تبنى المقولات الماركسية في فهم التاريخ العربي، شدد مؤرخون يابانيون آخرون على تحليل البنية الاجتماعية والاقتصادية المصرية وأثر المرحلة الكولونيالية البريطانية في تطويرها، ودور الاسلام كعامل أساسي ومحرك في البنية التقايدية المصرية. ودعوا إلى تجاوز مفهوم نمط الإنتاج الآسيوي الذي أدخله المؤرخون السوفييت بصورة اعتباطية إلى التحليل الماركسي لفهم التاريخ. وكانت آراء إيتاغاكي وناكاؤكا متقاربة جدا في النظر الى مقولات الاشتراكية العربية في المرحلة الناصرية على أنها مقولات معادية للاستعمار الجديد. واعتبروها مزيجا من المبادئ الاشتراكية الدولية بخصائص قومية عربية اتخذت أشكالا متنوعة وفق المتطلبات الداخلية في كل بلد عربي وتحالفاته الإقليمية والدولية. كما أن بعض المؤرخين اليابانيين تأثروا بمبادئ الثورة الصينية وشعاراتها الخاصة بأولوية دور الفلاحين في تغيير المجتمعات التقليدية التي كانت قوية طوال السنوات الممتدة من 1949 حتى 1978، حين قررت الصين تبني سياسة الانفتاح والاصلاح والتخلي عن مقولة الطبيعة الثورية للطبقة الفلاحية. أصيبت التنظيرات اليابانية الثورية حول الاصلاح الزراعي في الدول العربية وباقي الدول النامية بالإحباط بعد النتائج الهزيلة التي تمخضت عنها، والأزمات المتلاحقة التي عاشتها المجتعات الفلاحية العربية بسبب الفقر، والجوع، والأمية، والتصحر، وغياب التقنيات الزراعية المتطورة، وبروز الرأسمالية النفطية، والتحالف بين كبار التجار والسياسيين والإداريين والعسكريين.فسيطرت الرأسمالية الطفيلية العربية على الأراضي الزراعية الخصبة، وحرمت الفلاحين منها بعد تحويلها إلى ملكيات خاصة كبيرة.وفي ذلك تأكيد على فشل الاصلاح الزراعي في جميع الدول العربية، وتزايد حدة المسألة الزراعية فيها إبان مرحلة الانفتاح أو سياسة الباب المفتوح غير الخاضع لأي رقابة فعلية من الدولة، مما أدى إلى بروز ظاهرة «القطط السمان» التي انتشرت على نطاق واسع في مصر وغالبية الدول العربية. في مقالات نشرت خلال العقدين الماضيين نبه إيتاغاكي إلى دور الإسلام في المجتمع المصري، وحلل موقع الاخوان المسلمين كمعارضة للثورة المصرية وللنظام الناصري. ثم طور تلك المقولات في دراساته عن الاسلام السياسي في مصر. وأعاد النظر في مقولاته السابقة عن المجتمع المصري، والناصرية، والقومية العربية. كذلك طور ناكاؤكا مقولاته النظرية السابقة في تحليل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في مصر ودول عربية أخرى. على جانب آخر، نشر إيتاغاكي الكثير من المقالات عن القضية الفلسطينية وخاصة بعد ولادة منظمة التحرير الفلسطينية عام 1965. وما زال يلعب دورا بارزا في تعريف اليابانيين بالقضايا العربية العادلة.ونظم ندوات عدة في مختلف أنحاء اليابان دفاعا عن الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني، داعيا إلى ضرورة تطبيق القرارات الدولية وخاصة القرار 194 حول حق عودة الفلسطينيين إلى أراضيهم والتعويض عليهم، وحق الفلسطينيين في بناء دولتهم الوطنية المستقلة، وإيجاد حل عادل ودائم لأزمة الشرق الأوسط. شارك بفاعلية في تنظيم محكمة طوكيو الدولية عام 1983 لمحاكمة جرائم إسرائيل في لبنان وخاصة مجازر صبرا وشاتيلا في سبتمبر 1982.ونشر أعمال الندوة في كتاب وثائقي مهم صدر باليابانية والانجليزية عام 1983. ونظم مؤتمرا كبيرا في طوكيو عام 1989 تحت عنوان «المدينية في الاسلام».وكان له الفضل الأكبر في إطلاق عدد كبير من الحوارات بين اليابان والعالمين العربي والاسلامي وقد باتت سنوية منذ العام 2000. وفي مؤتمر الكويت عام 2008، دعا ايتاغاكي إلى بناء «جسر الحكمة» للتواصل الدائم بين اليابان والعالم الاسلامي على اسس عقلانية. وما زال في طليعة الباحثين اليابانيين العاملين على نشر الثقافة العربية في اليابان. بدوره، أعاد ناكاؤكا النظر في مقولاته السابقة عن البنى الاقتصادية والاجتماعية في مصر الناصرية. وكان أول من نشر مقالات بالغة الأهمية عن «المحاكم المختلطة في مصر إبان مرحلة الإمبراطور المتنور مايجي».وتضمن كتابه «تاريخ العرب الاقتصادي والاجتماعي» الصادر عام 1991 دراسات نظرية جديدة ومهمة، شدد فيها بشكل خاص على علاقات اليابان مع منطقة الشرق الأوسط. وحفلت مقالاته المنشورة في العام 1998 بمقولات معمقة حول أهمية المنطقة العربية في العلاقات الدولية والاقتصاد العالمي. ملفات توثيقية لمجلة «العرب» اليابانية عن العالم العربي هي مجلة فصلية تصدرها الجمعية اليابانية العربية Japan Arab Association. تأسست في سبتمبر 1958 لتعنى بالقضايا العربية بشكل خاص. صدر العدد الأول منها في يوليو 1964، وما زالت تصدر حتى الآن بتمويل من شركة النفط اليابانية Cosmo Oil Company. وهي صغيرة الحجم وتوزيعها محدود جدا في أوساط اليابانيين المهتمين بقضايا النفط.فكان الهدف منها متابعة ما يجري في الدول العربية عبر مقالات صحفية إعلامية غير موثقة وغير معمقة في غالب الأحيان. والغاية من إصدارها هي تسليط الضوء على إنتاج النفط العربي بالدرجة الأولى، ومتابعة الأحداث في الدول النفطية العربية والشرق أوسطية لتجنب آثارها السلبية على الاقتصاد الياباني على غرار الأزمة التي حلت باليابان بعد حظر النفط العربي عام 1973. أصدرت المجلة مائة وثمانية وثلاثين عددا حتى سبتمبر العام 2011. وكتبت الغالبية الساحقة من مقالاتها وتقاريرها الصحفية باللغة اليابانية مع عدد محدود جدا من التقارير القصيرة المنشورة باللغة العربية. بعد تصفح الأعداد العشرة الأخيرة الصادرة ما بين 2008 و 2011 تبّين لنا أن محور العدد 127 الصادر في العام 2008 كان بعنوان «الشرق الأوسط وأوباما».وصدرت في العام 2009 الأعداد 128 إلى 131، وتضمنت محاورها: «مأساة غزة»، و«الحرب الإسرائيلية»، و«العرب في نهاية عقد السبعينيات من القرن العشرين».وأصدرت في العام 2010 أربعة أعداد من 132 إلى 135، حملت العناوين التالية: «ملف خاص عن اليمن»، و«نظام الأسد في سوريا»، و«القوة النووية في الشرق الأوسط، و«المرحلة الانتقالية في مصر». وحملت الأعداد الثلاثة 136 حتى 138 الصادرة في سبتمبر 2011، العناوين التالية: «نهاية الدكتاتوريات في العالم العربي: تونس ومصر»، و«الربيع العربي»، و«ملف خاص عن ليبيا»، تناولت ملفاتها موضوعات عربية ويابانية مشتركة ومتنوعة، طالت مختلف تطورات الحياة السياسية والنفطية، والتراثية، والتاريخية، والاجتماعية، والاقتصادية، والفنية، واللغوية، والثقافية، والرياضية وغيرها. وركزت في دراساتها وتقاريرها على القضايا التي تساعد على تعزيز العلاقات الاقتصادية بين العرب واليابانيين.وتكمن أهمية المجلة في أنها تصدر في اليابان وتحمل في عنوانها «العرب». فالمادة الإعلامية والإحصائية فيها تساعد اليابانيين غير المتخصصين على فهم الأحداث الجارية الآن على الساحة العربية، وخاصة الانتفاضات الشعبية التي طالت أكثر من دولة عربية في العام 2011. ورغم صغر حجمها فإن استمرار صدورها طول أكثر من نصف قرن دون انقطاع يبرز أهمية الدور الذي تلعبه على الساحة اليابانية للتعريف بأوضاع الدول العربية، ومشكلات التنمية فيها، والقضايا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تعيشها الجماهير الشعبية المهمشة في أكثر من دولة عربية. أثار حظر النفطي العربي في حرب أكتوبر 1973 أزمة اقتصادية حادة في اليابان التي بات هاجس حكومتها وشركاتها الحصول على النفط العربي الضروري جدا لتطوير الاقتصاد الياباني. بدورهم، لم يكن العرب يهتمون بدراسة اليابان أو الاستفادة من نموذجها في التحديث السلمي بسبب خضوعها للقرار الأمريكي وبقاء أكثر من أربعين ألف جندي أمريكي يرابطون في قواعد عسكرية أقيمت على أرض اليابان وفي مياهها الإقليمية. فاقتصرت العلاقات العربية – اليابانية على تبادل النفط العربي مقابل السلع التكنولوجية اليابانية، ولم يظهر أي اهتمام جدي بتطوير العلاقات السياسية والثقافية بين الجانبين. لكن حظر النفط الذي أحدث صدمة عنيفة في اليابان، زاد من اهتمام باحثيها بمنطقة الشرق الأوسطُ، خاصة الدول العربية منها المنتجة للنفط.وبدعم من الحكومة والشركات اليابانية زاد عدد المراكز الثقافية والمعاهد والجامعات التي تعنى بتعليم اللغة العربية وآدابها، وبتاريخ العرب وتراثهم وحضارتهم. واتسعت دائرة العلاقات الثقافية بين الباحثين العرب واليابانيين على مختلف الأصعدة الأكاديمية، وتبادل الأساتذة والطلبة، وعقد المؤتمرات المشتركة وغيرها.فتزايد حضور الدراسات العربية في اليابان مع تكاثر عدد المستعربين اليابانيين والإعلان عن مشاريع ثقافية مشتركة بين الباحثين العرب واليابانيين.وأبرز إنجازات تلك المرحلة مشروع : «البحوث الدولية المشتركة في مجال العلاقات العربية – اليابانية». وعقدت في إطاره ندوات متلاحقة عن القضية الفلسطينية، والسلام والعيش المشترك في الشرق الأوسط، وقضايا سياسية واقتصادية وثقافية واجتماعية تهم الجانبين. كما أن مسيرة المؤتمرات الثقافية بين الباحثين اليابانيين والباحثين العرب والتي بدأت في العام 1978 وأنجزت أكثر من عشرين مؤتمرا موزعة بين اليابان والعواصم العربية، فإن الغالبية الساحقة من أعمالها لم تنشر بالعربية إلا في حدود ضيقة للغاية. لذلك بقيت الدراسات العربية والإسلامية في اليابان مغيبة بصورة شبه تامة عن الساحة الثقافية العربية حتى نهاية القرن العشرين.وفي العقد الأول من القرن الحادي والعشرين برزت تبدلات إيجابية بالغة الأهمية في مسار العلاقات الثقافية بين اليابان والعالم العربي. فبات للثقافة العربية حضور متزايد في اليابان يقابله حضور متزايد للثقافة اليابانية في العالمين العربي والإسلامي. وبني على أسس موضوعية تتناقض جذريا مع الأهداف التي رسمتها سابقا إدارة اليابان قبل الحرب العالمية الثانية. يندرج كتاب المستعرب الياباني الكبير نوبوإيكي نوتاهارا: «العرب، وجهة نظر يابانية» ضمن سجالات أدبية معمقة نشرها باللغة العربية عام 2003.فلاقى صدى كبيرا في الأوساط العربية واليابانية. أمضى المؤلف فترات طويلة في الريف المصري حيث تعرف إلى حياة الفلاحين وعاداتهم وتقاليدهم. ومن الكتب المهمة التي أثرت في تكوينه الثقافي رواية «الأرض» لعبد الرحمن الشرقاوي، و«شخصية مصر» لجمال حمدان.قرأ أعمالا كثيرة ليوسف إدريس، وصنع الله إبراهيم، ويحيى الطاهر عبدالله، وحسين فوزي، ويحيى حقي وغيرهم.وأقام صداقات حميمة مع عدد من الأدباء والفنانين والباحثين المصريين والعرب. ثم توجه لدراسة البادية فكانت له رحلة إلى حضرموت، ورحلات إلى البادية السورية وغيرهما من البوادي العربية. وجد في البادية ثقافة أخرى لا يعرفها اليابانيون، وذلك لسبب بسيط أنه لا توجد لديهم بادية في اليابان. أقام مع البدو في سورية وفي مصر ومع الفلاحين، وبدأ يبحث عن روايات تتحدث عن البدو لترجمتها إلى اليابانية. تعرف إلى إنتاج عبد السلام العجيلي، وروايات عبد الرحمن منيف، وخاصة «مدن الملح».أخيرا وجد ضالته في الكاتب الليبي إبراهيم الكوني الذي ينتمي إلى قبيلة «الطوارق» الليبية. فقرر بذل قصارى جهده لدراسة أعماله وتقديمه إلى القارئ الياباني، بترجمة ودراسة. أما لماذا انتقل من المدن والأرياف إلى الصحراء؟ فلأسباب يعتبرها محض ذاتية وإرادية.«فالصحراء، حسب قوله، تنحت الروح وتدبغ الجلد وتدمر الوعي بالوقت والفراغ. وهي مكان الوحدة، لكن الوحدة هذه تختلف جذريا عن مفهوم الوحدة في اليابان حيث المكان يكتظ بالينابيع والخمائل. نحن نحتاج إلى قوة الروح لكي نتحمل الوحدة في الصحراء.الصحراء مكان العقيدة بامتياز.فمن لم يجد عقيدة في أي مكان فإنه يستطيع أن يجدها في الصحراء. في البادية، يملأ الله وجود المكان. لذلك لا يشكر البدو المضيف من أجل الماء والنار والطعام لأنهم يعتبرونها ملكا لله. أمضى نوتاهارا أربعين سنة في تعلم وتدريس العربية.ترجم الكثير من الروايات العربية إلى اليابانية بعد أن قام بزيارات عدة إلى عدد من الدول العربية.وصف تجربته الأدبية بقوله: «كتبت عما خبرته وشاهدته بملء إرادتي.زرت الأماكن التي أردت، ودققت باب البيت الذي أردت زيارته.لكن ما كتبته باليابانية والعربية هنا لا يعطي صورة كاملة ولا منظمة عن البلدان العربية.فما قدمته لا يمثل سوى وجهة نظر شخصية وصغيرة حول بعض البلدان العربية. وعزائي أنني كنت صادقا في ما كتبت، وأنني أعتبر أن ما قدمته في هذا الكتاب هو بمنزلة رد الجميل لأصدقائي من العرب.إن قدرتي على قراءة الأدب العربي الحديث هي متعتي الشخصية.وهي نوع من الامتياز الشخصي الذي حصلت عليه لأن قلة فقط من اليابانيين تحصلت على تلك المتعة وذاك الامتياز.وبعد متعة القراءة جاءت متعة الترجمة. فاخترت ما ترجمته وفق اهتمام شخصي بالدرجة الأولى، وقبل الاهتمام بما يريد الجمهور الياباني. فكل ما قمت به كان بمنزلة تجربة شخصية أملتها رغبتي الذاتية وبمحض اختياري». ترجم إلى اليابانية رواية «الأرض» لعبد الرحمن الشرقاوي عام 1979، و«أرخص ليالي» عام 1980، ورواية «الحرام» عام 1984، و«العسكري الأسود» عام 1990، و«تلك الرائحة» عام 1993، و «بيت من لحم»، و«حادثة شرف »، و«الخبز الحافي»، وكثير غيرها. واهتم بترجمة روايات يوسف إدريس الذي جسد بأسلوبه الرائع عادات فلاحي مصر وتقاليدهم. وأعجب كثيرا بروايات إبراهيم الكوني التي تجسد روح الصحراء العربية وعادات البدو. كما اهتم بأدب السجون ودرّس طلابه كتاب «رسائل السجن» لعبد اللطيف اللعبي. ترجم رواية «الوباء» للكاتب السوري هاني الراهب التي تقدم نموذجا مهما عن أساليب القمع الثقافي في العالم العربي. نوه في كتاباته النقدية بالكتّاب العرب الذين تميزوا بمواقف ثابتة ومبدئية من أمثال الشاعر علي الجندي، والروائي حيدر حيدر، والروائي إميل حبيبي، ومحمد شكري.أسلوبه مميز في الترجمة المتأنية.إذ لم يكن مستعجلا لإنجاز الترجمة قبل زيارة الأماكن التي حصلت فيها أحداث الروايات.فيتفحصها بدقة، ويطوف في أرجاء البلد يلتقي الأدباء فيه، ويسعى للتعرف إلى حياة الناس اليومية بصورة مباشرة، وعلى نطاق واسع. تضمن كتابه «العرب، وجهة نظر يابانية»، الصادر بالعربية عن منشورات الجمل، ألمانيا، 2003، آراء جريئة في موضوعات متنوعة أبرزها: ثقافة الأنا وثقافة الآخر، كارثة القمع وبلوى عدم الشعور بالمسئولية، ودور عالم غسان كنفاني في تعريف اليابانيين إلى حقيقة القضية الفلسطينية، وما تعلمته من ثقافة البدو، وعالم إبراهيم الكوني، وعبد اللطيف اللعبي: الكتابة والقمع والحرية، يوسف إدريس والطريق إلى معرفة المجتمع في مصر. حملت موضوعاته آراء جديرة بالاهتمام والتقدير.فهي نتاج جهود طويلة استمرت أكثر من أربعين سنة أمضاها المؤلف متجولا في رحاب المدن والأرياف والبوادي العربية.وجمعته صداقات حميمة بعدد كبير من الشعراء والروائيين والباحثين العرب من أمثال أدونيس، ومحمد براده، وعبد الكريم الخطيبي، ونذير نبعة، والفنانة شلبية إبراهيم، وغيرهم. ينتسب كتاب نوتاهارا إلى جيل النضج عند الباحثين اليابانيين الذين أتقنوا العربية بدرجات متفاوتة، وأمضوا سنوات طويلة في العالم العربي، وزاروا الكثير من دوله، وتعلموا عددا من اللهجات السائدة في بعض المناطق العربية.وكانت ثمرة إتقانهم للغة العربية بشكل معمق، ومعرفتهم الدقيقة لأحوال المجتمعات العربية والسكن فيها لسنوات طويلة وزيارتها بشكل سنوي ومنظم، أن تجرأ نوتاهارا على الكتابة بالعربية لمخاطبة العرب كصديق حميم. كان صادقا في انتقاداته الصريحة والمباشرة للمثقفين العرب الذين تقاعسوا عن تجديد نهضتهم كما فعل اليابانيون.تنسجم مقولاته مع ما كتبه المؤرخ العربي المعروف شارل عيساوي في مقالته «لماذا اليابان؟»، حول تأكيد قدرة العرب على التحديث. فشروط النجاح متوافرة في حال وجدت الإرادة السياسية العربية القادرة على تحويل تلك الطاقات الكامنة إلى أفعال ملموسة وبرامج نهضوية طويلة الأمد. كتب باللغة العربية لأسباب عاطفية مؤثرة.«كتبت باللغة العربية لأعبر عن محبتي للثقافة العربية.فقد أعطيتها عمري كله، وجهدي كله، وعملي كله.وهذا، برأيي، أرفع تقدير وأكبر محبة. والسؤال الذي أقلقني دائما هو: لماذا أرى أن من واجبي أن أكتب باللغة العربية مباشرة إلى القارئ العربي وأنا أعرف سلفا كم سترهقني الكتابة بالعربية؟ لكنني قلت في نفسي: كتبت للقارئ الياباني باليابانية وبقليل من الإنجليزية. فلماذا لا أكتب للقارئ العربي بلغته؟ ما أثيره في هذا الكتاب هو موضوعات تخصني شخصيا كإنسان وككاتب وكياباني في آن واحد.ما أريد قوله للقارئ العربي إنني أعبر عن رأيي الشخصي في قضايا تخصه. أنا أنظر إليها من الخارج كأي أجنبي عاش في البلدان العربية، وقرأ الأدب العربي، واهتم بالحياة اليومية في المدينة والريف والبادية. إنه مجرد رأي من الخارج أرجو أن يسهم في بناء مستقبل عربي أفضل.وإذا كان من كلمة صريحة ومباشرة تقال في هذا المجال فهي أنني أرى أن الحرية هي باب الإنتاج، وباب التواصل والحياة النبيلة في آن واحد. وأرى كذلك أن القمع داء عضال ومقيم في الوطن العربي والعالم، وما لم نتخلص منه فستفقد حياتنا كبشر الكثير من معانيها». يعتبر هذا الكتاب مؤشرا مهما على بداية مرحلة النضج للدراسات العربية في اليابان. فبعد أن تزايد عدد اليابانيين المهتمين بتاريخ العرب، وبلغتهم، وثقافتهم، وآدابهم، وتاريخهم، وحضارتهم، بدأ الانتقال من مرحلة التراكم الكمي إلى التمايز النوعي.لذا يعتبر نوتاهارا نقطة تحول مهمة في مسار التعريف بالثقافة العربية على الساحة اليابانية. وعند صدوره قدر نوتاهارا عدد الطلبة اليابانيين الذين يدرسون اللغة العربية بأكثر من مائة طالب، ويتلقون إلى جانبها معارف أخرى باللغة اليابانية، كعلم النفس، والفلسفة، وعلم الاجتماع وغيرها. لكن المهم في نظره أن الطلبة اليابانيين أصبحوا يدرسون اللغة العربية، والثقافة العربية والإسلامية وفق برنامج واضح الأهداف، وبأسلوب ومناهج منظمة. وتتوافر لديهم حاليا أنظمة متطورة لتدريس هذه اللغة الجميلة التي لها مستقبل جيد في اليابان. وبالإضافة إلى المكسب الثقافي والحضاري من تعلم اللغة العربية وما تسمح به من اطلاع على تراث وحضارة العرب والمسلمين، هناك أيضا جانب اقتصادي أو الكسب المادي. ويلعب هذا العنصر دورا مشجعا في تعلم اللغة العربية. فالبنوك والشركات والمؤسسات الإنتاجية في اليابان تتنافس لاجتذاب الخريجين اليابانيين من قسم اللغة العربية. أكد نوتاهارا أنه منذ قرابة المائة سنة، لم يكن اليابانيون يعرفون شيئا عن العرب، ولم يكن العرب يعرفون إلا القليل عن اليابان. ثم تعرف بعضهم إلى البعض الآخر بصورة تدريجية، ومن خلال التواصل المباشر على مختلف الأصعدة. وشدد على السؤال التالي: «كيف نتبادل الثقافة؟، وكيف يمكن النفاذ إلى جوهر الثقافة العربية؟ وكيف يمكن أن تتم عملية تمثل الثقافة العربية ؟ عندنا الكثير من الذين تثقفوا بالثقافة الغربية، وهم يعيشونها وتظهر حية في حياتهم اليومية. فلماذا ليس لدينا في اليابان حتى الآن من تربى تربية ثقافية عربية إسلامية؟». وأشار إلى عوائق موضوعية تحول دون تفاعل الثقافتين اليابانية والعربية. فغالبية الباحثين اليابانيين هم من المترجمين الذين يفسرون على الدوام دون أن يكتشفوا قضايا نظرية أو مقولات جديدة. وخلص إلى القول: «ما لم نكتشف الثقافة العربية من الداخل، فلن نستمتع بها. ولابد من ولادة جيل ياباني جديد لا يكون مترجما فقط.وبدون تجاوز الحاجز الكبير بين الثقافتين العربية واليابانية، سنبقى كلانا قرب السطح، بعيدا عن الأعماق.فالعرب لا يعرفون شيئا جوهريا عن اليابان، وهم غير مهتمين حتى الآن بمعرفة ثقافة اليابان.لذلك أشك في أن يكون اهتمام اليابانيين بالثقافة العربية والإسلامية جديا.أنا شخصيا عملت في هذا الاتجاه». يعتبر كتاب إيجي ناغاساوا : «مصر الحديثة بعيون يابانية»، الصادر بالإنجليزية عام 2009 سجلا حافلا بأسماء الدراسات اليابانية التي تناولت تاريخ مصر الحديث والمعاصر. Eiji Nagasawa: Modern Egypt Through Japanese Eyes : A Study On Intellectual And Socio-economic Aspects Of Egyptian Nationalism. Cairo, Merit Publishing House, 2009, 410p. ناغاساوا من أبرز المستعربين اليابانيين المهتمين بتطور المجتمع المصري المعاصر. تخرج في كلية الاقتصاد بجامعة طوكيو عام 1976 وبدأ العمل في معهد الاقتصادات المتطورة بطوكيو لسنوات عدة قبل أن ينتقل إلى معهد الدراسات الشرقية في جامعة طوكيو كاستاذ مساعد.ترأس الجمعية اليابانية لترقي العلوم وعمل مديرا لمعهد الدراسات اليابانية في القاهرة. وفي العام 1998 رقي إلى رتبة أستاذ في قسم الدراسات اليابانية حول منطقة غربي آسيا. نشر الكثير من الدراسات باليابانية والانجليزية حول قضايا العالم العربي والشرق الأوسط، مع التركيز على قضايا المجتمع المصري، الاقتصادية منها والاجتماعية بشكل خاص. يعتبر كتابه الجديد «تاريخ مصر الحديث بعيون يابانية: دراسة في الجوانب الفكرية والاقتصادية والاجتماعية للقومية المصرية»، الصادر بالإنجليزية عن دار ميريت المصرية عام 2009، نقلة نوعية في مجال الدراسات اليابانية للتعريف بقضايا العرب وبالثقافة العربية. والمؤلف شديد التواضع على خلفية ثقافة معمقة.أتقن العربية والإنجليزية إلى جانب اليابانية، ولديه معرفة شمولية بكثير من المجتمعات العربية. لكنه ركز في دراساته على قضايا المجتمع المصري الحديث والمعاصر، ولديه انتماء مرهف إلى كل ما هو وطني أصيل وإنساني.كان في دراساته العربية منحازا على الدوام إلى جانب العمال والفلاحين والمثقفين المتنورين من ذوي الميول الثورية أو الليبرالية، والمدافعين بصلابة عن شخصية مصر وضرورة الحفاظ على تراثها الأصيل ودورها الطليعي على المستويين العربي والشرق أوسطي. توزعت أبحاث الكتاب ضمن أربعة محاور: تاريخ مصر الاقتصادي والاجتماعي الحديث والمعاصر، ودراسات في قضايا الشرق الأوسط المعاصرة، ودراسات في الفكر العربي المعاصر والنخب الثقافية العربية والتراث الشعبي العربي، ودراسات في قضايا التاريخ الاقتصادي وتاريخ الفكر السياسي في المشرق العربي الحديث. وأعاد المؤلف نشر أهم مقالاته الثقافية والاقتصادية والاجتماعية التي صدرت سابقا بالإنجليزية أو باليابانية ثم نقلها إلى الإنجليزية.ولاقى الكتاب ترحيبا من أوساط ثقافية متعددة. تضمن الكتاب وجهة نظر يابانية في قضايا مصرية بشكل خاص وعربية مشرقية بشكل عام. واستند إلى مقولات نظرية متنوعة ترددت مرارا في مقدمة الكتاب واستنتاجاته وخاتمته.وهي تؤكد على أن تطور المجتمع المصري الحديث والمعاصر شكل نموذجا متقدما بين المجتمعات العربية نظرا لمكانة مصر ودورها الريادي في العالم العربي. حفل الكتاب بمعلومات علمية موثقة وعلى قدر كبير من الدقة والموضوعية.وعالج فيه شخصية مصر من خلال دراسة كتاب جمال حمدان الذي صدر بالعنوان نفسه.وحلل موقف الأقليات المصرية من القضايا المصرية والعربية الكبرى من خلال دراسة السيرة الذاتية لأحمد صادق سعد، المفكر المصري اليساري من أصول يهودية.وناقش مبادئ ثورة 1919 المصرية ومواقف حزب الوفد، ومشكلات التأميم، والإصلاح الاقتصادي في مصر الناصرية، ومفاهيم القطاع العام، والبورجوازية الوطنية، والقوة الناعمة، والانتفاضات العمالية، وحركة عمَّال التراحيل، وسياسة الباب المفتوح وآثارها الاقتصادية والاجتماعية على المصرية، وآفاق تطور مصر المعاصرة ما بين أزمات الحداثة المقتبسة عن الخارج وحدة التحركات الشعبية المتزايدة التي شهدها المجتمع المصري في تلك المرحلة. وتضمن أيضا دراستين مهمتين أعدهما المؤلف للتعريف بكتابين لباحثين يابانيين من أبرز المهتمين بتاريخ العرب والثقافة العربية في تاريخ الياباني المعاصر. فكتاب البروفسور يوزو إيتاغاكي: «الشرق الأوسط المعاصر»، متميز في مجال دراسة الفكر السياسي العربي في المرحلة الراهنة.ويعتبر كتاب البروفسور هيروشي كاتو: «أصحاب الملكيات الخاصة في المجتمع المصري»، من أفضل الدراسات الاقتصادية والاجتماعية اليابانية التي تناولت تطور نظام الملكية العقارية والضرائب الريفية في تاريخ مصر المعاصر من خلال وثائق أصلية. تبرز صعوبة كبيرة في التعريف بمنهجية هذا الكتاب الذي تضمن مقالات عدة عالجت موضوعات متنوعة، ونشرت في فترات متباعدة.لكن الكتاب، على تباين موضوعاته وتاريخ صدورها مفيد جدا للباحثين بتاريخ مصر والمشرق العربي، السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، ما يستوجب نقله إلى العربية بعد ترجمته بأمانة ودقة. عالج المؤلف مفاهيم نظرية كانت متداولة سابقا ثم تراجع استخدامها نظرا لعدم علميتها. فباتت للكتاب أهمية توثيقية لتلك المفاهيم، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: نمط الإنتاج الآسيوي، والرأسمالية الزراعية في مصر، والدولة الوطنية المصرية، والاقتصاد القومي المصري، والبورجوازية الوطنية المصرية، وسياسة الباب المفتوح في مصر، ومقولات التحديث المصرية، والمقارنة بين النهضة اليابانية والنهضة المصرية، ومفهوم القوة الناعمة، والتنظيم البنيوي لحركات الاحتجاج المصرية بشكل خاص والشرق أوسطية بشكل عام، وموقع قوى الإنتاج في حركة التغيير الاجتماعي، وصلابة العادات والتقاليد الموروثة، وهشاشة الحداثة المصرية والعربية التي بنيت على ركائز تتعارض مع طبيعة الحداثة، وغياب القوى الاجتماعية الحاضنة للحداثة السليمة والمدافعة عنها في مواجهة قوى الجمود الاجتماعي والقمع السلطوي. ليس من شك في أن مقولات الكتاب النظرية في غاية الأهمية، وهي تبرز خصوصية الدراسات اليابانية في النظر إلى الثقافة العربية بعيون يابانية وليس استشراقية غربية.وعالجت مشكلات بناء الدولة المصرية بشكل خاص، والدولة العربية الحديثة بشكل عام، والأسباب التي أدت إلى احتفاظها بطابع الدولة القمعية الموروث من العهدين العثماني والاستعماري الأوربي.وسلطت الضوء على الاستخدام المفرط للقمع الذي مارسته الدولة العربية الحديثة ضد حركات الاحتجاج الشعبي التي عبرت عنها المنظمات والجمعيات والنقابات والأحزاب العربية ذات الجذور الريفية أو المدينية المهمشة. وحللت بعمق طبيعة البورجوازية المصرية بشكل خاص والمشرقية العربية بشكل عام من حيث هي بورجوازية ريعية، كان هاجسها المضاربات العقارية، والربح السريع، واستخدام الجيش وأجهزة الدولة لقمع المعارضة وحركات الاحتجاج الشعبي كافة. وقدم أدلة قاطعة على أن البورجوازية العربية ذات التوجهات الوطنية لم تنجح في ترسيخ أنماط إنتاج عصرية على غرار ما قامت به البورجوازيات الأوربية والأمريكية واليابانية وغيرها. ولم تساهم في تطوير قوى الانتاج وعلاقات الإنتاج، ولم تحتض النخب الثقافية المتنورة، ولم تتبن برامج طويلة الأمد لنشر العلوم العصرية والتكنولوجيا المتطورة ووضعهما في خدمة المجتمع. لذلك كله فشلت في وبناء دولة عصرية على أسس ديمقراطية تحاقظ على كرامة الإنسان، وحقوقه الأساسية. قدم كتاب ناغاساوا نموذجا بحثيا متقدما للتعريف بالثقافة العربية في اليابان.ويعتبر بحق في طليعة الدراسات اليابانية التي أحاطت بجوانب معمقة من الثقافة العربية مع التعريف بنخب ثقافية عربية متميزة. فقد عايش المؤلف في العالم العربي لسنوات عدة، وأتقن اللغة العربية إلى جانب لغات عالمية.تعرف إلى المجتمعات العربية بشكل عياني مباشر، فكتب عن تاريخها، وتراثها، وثقافاتها، واقتصادها، ومثقفيها، وحركاتها الاجتماعية. وأظهر هذا البحث مدى التطور التدريجي الذي شهدته الثقافة العربية في اليابان. وإلى جانب ناغاساوا، نشر باحثون يابانيون دراسات علمية معمقة للتعريف بجوانب أساسية من الثقافة العربية، وتحليل تاريخ العرب في إطار التاريخ العالمي، ومشكلة العصبيات والتجمعات السكانية في الدول العربية، وقضايا النفط، والبيئة، والعلوم العصرية، واستيراد التكنولولجيا، والحفاظ على التراث، والتفاعل الايجابي بين الثقافة العربية والثقافات العالمية، ومنها الثقافة اليابانية. نعيد التذكير بأن الدراسات العربية في اليابان حديثة العهد بالقياس إلى الدراسات الغربية عن العالم العربي، والتي يعود تاريخها إلى قرون عدة.وحتى نهاية الحرب العالمية الثانية، غالبا ما كان يدمج تاريخ العرب بتاريخ الشرق الأوسط، والثقافة العربية بالثقافة الإسلامية أو الشرق أوسطية.وعبر الانتقال من التراكم الكمي إلى التمايز النوعي تشكل وعي الباحثين اليابانيين بقضايا العرب الأساسية كالتاريخ، والمجتمع، والثقافة، والأدب، والفنون، والفلسلفة، والدين وغيرها. لكن الباحثين اليابانيين في الثقافة العربية باتوا اليوم على درجة متقدمة من التخصص العلمي في مجالات بحثية عربية متنوعة. وهم يعدون أبحاثا ميدانية متخصصة تطال قضايا شمولية أو فرعية عن الدول العربية.فلم يعد الكلام على شمولية التاريخ العربي مغريا لجيل المثقفين اليابانيين الجدد الذين تحولوا إلى متخصصين في قضايا عربية محددة، وفي دولة عربية واحدة أحيانا: كالأحزاب السياسية في مصر، والاقتصاد الجزائري بعد الاستقلال، ومشكلة جنوب السودان، وتاريخ المغرب في ظل الحماية الفرنسية، وتاريخ اليمن المعاصر، ووثائق حلب في العهد العثماني، ومدارس الموسيقى العربية الراهنة في المشرق العربي وكثير غيرها. مع ذلك، فحضور الثقافة العربية في اليابان ما زال ضعيفا بالقياس إلى انتشارها الواسع في الغرب، بجناحيه الأوربي والأمريكي.وبما أن الباحث الياباني حديث العهد بالثقافة العربية، فهي تنتشر فقط في أوساط ضيقة من النخب الثقافية وسط جمهور ياباني لا يعرف إلا القليل عن العرب وثقافتهم.ولأسباب ذاتية وموضوعية، ما زالت قضايا العرب التاريخية الكبرى، ومكونات الثقافة العربية، ومشكلاتها، وجمالياتها ضبابية لدى الجمهور الياباني الواسع. في البداية كرر الباحثون اليابانيون ما قاله المستشرقون الغربيون عن العالم العربي، إذ لم تكن لديهم مصادر معرفية أخرى تمكنهم من معرفة الثقافة العربية على حقيقتها.لكنهم أحسوا لاحقا أن نسبة كبيرة من المستشرقين الغربيين لا يبحثون عن الحقائق التاريخية والمعرفية عن العالم العربي، ولا يقدمون الثقافة العربية بالاستناد إلى مصادرها الأصلية.ومنهم من كان مرتبطا بمشاريع استعمارية للدولة التي تمول أبحاثهم عن تاريخ العرب وثقافتهم. وأدركوا جيدا أن هؤلاء لا يقولون الحقيقة رغم معرفتهم الأكيدة بها.وكانت القضية الفلسطينية خير مثال على ذلك.فكانت الصحافة اليابانية تقدم القضية الفلسطينية لليابانيين نقلا عن الإعلام الأمريكي والأوربي. لكن الباحثين اليابانيين الذين عرفوا العالم العربي عن كثب، أحدثوا تبديلا جذريا في هذا المجال. فتغيرت صورة العرب تدريجيا في اليابان دون أن تصل.وتزايد عدد الباحثين والإعلاميين اليابانيين الذين أدركوا أن الإعلام الغربي ونسبة كبيرة من مثقفي الغرب لا يقولون الحقيقة عن تاريخ العرب وثقافتهم وتراثهم. لعب البروفيسور إيتاغاكي دورا مهما في كشف التشويه الدائم للقضية الفلسطينية وللثقافة العربية عبر الإعلام الغربي.وشجع الباحثين اليابانيين الشباب على رؤية الحقائق العربية مباشرة.فباتت لديهم القدرة على تقديم الحقائق التاريخية، ومشكلات الثقافة العربية على حقيقتها. وهم يتعاطون الآن بصورة نقدية وبكثير من الحذر والتدقيق والحيطة، مع الكتابات الغربية حول القضية الفلسطينية، والثقافة العربية. نشير أخيرا إلى أن رؤية المثقفين اليابانيين للمسألة القومية بشكل عام وللقومية العربية بشكل عام شهدت تبدلا جذريا بفضل كتابات البروفيسور إيتاغاكي وغيره من الباحثين اليابانيين المهتمين بالثقافة العربية. كانت القومية اليابانية في عهد الامبراطور مايجي وخلفائه آسيوية بامتياز.فدعا اليابانيون إلى الوحدة الاسيوية والتضامن بين الآسيويين لمواجهة الغرب الاستعماري.وساعدت القومية اليابانية على ولادة وتطور دولة عصرية بهوية قومية يابانية متميزة.لكن مقولة الوحدة الآسيوية أو التضامن الآسيوي في مواجهة الغرب الاستعماري تحولت إلى أداة بيد الامبريالية اليابانية للسيطرة على أجزاء واسعة من دول الجوار، ما أدى إلى علاقات سيئة جدا مع بعض الدول الآسيوية.لذلك تخوف المثقفون اليابانيون بعد الحرب العالمية الثانية من تجدد النزعة القومية الشوفينية واستخدامها مجددا للسيطرة على مقاليد الحكم في اليابان.وكثيرا ما تمت المقارنة بين صعود القومية العربية في أواسط القرن العشرين وصعود القومية اليابانية الشوفينية في زمن مايجي وخلفائه حتى الحرب العالمية الثانية. بدأ تضامن اليابانيين مع القضية الفلسطينية على خلفية تضامن اليابان مع القوميات الآسيوية المناضلة ضد الاستعمار الغربي وخاصة إبان الحرب الكورية، ثم الحرب الأمريكية ضد فيتنام.لكنه ضعف تدريجيا مع تحول اليابان إلى قوة اقتصادية كبيرة تحالفت مع الدول الغربية وتجاهلت محيطها الآسيوي لعقود عدة. فأصيب المواطن الياباني بنوع من الاستعلاء بعد أن دخلت اليابان نادي الدول الكبرى واحتلت المرتبة الثانية في الاقتصاد العالمي. وباتت قلة فقط من المتنورين اليابانيين تشعر بالتضامن مع نضالات الشعوب الأخرى، في حين بحث آخرون عن مصالحهم الشخصية.ورغم كثافة المصالح الاقتصادية اليابانية مع الدول العربية، بقيت العلاقات السياسية، والثقافية، والاجتماعية مع العرب في الحدود الدنيا حتى أواخر القرن العشرين. وكان هناك تحفظ شديد من جانب المثقفين اليابانيين تجاه الكتب التي تمجد القومية العربية، والتضامن العربي، والوحدة العربية.وكانوا يرون فيها خطرا كبيرا على مصالح اليابان المتزايدة في منطقة الشرق الأوسط. تزايدت خيبات أمل المثقفين اليابانيين المناصرين للعرب بعد انهيار النظام الناصري، وحظر النفط العربي الذي أصاب الاقتصاد الياباني بضربة موجعة، وأحيا نزعة عدائية لدى الشعب الياباني تجاه العرب وثقافتهم. وأدت حربا الخليج الأولى والثانية إلى تضرر كبير في المصالح اليابانية وصولا الى انكشاف «اقتصاد الفقاعة» في اليابان منذ العام 1993. وتزايدت حدة العداء الشعبي للعرب بعد مقتل سياح يابانيين في الأقصر بمصر عام 1997، وصعود الأصوليات الإسلامية بصورة يصعب فهمها لدى المواطن الياباني الذي لم يختبر يوما ربط الدولة بأي دين.فالمجتمع الياباني متجانس وتغيب عنه بالكامل النزاعات الدينية أو الطائفية. وبذل المثقفون اليابانيون المناصرون للقضايا العربية جهودا كبيرة لشرح القضايا العربية العادلة أمام الشعب الياباني وخاصة قضية فلسطين.ووجهوا دعوات خاصة لعدد متزايد من المثقفين العرب للقيام بنشاطات مشتركة مع المثقفين اليابانيين لتصويب الصورة السلبية المتبادلة بين العرب واليابانيين. وعقد الباحثون العرب واليابانيون عددا كبيرا من المؤتمرات الثقافية التي نظمت سنويا منذ مطلع القرن الحادي والعشرين. وطرحت فيها قضايا مشتركة كثيرة، كالبيئة، واستيراد التكنولوجيا، وثقافة العولمة، والاستثمار المتبادل، والعلاقات التربوية والأكاديمية، وغيرها. فشكلت إطارا ممتازا للحوار الثقافي بين الجانبين، وتقديم الثقافة العربية إلى اليابانيين من خلال نخب ثقافية عربية بارزة منهم أنور عبد الملك، وحسن حنفي، وصادق جلال العظم، والمهدي المنجرة، وعبد الجليل التميمي، ورءوف عباس حامد، وكثير غيرهم. وبدأت الروابط الفكرية التي تجمع بين المثقفين اليابانيين والعرب تتسع بصورة واضحة بعد دعوة عدد من ممثلي مختلف التيارات الماركسية والقومية والليبرالية والإسلامية إلى اليابان للمشاركة في الحوار المستمر سنويا دون انقطاع. وانتقلت الدراسات اليابانية عن الثقافة العربية من مرحلة التأثر الشديد بالتيارات الماركسية والقومية السابقة إلى محاورة التيارات الليبرالية والإسلامية الحديثة. وتنوعت رؤية اليابانيين إلى القضايا العربية والثقافة العربية والإسلامية وفق مواقع فكرية متنوعة بعد أن فقد الباحثون اليابانيون الجدد الحماس الكبير الذي أبداه أسلافهم في الدفاع عن القضايا العربية العادلة والثقافة العربية. ختاما، عالجت هذه الدراسة نماذج ثقافية لأبحاث يابانية متنوعة تناولت مختلف جوانب الثقافة العربية. وكتبت غالبية تلك الدراسات في النصف الثاني من القرن العشرين، فتتبعنا تسلسلها الزمني بعد أن أسست لجيل جديد من الباحثين اليابانيين الذين اهتموا بالتاريخ العربي وبالثقافة العربية والإسلامية بصفتهما قضايا بحثية مستقلة بذاتها. وحللنا بصورة مكثفة أربعة نماذج يابانية بارزة أثارت نقاشات مهمة في اليابان أو في العالم العربي.وساهمت في تعريف اليابانيين بتاريخ العرب، وتراثهم، وثقافتهم، وفنونهم، وآدابهم، وبقضايا التحرر الوطني والاجتماعي في العالم العربي وخاصة قضية فلسطين، وبقضايا التنمية البشرية والاقتصادية المستدامة في دول عربية عدة. تضمنت النماذج المختارة مقولات ثقافية مسندة إلى مناهج معرفية متنوعة لعبت دورا ملحوظا في تطوير وعي اليابانيين بأبرز القضايا العربية المعاصرة منها : قضايا نظرية ذات طابع سجالي حول مناهج التاريخ العربي، وملفات توثيقية تضمنتها مجلة «العرب»، وسجالات معمقة عن الثقافة العربية أطلقها نوبوإيكي نوتاهارا ولاقت صدى كبيرا في أوساط المثقفين العرب واليابانيين، ودراسات في الأنطروبولوجيا الثقافية حول رؤية تاريخ مصر الحديث والمعاصر بعيون يابانية. وأشرنا إلى بعض الاستنتاجات المعمقة التي تبرز تطور معرفة اليابانيين بمشكلات العالم العربي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. مما دفع حكومات اليابان إلى تبني إستراتيجية براغماتية لحماية مصالحها في هذه المنطقة المضطربة والغنية بالنفط. فتطورت معرفة اليابانيين بالثقافة العربية عبر الانتقال من الدراسات الشمولية عن العالم العربي إلى دراسات فرعية خاصة بكل دولة عربية، بالإضافة إلى دراسات عربية متخصصة في مجال البداوة، والتاريخ الاقتصادي، وقضايا البيئة، والتعليم، والفنون، والآداب، والأنظمة السياسية، والجغرافيا، والآثار، والأنطروبولوجيا الثقافية، وغيرها. فتطورت معرفة اليابانيين الأمبيريقية بالثقافة العربية عبر إنتاج الكثير من الدراسات الميدانية اليابانية التي عمل الباحثون فيها على عدد من الأرياف، والقرى، والتجمعات القروية العربية، والقبائل، وأحياء المدن وغيرها. ورغم أهمية المعلومات التي تضمنتها، لم تحظ باهتمام يذكر من جانب الباحثين العرب، وذلك لأسباب عدة أبرزها أنها لم تترجم إلى العربية مع أن بعضها كتب بالإنجليزية أو ترجم إليها. ونشرت مجلدات ثقافية عدة في اليابان طالت قضايا أساسية في العالمين العربي والإسلامي، وبمشاركة باحثين من اليابان ومن مختلف الدول العربية والعالمية. وفي حين ساهمت الدراسات الأمبيريقية اليابانية عن العالم العربي في تعزيز حضور الثقافة العربية في اليابان، إلا أن حضور الثقافة اليابانية في العالم العربي ما زال محدودا. ومع كثرة المؤتمرات الثقافية المشتركة التي تقام سنويا في المرحلة الراهنة، تعززت معرفة اليابانيين بتراث العرب الثقافي، مع بروز اهتمام متزايد بالثقافة اليابانية لدى الجانب العربي. |
