الترجمة وحوار المتوسط في التاريخ
أضافه الحوار اليوم في
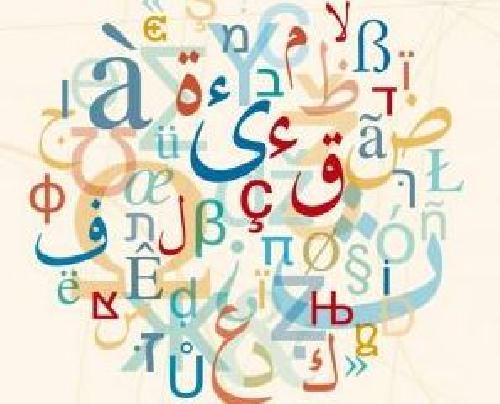
شوقي جلال
نخطئ منهجياً حين نتحدث عن قضية اجتماعية بمعزل عن السياق الاجتماعي الشامل في تعدده وتنوعه ومساره التاريخي مع المقارنة بخبرات الآخرين.
مثال ذلك أن نناقش واقع حال الترجمة وكأنه نشاط مستقل عن واقع حال النشاط العلمي أو التعليمي أو الاقتصادي أو العسكري أو السياسي أو عن واقع حال التنشئة الاجتماعية أو نوع ومحتوى الوعي بالتراث ودوره في المجتمع.
اعتدنا أن نقول «الترجمة حوار بين الحضارات»؛ ولكن نسينا أن الحوار تفاعل وجدل معرفي صاعد في اطراد أخذاً وعطاء بين طرفين أو أكثر على أساس من التكافؤ والنديّة، والرغبة في تحصيل جديد يدعم المشروع الوجودي لأي من أطرافه. إذ بدون هذا يكون حواراً للطرشان، أو محاكاة مظهرية عقيمة، لهذا لا نرى الترجمة حواراً شكلياً ولا نشاطاً للترفيه والتسرية فحسب، بل نشاطاً اجتماعياً متكاملاً في منظومة واحدة مع مجموع أنشطة المجتمع الهادفة إلى تعزيز وجود الفرد والمجتمع من حيث الفكر والفعل الاجتماعيين، ومن حيث القدرة على مواجهة تحديات مفروضة محلية وخارجية في صورة استجابات إبداعية لا محاكاة أو نقلاً مجانياً عن آخر في الزمان أو في المكان بل إبداعاً نابعاً من واقع الذات بفضل الفكر والفعل الاجتماعيين لانتزاع أو اقتناص حق الوجود.
ومن هنا نقول: الترجمة هي إحدى آليات تمكين المجتمع في السياق الحضاري بين الأمم. وتتأكد أهمية وحيوية هذا التعريف في سياق ظروف العولمة التي تعني أن المعرفة قوة، وتعني تكثف الزمان والمكان، وتكثف الاتصالات، ومن ثم تكثف التفاعل العلمي والتكنولوجي والثقافي بين الشعوب، ومع هذا الزوما إنسان/ مجتمع أهل لهذا الحوار والمشاركة فيه.
إن المجتمعات التي تتصف بالحيوية الدينامية المطردة في عصر العولمة هي مجتمعات مشاركة إيجابياً في حوار علمي/تكنولوجي/ثقافي على الصعيد العالمي، ومشاركة أو متنافسة على أرضية الإبداع أو السبق الإبداعي في عناصر هذا الحوار، والسبق في امتلاك ناصية أغنى رصيد للمعرفة قرين القدرة على استثماره وتوظيفه وتطويره. معنى هذا أن رصيد المجتمع من إنجازات في صورة إبداع علمي وتكنولوجي متطور يمثل الدعامة الأولى والأساسية التي تؤهله للمشاركة الإيجابية في هذا الحوار. وطبيعي أن هذا الرصيد جامع بين مصدرين: إبداع محلي، واستيعاب لإنجازات الآخرين.
إن جناحي النهضة أو البناء الحضاري هما معاً وفي آن واحد، الإبداع المحلي في مناخ حر قرين استيعاب إنجازات الآخرين، وسيادة رأي عام داعم بثقافته لهذا الجهد. ويصبح هذا النهج أكثر ضرورة وإلحاحاً في عصر الترابط الشبكي بين المجتمعات والأفراد في عصر العولمة.
ويمثل واقع حال الترجمة دالَّة كاشفة عن حال المجتمع وأهليته في ضوء أبعاد متعددة: البعد المعرفي والثقافي العلمي والتعليمي والإبداعي، وهي جميعاً متشابكة في جديلة أو منظومة واحدة ذات عمق تاريخي اجتماعي، وأيضاً ذات مدلول اقتصادي سياسي. أو لنقل بمعنى آخر: إن نشاط الترجمة دال على مستوى نشاط المجتمع جملة في حركة هذا المجتمع سلباً أو إيجاباً؛ تقدماً أو نكوصاً على صعيد السباق الحضاري في ضوء كم ونوع أو محتوى المترجمات. ونلحظ أنه على الرغم من تواتر وتكثف الحديث في كل أنحاء العالم العربي عن الترجمة ونقل المعرفة خلال السنوات الأخيرة، إلا أننا لم نخط خطوة عملية حقيقية على طريق الكشف، ومن ثم معالجة الأسباب الحقيقية الكامنة وراء التدنَّي الشديد لمستوى الترجمة.
والتواصل مع الذات ومع الآخر، الجماعة والطبيعة، عامل حيوي؛ بل هو شرط الحياة بالنسبة للبشر ولضمان بقائهم على المستوى البشري. إذ لا حياة بشرية بدون التواصل عبر الرمز/اللغة مكتوبة أو شفاهة أو فنية. والتواصل تفاعل ثقافي وحضاري يجري من خلال انتقال الأفكار والمبادئ والمفاهيم الناتجة عن حركة أو نشاط معرفي خبري اجتماعي. وتمثل الترجمة إحدى أهم قنوات التواصل وأقواها أثراً في نقل المعارف والمفاهيم بين المجتمعات، وتطوير الثقافة. هكذا حال المجتمعات عبر التاريخ.
حوار العقائد والفكر بين بلدان المتوسط
ولقد كان البحر المتوسط، كمثال ساحة حوار وتحالفات وصراعات هادئة أو ساخنة بين شعوب المنطقة، وكانت الترجمة إحدى آليات الفعالية الحضارية دائماً. نعرف أن مصر واليونان وفارس كانت قبل الميلاد بقرون أهم القوى الإقليمية في شرق المتوسط، واشتعلت المنافسة، كما تكررت المحاور والتحالفات فيما بينها.
يحكي التاريخ كيف كانت مصر كعبة المعرفة العلمية يقصدها علماء وفلاسفة الإغريق ومنهم طاليس وفيثاغورس وأفلاطون وغيرهم، كما يروي البعض أن معبد دلفي في أثينا أعاد بناءه الفرعون المصري أمازيس بعد أن أحرقه بعض الآثينين بزعم أنه يقدم لرواده تعاليم تناهض التعاليم التقليدية السائدة.
ويؤكد مارتن برنال في كتابة الضخم والمهم: (أثينا إفريقية سوداء) على هذا المعنى وأن الربة أثينا مستوحاة من مصر – أفريقيا. وطبيعي أن كانت الترجمة آلية معرفية وتثقيفية لا غنى عنها في ذلك.
ونذكر هنا مدرسة الإسكندرية التي أنشئت في العصر الهللينستي. وكانت المدرسة ساحة تفاعل فكري وفلسفي وعقيدي متعدد اللغات بين فلاسفة ومفكرين من مدارس فلسفية ودينية ومذهبية مختلفة. وتمثل المدرسة تجسيداً حياً لمعنى التفاعل ودوره في الإثراء الفكري فضلاً عن إسهاماتها في تأويل النصوص. وقبل هذا التاريخ كانت مدرسة أو معبد (بعنخ) المصري الفرعوني في راقودة على شاطئ المتوسط والذي أنشئت مدرسة الإسكندرية البطلمية على غراره.
وحرى أيضاً أن نذكر منطقة شرق المتوسط وآسيا الوسطى التي توهجت فيها مدارس فكرية وصراعات وحوارات عقدية عن المسيحية والإلهيات في تنوع خصب تجسدت في مدارس ومذاهب فكرية. ونضيف كذلك الأنشطة الاجتماعية العلمية والعقدية والفكرية في بابل وآشور والسريان ومراكز الفكر في أنطاكيا وحران والرها ونصيبين وأوغاريت. وكانت جميعها قلاعاً فكرية وعقائدية آثرت بإشعاعاتها في الإقليم على اتساعه، مثلما كانت لها جميعها تفاعلاتها خارج الحدود، وكان لبعضها حضور ثقافي بل ومادي داخل شبه الجزيرة العربية مثل فارس والرومان ومصر فضلاً عن رحلات القوافل التجارية.
ونجد دور الترجمة واضحاً أيضاً في المعاهدات المعقودة بين البلدان مثل المعاهدة المعقودة بين رمسيس الثاني في مصر وملك الحيثيين حيث كان بين كل منهما صورة من المعاهدة بلغته. وترجم الرومان إثر غزوهم لليونان المعارف اليونانية إلى لغتهم اللاتينية، ومن أهم هذه الترجمات الأوديسة سنة 240م. ويذكر التاريخ أن عمر بن الخطاب عني بتعريب الدواوين نقلاً عن الفرس.
يوم أن تكلمت الحضارة بلسان عربي
وجاء عصر النهضة العربية بمراحله الأربعة بداية من خالد بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان أول من أمر بترجمة التراث اليوناني إلى اللغة العربية، وكذا تعريب ما سبق نقله من اليونانية إلى السريانية.
واستمر العرب في عهد الخلافة العباسية ينقلون تراث الفكر اليوناني والروماني والهندي والفارسي استجابة لضغوط مشكلات وسجالات اجتماعية وعقائدية التماساً لحلول عقلية ومنهج حاكم لمسيرة الفكر. وحرص العرب على مدى فترة (النهضة العربية الإسلامية) على نقل وترجمة العلوم الطبية والرياضيات والفلك فنجد كتب إقليدس وأرشميدس وبطليموس في الهندسة والفكر، وكتب أبو قراط وجالينوس في الطب، وكتب أرسطو وأفلاطون في الفلسفة. وترجموا عن الهنود العديد من الكتب العلمية والأدبية من مثل كتاب (شاناق في السموم) و(السند هند) في الرياضيات والفلك وغيرها، واستفاد العرب من الهنود في حل جملة من المسائل الفلكية المتعلقة بعلم المثلثات الكروية، واقتبسوا عدداً من الاصطلاحات الرياضية مثل مصطلح جيب في حساب المثلثات والهندسة.
وبلغ نشاط الترجمة ذروته في عصر المأمون المولود لأم فارسية والذي تولى إمارة مرو في جنديسابور التي ضمت دار الحكمة الفارسية. وأنشأ المأمون على غرار هذه الدار دار الحكمة في بغداد وجمع فيها كل ما استطاع من ذخائر اليونان والسريان والهنود والفرس والرومان.
وتميز نشاط الترجمة في عصر النهضة العربية بأنه نشاط مؤسسي، أعني اختصت به أسر معينة بالعلوم وترجمتها وإن عملت تحت رئاسة الدولة. ويمثل أيضاً منظومة معرفية متكاملة وإطاراً حضارياً. ودعمت الدولة كما دعمت الأسر مشروعات الترجمة بالتمويل المباشر وتوفير الكتب. ونذكر من بين هذه الأسر:
1. أسرة بختيشوع وكانت تعنى بالطب وهو مهنتهم.
2. أسرة موسى بن شاكر وتخصصت في الهندسة وعلم الحيل (الميكانيكا) والمساحة والفلك والفيزياء.
3. أسرة حنين بن إسحق عميد المترجمين.
وتجسد الأسرة مشروعاً علمياً وفكرياً في صورة منظومة محددة وهادفة.
ويذكر التاريخ من أهم المترجمين الرواد أسماء:
- أبو يحيى البطريق الذي ترجم معظم مؤلفات جالينوس في الطب.
- حنين بن إسحق شيخ المترجمين الذي درس اللغة العربية على تلامذة الخليل بن أحمد الفراهيدي في البصرة ثم سافر إلى بلاد اليونان حيث تمكّن من اللغة اليونانية، لذا تميزت ترجماته بالدقة والوضوح.
- ثابت بن قرة الذي ترجم عن اليونانية كتباً في التنجيم والحساب.
- محمد بن إبراهيم الفزاري وكان أبوه فلكياً وألف منظومة في الفلك، ويقال إنه أول من صنع الاصطرلاب وإن قالت روايات أخرى إن الصين أيضاً أول من صنعه.
- عبدالله بن المقفع وترجم عن البهلوية بعض الكتب في المنطق والطب والأدب (كليلة ودمنة).
- ابن الباطق وترجم أعمال أبو قراط.
- المسعودي وترجم كتاب العناصر كما ترجم المجسطي لاقليدس.
- يحيى بن ماسويه الذي كان يكتب بالسريانية والعربية وكان متمكناً من اليونانية وله كتاب عن الحميات الذي تمت ترجمته إلى اللاتينية فيما بعد.
التلاقح الفكري في مناخ الحرية شرط الإبداع والتجديد
والتجربة العربية درس عملي بالغ الأهمية حري أن نتعلم منه. إنها تجسيد واقعي لمعنى التلاقح الثقافي بين الحضارات في مناخ الحرية. إذ كان المترجمون من أبناء حضارات مختلفة في المجتمعات المحيطة بشبه الجزيرة العربية. وضم العرب قطاعات واسعة من هذه البلدان التي أضحت منهكة حضارياً، وشديدة التنوع فكرياً وعقائدياً ومذهبياً تحت راية سلطة سياسية واحدة جديدة تحمل اسم عقيدة الإسلام. وخلق الواقع الجديد فرصة جديدة لتفاعل جديد على نطاق إقليمي واسع بين ميراث هذه الإنجازات الحضارية السابقة.. تفاعل في سياق جديد مغاير، وتحت مظلة سياسية جديدة.. سياق يمتد مكانياً من حدود الصين عبر الهند وفارس إلى شرق المتوسط ومصر وبلاد الإغريق.. وكان الوضع الجديد وما أثاره من قضايا لها تاريخها السابق أشبه بحقنة أدرينالين منشطة لجسد واه ضعيف، فبثَّت الروح والحمية فيه من جديد، وأفاق الجسد إلى حين.
وتجلت ثمار التفاعل في ظل السياق الجديد وقضاياه الجديدة.. وكانت مرحلة لاستيعاب فكر وافد، وإيقاظ فكر موروث متنوع المصادر، وتفاعل من منطلق خصوصيات سابقة متنوعة مع رؤى وفكر إسلامي جديد، وليس بالغريب، وإنما يمثل نقلة على امتداد متصل الأديان في تطورها الإقليمي.
وأصبحت المنطقة العربية خزانة المعارف، وذاكرة العالم الحضارية على مدى أربعة قرون، وحلقة من حلقات مسيرة تداول الحضارات بين المجتمعات، كما تطورت واغتنت اللغة العربية وأصبحت لغة العلم بفضل إنجازات العلماء العرب ومناخ الحرية. وبينما كان القرن 14 بداية ونذيراً بانحسار النهضة العربية فقد كان القرن 14 أيضاً بداية وبشيراً بانطلاق النهضة الأوروبية كمركز جديد في مسيرة تداول الحضارات. وإذا كان انحسار النهضة العربية له أسباب عديدة محلية وخارجية مثل غزوات المغول، والحروب الصليبية، وسوء الإدارة داخلياً وإغلاق باب الاجتهاد وانتصار الأصولية ومن ثم وأد العقل العلمي فقد استهلت حركة النهضة الأوروبية (الرينسانس) مسيرتها من إيطاليا اعتماداً على النهم المعرفي، وتقديس العقل، ورفض التقليد والتبعية العمياء للسلف والدعوة إلى أن يكون أبناء العصر هم فقهاء عصرهم. واتجهت الأنظار إلى كنز المعرفة المتمثل في الترجمات العربية للتراث العلمي الإنساني إضافة إلى إبداعات علماء العرب.
ومال ميزان الحضارة عن العرب إلى الغرب
وإذا كان نشاط الترجمة في عصر النهضة العربية انطلق بدافع البحث عن منطق جديد يحكم قواعد الفكر والحوار بل والصراع الدائر والمتطور وقتذاك بشأن قضايا ومشكلات أفرزها الواقع الجديد، والتمس فلاسفة وعلماء ومفكرو العرب ضالتهم في فكر بلاد الإغريق ومصر وفارس والهند والسريان والنساطرة.. إلخ كذلك حال الغرب الذي التمس في مستهل النهضة وعلى مدى مسيرتها لبضع قرون، حلولاً لقضاياه ومشكلاته بين سطور وكتب مفكري وفلاسفة وعلماء العرب مثل ابن رشد والخوارزمي وابن الهيثم وابن خلدون وغيرهم.. مثال ذلك السجال بشأن القروض والربا والحاجة إلى تحديد مساحة الاختصاص لكل من رجال الدين ورجال السلطة الزمنية وأهل الفكر والعلم، فرجال الدين يفتون في أمور الدين، والعلماء أدرى بشؤون دنياهم اعتماداً على العقل العلمي في مناخ الحرية.
والرينسانس وتعني البعث أو الميلاد الجديد حركة ثقافية امتدت من القرن 14 وحتى مطلع القرن 19 وبدأت من إيطاليا ومنها انتشرت إلى بقية أنحاء أوروبا. بدأت أول ما بدأت في فلورنسا. وجدير بنا أن نذكر أن فلورنسا والبندقية كانتا مركزين لنشاط تجاري في العصر الميركانتيلي لتجارة القوافل عبر طريق الحرية الممتد من الشرق الأقصى (الصين) ثم بلاد فارس وبلاد العرب. هذا علاوة على التشابك بين العرب وأوروبا من خلال الحرب الصليبية. واطلع الغرب على ثقافة الشرق بفضل التجارة وأيضاً أثناء الحروب الصليبية. وبدأ الغرب، وهو يتشوف للنهضة، يعود بالنظر إلى ماضيه القديم وثقافته العلمية والأدبية والفكرية وعرف أن هذا كله مودع في خزائن العلم العربي. وتجلى دور الترجمة واضحاً. وانتقلت العلوم العربية مترجمة إلى اللاتينية إلى فلورنسا وباليرمو عاصمة صقلية، وساليرنو جنوب شرق نابولي، هذا بالإضافة إلى طليطلة وقرطبة في الأندلس. وتمت الترجمة إلى اللاتينية وكذا إلى العبرية ولغات أخرى.
ومن أشهر المترجمين عن العربية قسطنطين القرطاجي والمسمى الأفريقي، وترجم علوم الطب في القرن 11 وتولى مهام تعليم الطب في ساليرنو. امتلك مكتبة ضخمة من الكتب الطبية العربية ومن بينها كتاب (القانون) في الطب لابن سينا وترجمها إلى اللاتينية وظلت مرجعاً علمياً في مدارس الطب في أوروبا حتى القرن 17 وإن ظل بعضها كذلك حتى القرن19.
ومثلما كان المأمون في بغداد، كذلك كان فريدريك الثاني ملك صقلية 1194 – 1250 الذي شجع عملية نقل المعارف عن اللغة العربية، وحرص على تبادل الرسائل العلمية مع العلماء والفلاسفة العرب. وهو المسؤول عن إنجاز كتاب المجسطي لبطليموس عن العربية إلى اللاتينية، وكذا ترجمة أعمال عالم الفلك أبو العباس أحمد الفرغاني إلى اللاتينية. وقام بتوسيع مدرسة الطب في ساليرنو واستهل إنشاء جامعة نابولي.
وظهر في عهده ليوناردو فيبوناتشي Leonardo Fibonacci (1194–1950) من رجال البلاط في قصر فريدريك الثاني وهو مبتكر المتواليات الحسابية، ودرس مع علماء الرياضيات العرب.
وحري أن نشيد بدور العلامة الإدريسي، أبو عبدالله المعروف بالشريف (1100–1165) الرحالة المولود في سبتة في المغرب. درس في قرطبة وبرع في علم الهيئة (البحث في أحوال ومواقع الأجرام السماوية) وفي الجغرافيا ورسم الخرائط وفي الطب والحكمة والشعر. طاف ببلاد الروم واليونان ومصر والمغرب وفرنسا وإيطاليا والشرق الأقصى. دعاه الملك روجر ملك النورمانديين إلى صقلية حيث بقى هناك ورسم له الإدريسي ما عاينه من البلدان على كرة من الفضة وأهداه كتابه (كتاب روجر) الذي تضمَّن شكل الكرة الأرضية وأفاد به روجر بيكون وكوبرنيكوس.
وتذكر ميشيل سكوت (1217–1240) سكوتلاندي ومن أذكى عقول رجال بلاط فريدريك الثاني في باليرمو. عمل في مركز الترجمة العربي في طليطلة وقدم نسخة لاتينية لأعمال ابن رشد الفلسفية. وترجم كتاب الأجسام الكرية للبطروجي (نور الدين أبو إسحق البطروجي) ت 1185 ويعرفه الأوروبيون باسم البطراجيوس Alpetragius. فلكي أندلسي. وألف كتابه هذا في نقد بطليموس. وترجم سكوت أيضاً من العربية إلى اللاتينية كتاب أرسطو تاريخ الحيوان.
وهناك أيضاً شارل الذي عمل بالترجمة في جنوب إيطاليا وترجم مع آخرين إلى اللاتينية الموسوعة الطبية الضخمة للرازي المعروفة باسم (الحاوي).
الحوار الخارجي:
