المترجمة الهندية مريم كريم-أهلوت: الترجمة والعلاقة بالآخر
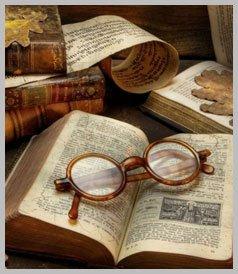
ترجمة: عادل العامل
نحن، (في الهند)، تقول مريم كريم-أهلوت Mariam Karim-Ahlawat، أمة كثيرة اللغات، و لدينا معرفة في الأقل بلغتين: لغة أم ولغة تعلّمنا بها في المدرسة والكلية، والتي غالباً ما تكون مختلفةً عن اللغة الأم. وهذه اللغة في الغالب هي الانكليزية. و كل لغة تتعلمها لها إدراكاتها أو حساسياتها ومصطلحها الخاص. كما أنها تمتلك سجلاتها، وأنظمة قيَمها، وتميّزاتها الطبقية ومستويات المقبول وغير المقبول لديها. و كل لغة نعرفها تجعلنا حساسين على نحوٍ مختلف تجاه أشياء مختلفة، وتطوّر فينا شخصيات مختلفة ذات إدراكات مختلفة.
و في كل مرة نتحول إلى لغة أخرى، نتغير بدقة إلى شخص آخر. كما تتبدل إيماءاتنا و تعابير وجوهنا وفقاً لذلك. فاللغة ليست مجرد كلمات و جمل، إنها أيضاً وقفات، و تشديد، وتنغيم، وإيقاع، وسكتات؛ والاستخدام الملائم لهذه في الجمل والكلمات هو الذي يخلق معنى ما نقول، وينقل الفروق الدقيقة.
و في ترجمة النصوص، تكون جوانب اللغة غير اللفظية non-verbal مخبَّأة إلى أن يصل النص إلى القارئ. لكن جعل النص يصل إلى القارئ بطريقة يفسّر بها هذا القارئ العلامات اللفظية لإحداث المعنى نفسه هو عمل المترجم. وعلى مترجم النصوص الأدبية خاصةً أن يكون واعياً بشدة للشخصيات المختلفة التي طوَّرها بلغات مختلفة. فلحظة الترجمة هي تلك اللحظة التي تكون فيها شخصيتا المترجم باللغتين المختلفتين في حوار إحداهما مع الأخرى. إنها لحظة التعابير بين شخصيتي الشخص نفسه. و آنذاك فقط يمكن للجدل الأبدي المتعلق بـ " الأمين faithful " و"الجميل" أن يُحل في الترجمة، لأنه عندئذٍ يتم تجاوزه، ونصل إلى مستوى آخر من الفهم بشأن الترجمات. ولم يعد الأمين والجميل يعارض أحدهما الآخر بل لم يعودا لاعبين في هذا المجال، أيضاً.
و بمعرفتنا لغةً أخرى، أهلية أو أجنبية، وبالتالي تطوير شخصية بديلة، فإننا نخلق فضاءً لفهم الآخر. والترجمة، والأدب المقارن، و الكتابة جميعاً تطرح بثبات مسألة العلاقات بالآخر.
و إذا أخذنا كحقيقةٍ أولية أن كل المجتمعات مستندة على قيَم إنسانية عالمية، فإن ذلك يُصبح أمراً محدِّداً للغاية. فنضيِّق عندئذٍ أنفسنا و نختار نصوصاً و مواضيع نشعر أنها تقدم تلك القيَم العالمية التي نفهمها كقيَمنا أيضاً. في حالةٍ كهذه نغلق الأبواب على فهمنا للآخرين. و لا يستطيع الآخرون أن يكونوا آخرين ما لم تكن لهم آخرية Otherness. فإذا لم نُقر بآخرية الآخرين، إذا فكّرنا بأننا نعرف حقائقهم سابقاً، نغلق عندئذٍ عقولنا ولا نخرج للبحث عن آخريتهم. في حالةً كهذه في الترجمة تجدنا نبحث فقط عن صور مرآتية لأنفسنا ولا نتجاوز أنفسنا أو النصوص. فما هي القيمة التي ستكون للترجمة حين لا نريد أن نعرف لماذا يمثّل شخصٌ ما، أو شيء ما، آخرَ أو يكونه؟
و قد كان هناك، في نظرية الترجمة، في وقت مضى، بحث عن مرادفات نحوية (المنطق و القواعد في الجملة) و لفظية ( تنقل المعنى نفسه ). أما اليوم، و خاصةً في الشعر و النصوص الأدبية، و اعترافاً بالمترجم كنوع من خالق عَبر transcreatorالنص، تُعد الإيقاعات ، والوقفات، والتنغيمات الآنفة الذكر ذات قيمة أيضاً. كما أن نقل المصطلح في شكله الأصلي يُغني النص.
و يلاحظ بعض القراء أن فعل القراءة ذاته بلغة ثانية، دعك من كتابته بها أو ترجمته، هو فعل ترجمة. فالترجمة والتفسير يصبحان مترادفين. و الجانب المهم والمثير جداً لهذا العمل بين اللغات هو إمكانية التغييرات بين الشخصيات، الذي يمكن أن يكون ممارسة مسرحية ودراماتيكية تساعد على فهم عوالم مماثلة لكن مختلفة.
كما أن الترجمة و العمل بين اللغات يقومان بإنجاز الوظيفة السفارية ambassadorial المتمثلة في خلق الاعتناق والفهم بين الثقافات، لكن فقط حين نكون مستعدين لإقرار وتقييم الاختلافات، ( الآخرية Otherness) من أجل تقبلها حسبما هي عليه، و لرؤية كيف أن هذه الاختلافات ذاتها تُغني و تقوّي المجتمعات.
المصدر:
http://www.araa.com/article/95921
